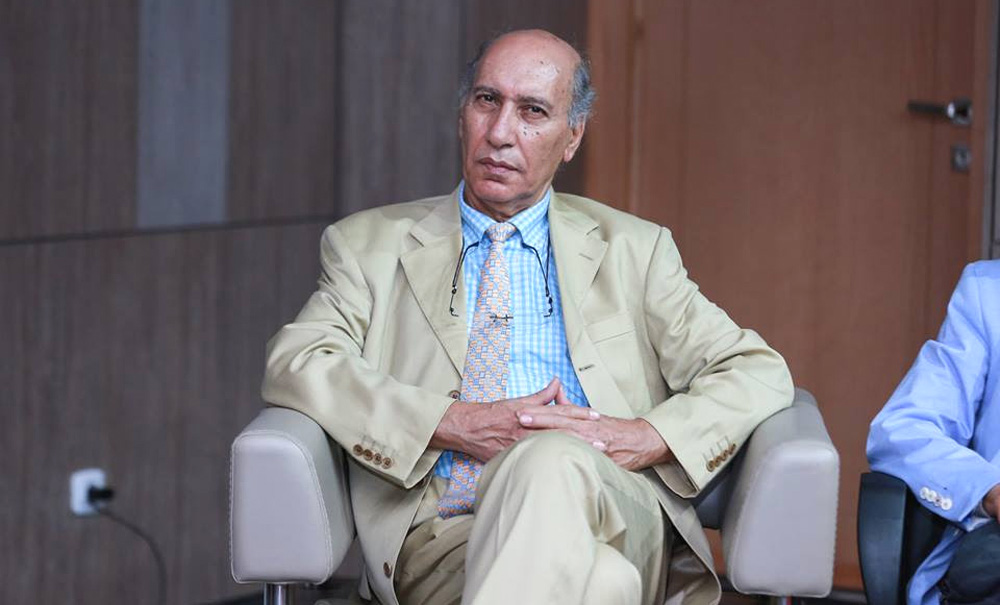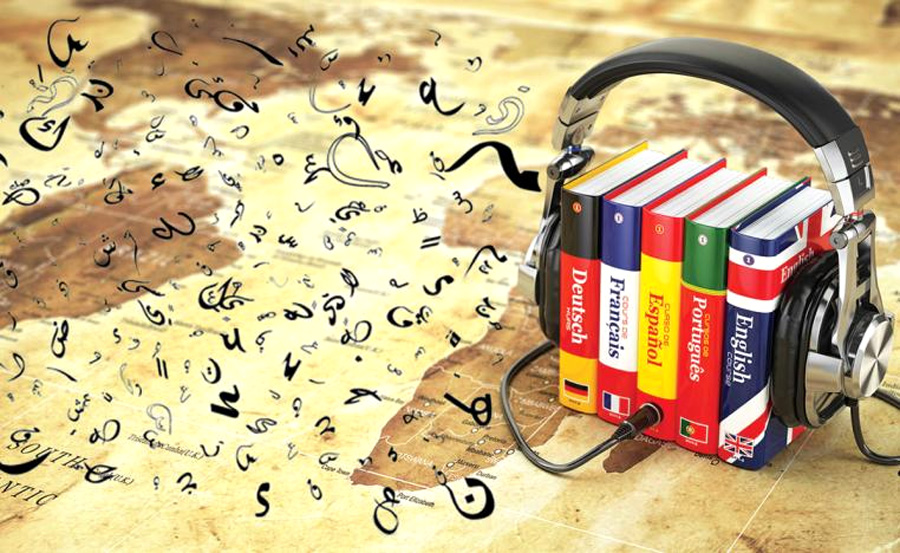الصناعة واسعة والعمر قصير
جميل ومفيد هو التحليل الذي أنجزه الكاتب الروائي التونسي المهاجر أبوبكر العيادي حول موقع الأدب العربي في الساحة العالمية وحول أهم أسباب التأخر الذي ميز هذا الأدب، فكأنه بذلك يعود بنا إلى العنوان - السؤال الذي اشتهر به كتاب الشيخ عبدالله النديم (1893): "بِمَ تقدّم الأوروبيّون وتأخرنا والخلق واحد؟!". والحقيقة أن العيادي عودنا على هذا النوع من الكتابات التي تنم عن وعيه بمسائل عصره وقضايا شعبه وثقافته وعن قلق كأنه ريح تحته تجعل باله لا يهدأ وطموحه لا يستكين. أما في الموضوع المطروح للمحادثة، قد أختلف معه عند بعض الأسئلة وبعض تأويلاتها، وما أهم أن نختلف لنتقدم معا.
ينطلق أبوبكر العيادي من علاقة الثقافة بالهيمنة وميزان القوى فيشدد على التفاوت بين الأمم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وهو تفاوت في علاقة وطيدة بتفاوت آخر، ثقافي بصفة عامة، يلمسه المثقف، والكاتب خاصة، من خلال تفوق لغات على أخرى وانتشار آداب أكثر من آداب أخرى. هذا الأمر بديهي بما أن التاريخ يعيد توزيع أوراق السلطة بين الشعوب والثقافات والحضارات حسب تطور أحداثه وما ينتج عنها من إعادة رسم للجغرافيا الثقافية كصورة تعكس الجغرافيا السياسية والاقتصادية وما يترتب عنها في الشأن الاجتماعي.
والتاريخ علمنا أن ضعفاء هذا الوضع العالمي لا يجديهم نفعا التشكي والتظلم إلى حد البكاء أو النقمة وعليهم أن يعوا أولا أنهم، بصفة أو بأخرى، مسؤولون عن أوضاعهم تلك. وأن يعوا خاصة أن على الشعوب التي تريد تغيير أوضاعها أن تبدأ بتغير ما بنفسها، لأن كل علاقة مع الغير يفترض أن تبدأ بمراجعة الذات ومساءلتها.
كثيرون هم الذين يشتكون من الاستعمار ومخلفاته ومن هيمنته التي نتجت عنها ما سمي "الأوروفونية المنتصرة". لكن الموضوعية تفرض علينا أن نتذكر أن تاريخنا سمح لنا بأن نتقمص نفس الدور سابقا، لما كانت أوروبا ترزح في عصور الانحطاط، ولما كانت المجتمعات العربية الإسلامية تعتبر رمز التطور الفكري والحيوية الإبداعية في اقتران بتفوقها العسكري وسيطرتها على جزء كبير من العالم.
وبالعود إلى كتاب الشيخ عبدالله النديم، فإن سؤاله يمكن أن يصبح "بِمَ تأخرنا بعد أن كنا في الطليعة وتقدّم الأوروبيّون بعد انحطاطهم؟!" وهو سؤال يمكن أن نستحضر معه موضوع المسؤولية التي ذكرنا أعلاه.
فلما جاءت النهضة الأوروبية، كان المحرك الأساسي فيها هو الفكر والإبداع بالاستفادة من الماضي، ماضيها وماضينا وماضي غيرنا، قصد التجديد وإنارة المستقبل وبناء صرحه. لكننا إلى اليوم لم نستطع أن نمسك بحبل الحداثة، التي هي النتيجة التاريخية للنهضة الأوروبية، لأن عديد العاهات بقيت تعوقنا ومنها أن أصبحنا نحمل الآخر مسؤولية تأخرنا.
لا يمكن أن تبقى عقدة الاستعمار متمكنة بعقولنا وقلوبنا فتعيدنا إلى منطق البكاء على الأطلال في قلة وعي صارخة بمستلزمات التطور والتقدم وأولها أن نمسك بزمام أمورنا. بل بالعكس، أصبحنا نبحث في ماضينا نظما غابرة نريد محاكاتها لنوهم أنفسنا بأن ذلك يمكن أن يعيد إلينا الجنة المفقودة. باختصار، لما كان علينا أن نكون في مسار التاريخ اخترنا أن ندير ظهرنا وأن نعكس الاتجاه.
إذن، لعله من واجبنا اليوم الإقرار أولا بأن كل شعب وكل مجتمع مسؤول عن تقدمه أو تأخره ولا يجب عليه أن ينتظر من خصمه أو منافسه أن يترك له المجال للتوسع بدعوى أخلاقيات نعلم جميعا أن السياسة لا تعترف بها، وحتى إن ذكرتها فلتوظفها لأجل أغراض سياسية أخرى. ونفس المنطق ينسحب على قطاع الكتاب بما أنه جزء من قطاع الثقافة وأن هذا الأخير هو أحد عناصر السياسة المذكورة.
ومن هذا المنظار، عندما نتحدث عن "محاولات انخراط الأدب العربي في الفضاء العالمي" وعن الصعوبات التي تواجهها، لا يمكننا إلا أن نتفق مع أبوبكر العيادي حين يرجع ذلك إلى الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية للمجتمعات العربية التي جعلتها غير قادرة على الانصهار في الحداثة؛ فتصبح بذلك قضية الثقافة عامة وقضية الإبداع الأدبي وغيره قضية مجتمع بأسره لا بد له أن يتولى كل أموره بالحكمة والحكامة (أو الحوكمة) اللتين تضمنان له ما يطمح إليه من نمو وازدهار وإشعاع.
لكننا نستغرب بعض الشيء من الرأي الذي يعلل لصعوبة الرواج العالمي للأدب العربي بالمزاحمة التي يلقاها من الذين يكتبون "بلغات المستعمرين القدامى". دعنا نؤكد على ضرورة الفصل بين القيمة الإبداعية لأدب ما وبين رواجه في صلة بعملية تجارية تنشد الربح المالي قبل كل شيء. فبغض النظر عن اللغة الإنكليزية التي تضافرت عديد العوامل المرتبطة بالعولمة لجعلها اللغة الأكثر رواجا في العالم، يبقى السؤال مطروحا من حيث رواج الأدب في لغات هي ليست بالضرورة أكثر استعمالا من غيرها. فالعربية هي رابع لغة في العالم من حيث الاستعمال، بعد الصينية والهندية، لكن رواج آدابها يأتي بعد الفرنسية مثلا وهي اللغة التاسعة في الترتيب العالمي.
أعتقد أن الأمر يكمن في المقام الذي وضعت فيه الدول آدابها من حيث هي عنصر اقتصادي يتطلب صناعة ومراحل تجارية مدروسة ومتكاملة، يدعمها قطاع الإعلام والاتصال بمختلف آلياته المكتوبة والرقمية والسمعية البصرية. فهو استثمار صناعي وتجاري في الثقافة أتى بفوائد جمة وملموسة للأدب المكتوب بتلك اللغات المتفوقة، لأنه دخل في المنظومة المتكاملة التي ذكرنا. أما عندنا، يكفي أن نتوقف عند حكامة قطاع النشر والتوزيع والترويج للكتاب لنرى أننا في بعد مسافة كبيرة عن الهيكلة والسياسة المعتمدتين في بلدان اللغات التي تقدمت علينا في ذات المجال. فإما أن يكون الأدب عندنا أو لا يكون. ولكي يكون وجب أن يصبح هاجسا عاما، حكوميا ومواطنيا، تضعه المؤسسات والجماعات والسلط في مقدمة اهتماماتها وكذلك الأفراد ورؤساء الأموال وغيرهم. والأهم في هذا التمشي أن تكون للدولة سياسة واضحة المعالم والأهداف ومنتظمة الأداء والتقييم والاستشراف، مدعومة بوعي المواطنين وانخراطهم في نفس التمشي باعتباره السبيل الأفضل لنمو القطاع.

أما من الجانب الإبداعي، فالملاحظ هو أن قضية "الكتابة بلغة المستعمر القديم" لا زالت قضية خلافية في مجتمعاتنا، خلناها ستزول بعد عشريتين من الاستقلال لكن الواضح أنها لا تزال راسبة في بعض العقول. فكأننا فقدنا القدرة على التخلص من النكسات التاريخية وبقينا دوما تحت وطأة تأثيراتها السلبية نحمل عقدتها المحبطة عوضا أن نجعل منها علامة مستقبلية تنير بدروسها بناء الغد الأفضل. بل ذهبنا بالأمر إلى أن أصبحنا نخون كتابنا باللغات الأجنبية بدعوى أنهم دمى متحركة بين أيدي الاستعمار الجديد وهلم جرا. قد يوجد من هو منخرط في هذه الاعتبارات المنفعية الضيقة ولكن لا يمكننا التعميم إلى حد إنكار صفة الكاتب العربي بالنسبة للكاتب بلغة الآخر. لا حق لأحد أن ينكر انتماء مواطن ما لوطنه ككل متكامل باعتبار أنه كتب بلغة أو بأخرى دون اللغة الرسمية لبلاده، تماما كما لا يمكننا نفي صفة المواطنة عن أحد لاعتقاده في دين غير دين الأغلبية في الوطن. بل الرأي عندي هو ضرورة التوقف عند هذا الأدب بالدرس والترجمة، خاصة التعريب، لتلمس ملامحه الإبداعية في علاقة بجدلية الأنا والآخر وفي بعد يتجاوز الجدلية اللغوية المبسطة إلى ما هو أعمق في إنسانية الإنسان.
لا أظن أبوبكر العيادي في هذه الزمرة من الذين يستهدفون زملاءهم "الكتاب بلغة المستعمر القديم"، لكن استعمال العبارة على هذه الشاكلة يبعث على الحيرة والسؤال. فهل معنى ذلك أنه مسموح للتونسي والجزائري والمغربي، مثلا، أن يكتبوا بأي لغة أجنبية ما عدا اللغة الفرنسية، فقط لأن بلدان المغرب العربي كانت مستعمرات فرنسية؟ هو تأويل ممكن لكنه لا يستقيم عقلا وتبقى العبارة أكثر دعوة إلى رفض الأدب بلغة الآخر أو على الأقل إلى التوجس والريبة منه.
أعتقد شخصيا أن الداء هنا يكمن في أننا لا نتصور تقدمنا وإشعاعنا إلا على حساب الغير وللتفوق عليه، في حين منطق التقدم والتطور والنهضة الحداثية عموما لا يقوم على منافسة الآخر بقدر ما يقوم على مراجعة النفس، الذاتية الفردية والذاتية المجتمعية. لكننا استبطنا إلى يوم الناس هذا صورتنا كضحية الآخر وبقينا نجترها كتعلة لتخلفنا عوض أن نستمد من تجربة الاحتكاك بالآخر قوة فكرية استشرافية تجعلنا نعيد بناء حاضرنا ومستقبلنا لا بالوقوف على الأطلال والبكاء على الزمن المفقود بل بالخلق والإبداع والتجديد الفكري والبحث العلمي كأننا نصنع شعبا جديدا وحضارة جديدة، لا تتنكر لماضيها وجذورها لكنها لا تأخذ من الماضي إلا ما هو في تناغم مع حركة التاريخ.
ومن حيث ما يعطل الإشعاع العالمي لأدبنا العربي، عندما نجعل سبب تخلف الكتاب العربي يكمن أيضا في منافسة الكتاب بلغة المستعمر له، أرى شخصيا، بالتواضع الذي يجب، أن الأدب إبداع وأننا لا نفرض على المبدع لسان إبداعه كما لا نفرض عليه مجال إبداعه. هل يمكننا أن نفرض على مبدع أن يعبر بالموسيقى عندما لا يجد في نفسه القدرة على التعبير إلا بالفن التشكيلي؟ فبأي لغة يتكلم الفن التشكيلي وبأي لغة تتكلم الموسيقى؟ كذلك الأمر في اللغة الأدبية، فالمبدع يكتب باللسان الذي يجد فيه القدرة على الإبداع، بحثا على التجديد عوض محاكات من سبقه من الكتاب.
أتذكر في هذا الصدد إجابة الكاتب المغربي المرحوم عبدالكبير الخطيبي عن سؤال طرح عليه في مائدة مستديرة بمراكش سنة 1988، وهو الذي يتقن أكثر من خمس لغات. السؤال هو: "لماذا تكتب بالفرنسية؟". فأجاب بأنه سيستعير إجابة صامويل بيكيت على نفس السؤال وهي: "لأنني أحب أن أقول سافا، سافا" (Parce que j’aime dire ça va ça va). نعلم أن اللغة الأم لبيكيت هي الإنكليزية وقد بدأ الكتابة في تلك اللغة وأنه كان في مرحلة من حياته سكرتيرا لمواطنه الإيرلندي جايمس جويس ولكنه اختار الفرنسية ليتخلص من تأثره بجويس وينطلق حرا لإبداعه في لسان آخر. أستحضر هنا أمرا شخصيا، بما أنني أكتب بالعربية والفرنسية وإن كنت لا أنشر إلا بالفرنسية (نشرت فقط بعض النصوص العربية المنفردة في دوريات ومجلات): فكثيرا ما أبدأ نصا في إحدى اللغتين وفي مرحلة ما تغمرني حاجة ملحة إلى الانتقال به من اللغة الأولى إلى الثانية دون أي تقصير في شغفي ومحبتي للغتين.
فلنتفق إذن إن كنا نريد كتابة إبداعية أو كتابة موظفة ومسيسة أيديولوجيا مهما أنكرت على نفسها ذلك. إن كان همنا الإبداع حقا، فلتكن كلمة السر عندنا: أبدع في أي فن وبأي لسان استطعت أو شئت، وما هو غير ذلك "فأدبيات" كما قال الشاعر الفرنسي بول فرلين. هل كان مطلوب منا أن نفرض على العبقري كاتب ياسين ألا يكتب لأنه لا يقدر على الكتابة باللسان العربي، وبما أنه فعل هل نجرده من أصله ونرمي به عند "المستعمر القديم"؟
كاتب ياسين كتب كما لم يكتب أحد قبله في إحداث إنشائية (une poétique) حديثة تمزج بين اللغات والثقافات والأجناس الأدبية، بشاعرية تميزه، وهو ما أطلقت عليه في بعض أعمالي "إنشائية النص المختلط". فارتقى بذلك إلى الكونية ولقب بـ "رمبو المغرب" (le Rimbaud maghrebin) وجعل نصه المحوري "نجمة" عصي في التعريب على أبرز المترجمين العرب، على الأقل من خلال ترجماته الثلاث الأولى. وهو موضوع شائك حاضرت فيه في الجزائر وفي تونس ولم أوفه حقه من البحث والتمحيص.
وفي حال يكون الكاتب يتقن اللغتين فيتنقل إبداعه بينهما، أليس في ذلك إثراء للتجربة الأدبية وفتح لآفاق تجديدية هي في صلب سؤال الأدب؟ أشير هنا إلى بعض التجارب المهمة في الأدب التونسي كتجربة فرج الحوار مثلا وربما لتجربة رشيد بوجدرة في الجزائر مع الجدل الذي قام حولها في بداية ثمانينيات القرن الماضي. فالكتابة بلغة الآخر تؤسس لإبداع يتصدر موقع التقاطع بين لغتين وبين ثقافتين نحو التجديد والإثراء على درب سؤال الذاتية والآخرية. سواء شئنا أم أبينا، تبقى لغة الآخر، ولو كان مستعمرنا القديم، "غنيمة حرب" (والعبارة لكاتب ياسين) يمكن الاستفادة منها إن نحن تخلصنا من عقدنا تجاه المرحلة الاستعمارية ونظرنا إلى المستقبل بمنطق الحتمية التاريخية التي تفرض التطور والتقدم والتغيير. ولعل مقولة كاتب ياسين مستوحاة من حديث منسوب للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) مفاده أن من أراد تفادي شر قوم تعلم لغتهم.
يبقى أن نشير إلى موضوع الترجمة في علاقة بالقضية المطروحة وهي الصعوبات التي تعترض الأدب العربي في محاولته اكتساح الفضاء العالمي.
لنشدد في البداية عن الفصل الضروري بين الترجمة والإبداع في لغة الآخر فهما عمليتان إبداعيتان من طبيعة مختلفة ولو تعددت نقاط التقاطع والالتقاء بينهما. فالترجمة هي نقل تجربة إبداعية من لغة إلى أخرى وفيها درجات مختلفة من الإبداع في علاقة بقضية الأمانة والخيانة للنص الأصلي ولغته وإنشائه. أما الكتابة بلغة الآخر فعملية إبداعية حرة ومستقلة عن الحدود التي تفرضها الترجمة وهو ما يمكنها من اللعب بكل طلاقة وجرأة على التقاطع الإنشائي بين لغتين وثقافتين لتصور أدب جديد هو أدب "النص المختلط" (Le texte mixte).
قد يطول الحديث في مختلف جوانب موضوع الترجمة عامة والترجمة في العالم العربي خاصة، مما قد يذهب بنا أبعد من القضية المطروحة للنقاش هنا وهي صعوبات الرواج والإشعاع العالميين للأدب العربي. أما عن الترجمة كعامل انتشار لأدب ما، فجدير بنا التوقف عند أسئلة ما نترجم ولمن نترجم وماذا نفعل لترويج ترجماتنا، خاصة أن بعض الدول العربية أحدثت مراكز أو معاهد للترجمة (والضرورة تقضي بالتمييز بين دور المركز وأهدافه ودور المعهد وأهدافه) لا بد من تقييم أدائها بانتظام لتصحيح المسارات التي قد تحيد عن الأهداف، إذ كثيرا ما تكون هذه المراكز رهينة لاختيارات المسؤول الأول عنها أو صاحب السلطة عليها، رغم مجالسها ولجانها المتعددة، وذلك لأسباب عدة، وكثيرا ما يحكم هذه الاختيارات الميل الشخصي أو العلاقاتي المقنع عوضا عن سياسة تشاركية مدروسة على أوسع نطاق. لعل الداء يكمن في ما أشار إليه أبوبكر العيادي بصفة غير مباشرة عنما لمح لغياب الديمقراطية في مجتمعاتنا وجعل منها سببا مهما من أسباب التخلف الفكري والإبداعي ومن التأخر عن قطار الحداثة؛ إذ ما مؤسساتنا سوى أمثلة مصغرة لنظامنا السياسي والمجتمعي العام. والترجمة عندنا في ارتباط وثيق بهذه الأمور.
أولا، اعتبارا لتأخرنا العلمي والتكنولوجي، فإننا نسعى لترجمة العلوم قصد الأخذ بناصيتها واللحاق بركب التطور، غير أن السؤال ماذا نفعل بهذه الترجمة في مدارسنا وجامعاتنا وفضاءاتنا الثقافية؟ وما هي نسبة الاستفادة من تلك الترجمات إذا كان مستعملوها عندنا يتقنون لغاتها الأصلية؟ لا بد من أرقام واضحة في هذا المجال ومن تحاليل موضوعية تتقدم بنا لوضع أفضل الاستراتيجيات المؤدية لأداء أفضل النتائج وأنجعها.
وعن موضوعنا المتعلق بإشعاع الأدب العربي، لنسأل عن عدد إبداعاتنا الأدبية التي نترجمها على الأقل إلى الإنكليزية والفرنسية بأنهما اللغتان الأكثر استعمالا في الترجمات. عندها ندرك لماذا قد يروج للكتاب المكتوب في لغة الآخر أكثر منه للكتاب المترجم، وإن كانت الأرقام في هذا الشأن غير مثبتة والتحاليل قليلة الموضوعية. فحتى في الإبداع، نحن نترجم نصوص الآخر إلى لغتنا أكثر من ترجمتنا نصوصنا إلى لغة الآخر.
بعد ذلك لا بد من إضافة المشاكل المتعلقة بنسبة الاستثمار في ترجمة الأدب العربي نقلا ونشرا وتوزيعا وإشهارا، فالحركية والحماس في هذا الباب محتشمان رغم أن بعض أثرياء بلداننا يسرفون في الإنفاق عندما يتعلق الأمر بشؤون أخرى. طبعا هم أحرار في أموالهم، لذلك نتحدث عن وعي مواطني يجب أن يعم لتكون الأغلبية المقتنعة قوة ضغط معنوي مؤثرة في البقية التي قد يكون إسهامها أكثر فاعلية بما تملك من مال أو من جاه.
وفي الختام، الرأي عندي أنه لا يمكن فصل قضايا الأدب والكتاب عن النمط المجتمعي الذي نريده لأنفسنا وعن درجة الوعي التي نريدها لجل المواطنين إن لم تكن لجميعهم. وهذا أمر يتطلب بناء قد يستغرق على الأقل زمن جيل كامل إن نحن بدأنا اليوم في وضع الأسس القويمة للمسار المنشود. لكن أين لنا بهذا والوعي متأخر والهم الغالب تائه في خصومات سياسوية لأجل السلطة والتسلط؟
"الصناعة واسعة والعمر قصير" (L’art est long et le temps est court) يبقى السؤال قائما: "بِمَ تأخرنا بعد أن كنا في الطليعة وتقدّم الأوروبيّون بعد انحطاطهم؟!" الجواب في إعادة قراءة التاريخ.
أستاذ متميز بجامعة تونس المنار - مفكر وكاتب ومترجم وإعلامي