حنينُ الروح وسُقْيَاها في قصائد إبراهيم داوود
يمثل الشاعر المصري إبراهيم داوود حالة إبداعية وإنسانية مائزة، حيث ظل حضوره في كل مرحلة من مراحل رحلته الإبداعية مؤشراً على مجموعة من القيم الجمالية والفنية والإنسانية التي ظل مخلصاً لها وحريصاً على توهجها رغم التحولات التي تسم كل دورة وكل طفرة أو توجه يتبناه المبدع أو يذهب إليه، منها حميمية نصه وطزاجته الدائمة وبساطته العميقة، وبالتالي قدرة هذا النص على اقتناص الألق الشعري وتطويره لأدواته الفنية، جنباً إلى جنب مع المتعة التي باتت مضمونة عند التلقي، الأمر الذي يجعل من نص هذا الشاعر طول السنوات، رفيقاً مضموناً للوعي وصديقاً مدهشاً للروح والقلب، في الآن ذاته.
ومن هذه القيم كذلك التساوق الواضح بين كتاباته سواءً منها الإبداعية الخالصة أو تلك النثرية المتمثلة في النصوص والمقالات، وبين التوجه الشخصي في القضايا العامة والأدبية والثقافية، فلا تعوقك أية نتوءات ومثالب أو تناقضات وأنت تتأمل مسيرة تتجاوز الثلاثين عاماً، بل إنك قد لا تلحظها بالأساس.
نجحت هذه الرحلة إذن في صنع حالة ظلت تكتسب تقدير المتلقين والنقاد من كل الأطياف ويرجع ذلك إلى صدق التجربة البادي وعدم تعاليها أو تكلفها عندما تتشكل هذه القيمة على هيئة كتابة ثم النظر الواضح إلى هذه الكتابة على أنها تجلٍ حقيقيٍّ من تجليات التواصل والصداقة مع البشر مثلما هي كفاح إنساني مشروع ضد القسوة والخراب والفناء.
ولد إبراهيم داود في العام 1961 ومارس نشاطه الشعري ضمن سياق وتوجه يضم محمود قرني وفتحي عبدالله وعاطف عبدالعزيز وشريف رزق وعلي منصور وسمير درويش ومهدي محمد مصطفى والسماح عبدالله وعماد غزالي وفاطمة قنديل وهم من أطلق عليهم: جيل الثمانينيات في الشعر المصري، على الرغم من التباين الفني الواضح والانحيازات الجمالية المختلفة والتمايزات بين المشاريع الشعرية.
نص إبراهيم داود سيظل نصاً إنسانياً مهموماً بعذابات البشر وبصرخاتهم المكتومة، وسيظل هو الأقرب للكثير من الشعراء التاليين له
ثم أصدر ديوانه الأول "تفاصيل" عام 1989 لافتاً الانتباه بداية من العنوان لعقيدة فنية مغايرة تظهر إرهاصاتها وتحتفي باليومي والعابر والهامشي رغم أن القصائد تنتمي للقصيد التفعيلي وهو التوجه الذي ظهر وتأكد بشكل أكبر مع ديوانه الثاني "مطر خفيف في الخارج" الصادر عام 1993 والذي اقتربت قصائده التفعيلية بشكل جلي وواضح من روح قصيدة النثر وبنيتها وولاءاتها الفنية حتى حُسم الأمر تماماً مع ديوان "الشتاء القادم" عام 1996 الذي تخلى فيه عن الوعي الأقرب للرومانسية وامتداداتها البلاغية في الديوانين السابقيْن، هذا الوعي الذي اقترح لغة غنائية تتماهى مع واقع القرى الشفاهي الذي يقتات على الإيقاع وجرس موسيقى الحياة السوداء/الخضراء والمُحَمَّلة بالتفاصيل التي تتهادى على ظهر الغناء، وذلك رغم المحاولات الظاهرة بشدة للتمرد واقتراح جماليات مختلفة ومسارب تتمكن عن طريقها الذات الشاعرة من القبض على صوتها الخاص ذي الحمولات الفلسفية والفنية الأكثر مرونةً واتساعاً، وهو ما تحقق في "الشتاء القادم" الذي دشّن به مسيرته كأحد أهم أصحاب المشاريع المتميزة في قصيدة النثر المصرية منذ نهاية القرن المنصرم، بمدينيته وسينمائية عالمه وتعاطيه مع يوميات كائنات الطرقات والشوارع ومحاولة الإمساك بالمشاعر الظاهرة والمُضْمَرة في التفاصيل الصغيرة أو في الصمت.
ثم توالت دواوين داوود: "لا أحد هنا"، "انفجارات إضافية"، "حالة مَشيْ" وأصدر كذلك مختارات شعرية بعنوان "يبدو أني جئت متأخراً" ثم يُقْدِم شاعرنا على أن يجمع دواوينه الستة في مجلد واحد تحت عنوان "ست محاولات" وهو العنوان الذي يُشير لتوجهٍ يرى الشعر مجرد محاولة لطرق باب الروح التي تغيب وتنسانا والإلحاح على أنها محاولة محفوفة بالمخاطر طول الوقت.
ويواصل بعد ذلك مسيرته بديوانيْ "أنت في القاهرة" عام 2015 والذي فاز بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب كأفضل ديوان شعر فصحى ومؤخراً أصدر ديوانه "كن شجاعاً هذه المرة" في عام 2019 بالإضافة إلى كتبه النثرية: "خارج الكتابة"، "الجو العام" الذي فاز بجائزة ساويرس 2012 وانتهاءً بـ "طبعاً أحباب" 2019.
يقدم داوود شعريةً تقوم على تأمل واستنطاق تفاصيله الشخصية وفتح مساحات من السرد السيري والحكي المُضَمَّخ بالشجن والحنين وكذلك على الالتقاط الذكي لدراما حيوات الآخرين مستخدماً لغة صافية، وتكاد تكون متقشفة وعارية من الجزالة المتكلفة أو الألعاب اللغوية، مُقصياً كل ما هو سامٍ وفخم ومتعالٍ وحكيم وعليم وغريب عن جوهر التجربة لحساب الهش والبسيط والعادي والقريب والقلِق والشاك والمتسائل الماكر عديم اليقين، وكأن هذا الشاعر بولاءاته وأداءاته الفنية وموقعه التاريخي كمنتمٍ لجيلٍ جاء تالياً لجيل مركزي قدّم نفسه في بداية وجوده وأثناء صراعه الوجودي مع أجيال الكتابة التقليدية التي كانت تحاصره وتخاصم كل تجديد، كمفجِّر للغة وكصياد ماكر يلعب مع العالم من حيث هو معجم كبير، وهو جيل السبعينيات الذي أعلى من قيمة التجريب في الشكل والأداء اللغوي والذي كان يعتبِر اللغة والشكل مركزاً وأساساً يصح أن تبدأ منه التجربة وتنتهي إليه، وهي التوجهات التي أتى نص داوود على النقيض تماماً معها حيث يطرح عنه كل ما يثقله ويتعالى عليه من تكوينات وألعاب وزخارف وثورية عالية النبرة ومجازات مركبة ومعقدة ثم يقترب به من الضعف الإنساني والهمس والشجن والهشاشة ويُقَرِّب المسافة بين الفصحى والمفردات العامية المصرية التي لا تقل بلاغة وفاعلية.
أقول، وكأن هذا الشاعر يصح أن يكون شاهداً على مفارقة أن غالبية شعراء السبعينيات تخلوا في السنوات الأخيرة عن تللك الولاءات الشكلية نحو خيار الأجيال اللاحقة وبهذا قد يصح أن نقول، وإنْ بحذرٍ وتوجسٍ مُفْتَرضَيْن علمياً، أن رهان إبراهيم داوود ومن يبحث مثله عن الصفاء اللغوي قد نجح في اختبار الزمن، ذلك الراوي العليم والمشارك الذي يقبع ليهز رأسه دائماً في النهاية.
يقول الشاعر: "الذين أهاتفهم على فترات متباعدة /وأُنهي الكلام بسرعة معهم/ أحبهم/ وغالباً ما أكون مشتاقاً لهم/ أما الذين لا أهاتفهم على الإطلاق/لا ينتهي الكلام بيننا" ديوان "الشتاء القادم".
هذه البساطة كافية تماماً لتدلل على وحدة البطل هنا وعلى حنينه المفرط لأزمان نفسية قديمة وَلَّت وانمحت وكذلك على اغترابه وسط تفاصيل الحياة التي تختار له أحياناً دور المتأمل البعيد وإن كانت هناك علاقات مباشرة تتوالى وتترى وتحيط به.
هذا النص الذي يُعلي من قيمة السرد ويكاد يخلو من المجازات الصريحة، يصلح في حد ذاته لأن يكون كنايةً كبرى عن حال الغريب في المدينة، هذا المحكوم بالماضي رغم الهواء الذي يتغير طول الوقت على رئتيه. إن الحنين هو قَدَر الشاعر وصليبه الذي يرعى داخله وينهشه ويسلبه من ذاته فيعيش وسط الزحام وروحه تهيم في أماكن أخرى:
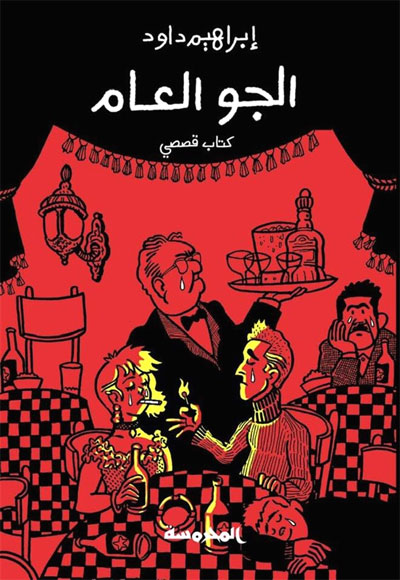
"عندما استدار/ كان الذي ناداه اختفى/ وأخذ معه صف البيوت/ التي مر عليها بعد الفجر".
لكن هذا الحنين قد يحقق بعض الأمان والعزاء لروح وثابة تقفز من زمن إلى زمن بحثاً عن الألفة وعن الصدق خاصة إذا كان لتفاصيل حية من ألبوم العائلة:
"إذا رجعت عشرين عاماً/ "الولد" الذي تمنى أن يكبر/ فأحب الكبار/ و"حَوَّط" عليهم/ خوفاً من الذين كبروا/ لأسباب خارجة عن إرادتهم".
هنا نلتقي بالبكاء على الأطلال كما يسمي الشاعر قصيدته وكأن جوهر الحنين إلى اللحظات المشرقة والزمن المكتنز بالبهجات واحد في كل دورة تاريخية لكن الفرق يكمن في الوعي وفي الإحساس وتراوحه الدائم بين الحدة والألم والخفوت واليأس. فما نحن إلا "بحارة" نأخذ بعض أرواحنا ونحن نخرج للبحر الغامض المتقلّب الذي هو الحياة لنستعين بالأريج وبالصور وبالذاكرة على الابتلاع المتوقع في كل لحظة:
"أخذنا معنا الحقائب والتصاوير/ والذكريات التي .. ربما/ احتجنا لها/ وتركنا أجدادنا في الحكايات" ديوان "لا أحد هنا". ورغم أن المقاهي هي العالم والدراما بشكل مكثف وموحي ومغري على الدوام باكتشاف الملامح المنثورة والأرواح الضالة أو القريبة، وهي الحضن المفتوح على الدوام والبديل عن طائرٍ بجَناحيْن كَبيريْن يضمنان الدفء، فإنها قد تقسو وتكشف حزنك ووحدتك واغترابك وتوقفك أمام مرآتك التي قُدَّت من حنين لتقول يا أخوتي أنا مزيف:
"ممتلئ أنا بـ (الليالي) / وأنا أركض/لألحق المقهى قبل أن يخلو/ سأُصدِّر إحساساً بالامتلاء/ وأنا أدخل/ لأقنع نفسي أنني أصبت/ وأقنعهم أن حزناً/ كالذي غادرت به ليلة أمس/ لا علاقة له بالأيدلوجيا".
كأنك مقامر أبدي يدفع بملامحه كلها في لحظة، فقط ليكتمل حلم الفوز والانتصار الذي هو هنا مجرد أن يربط مصيره ببشر حقيقيين:
"المقامر يهرب دائماً من الضوء/ يريد – فقط- أن يرى أصابعه/ وهي تعبث بمصائر خصومه/ خصومه الذين يعرفون ماذا يريدون".
وبما أن البطل يزداد صمتاً كلما ازدادت الحياة حوله ضجيجاً، ستظل عيونه تتسع وتتسع لا ليبصر ولكن ليشوف، إنها حكمة المقتول على الدوام:
"لم تحدث مفاجآت طوال هذه السنوات/ لأن المَداخل ظلت كما هي/ ورحل كثيرون/ وبقى الليل في مكانه". ديوان "انفجارات إضافية".
وهكذا يُقَطِّر الإنسان أحزانه وتفاصيله ويُغَلِّف حنينه الضاغط للحب وللماضي الآمن والطيب وللصفاء وللبهجة: بالخيال وبأرواح ودفء مَنْ رحلوا وبضحكاتٍ تَعْبُرُهُ لكنها لا تترك قلبه ولا تغادر نظراته.
إن الوحدة التي قد تكون خيارا آمناً ومضموناً: (سأحكي لكِ/عن القوانين التي وضعتها/ لكي أصير.. بمفردي) دائماً ما تُبرز مخالبها المُخبأة وتمسك بالكائن من روحه المتعَبة:
"في آخر الليل/- عندما أكون على وشك النوم -/ ألتقي كوابيسَ في الطريق" أنا الذي: "أحب أن أُسَمِّي الوحدةَ (شجرةً)" يعني حياةً، تتجدد وتتناسل بلا انقطاع بالحكي مع البشر الذين تقترب ملامحهم ساعتها منا: "كنتُ أحكي له عن أمي/ التي ماتت ليلة العيد/ وكان الطعام على النار/ ومسرحية (منين أجيب ناس)/ في التليفزيون" البشر الذين يحلم بهم دائماً كأنهم سبيل النجاة الوحيد: "سيجد بشراً/ خُلقت ابتساماتهم له/ وغناءً غزيراً/ يحرس هدوءه/ وامرأة تغمره بالحرارة/ بعد أن فقد ملامحه/ في العمل".
وفي النهاية سيبقى هو رجل الحكايات سواء مع البشر أو مع الظلال: "الرجل المسكون بحكايات متناثرة/ ناقصة/ الذي نصحه الأطباء كثيراً/ الملول/ الذي يرى البكاء/مضيعة للوقت". ديوان "حالة مَشْيْ".
وهكذا وكما كان منذ بدايته، سيظل نص إبراهيم داود نصاً إنسانياً مهموماً بعذابات البشر وبصرخاتهم المكتومة، وسيظل هو الأقرب للكثير من الشعراء التاليين له، بطموحه منذ البداية للوصول إلى جوهر الشعر باعتباره سؤالاً وجودياً يمسك بالروح من كفوفها ليقودها في متاهتها الأزلية نحو الكشف والبصيرة، وباعتباره لعبة مع القَدَر ومع الزمن ومع تأملاتنا لسيرتنا وملامحنا المحفورة على الجِلد وسيبقى الشاعر كائناً يمشي في الأسواق ليس رائياً ولا نبياً وإنما تحاصره القسوة الإنسانية والسطوة المادية البشعة والحروب فيبحث مع البشر عن الخلاص، ويكون الشاهد على الحلم ووهجه، وكلما عم الخراب يزخرف لهم الموت علّه يقع في الفخ ويعود وردةً في يد مُرَاهِقَةٍ تطلُّ من النافذة القريبة وتبتسم.







