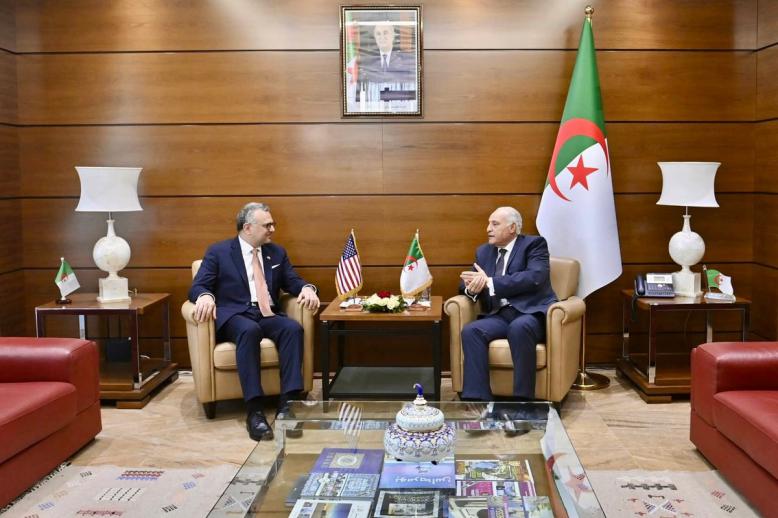كيف يعيش الناس في قطاع غزة بعد عامين من الحرب؟
لا أتحدث هنا عن الأحوال السياسية والاجتماعية العامة، ولا عن حرب الإبادة والتدمير والجوع، وكل ما تتناقله الأخبار وتنقله الفضائيات، بل عن مصدر رزق الناس، ومن أين يأتون بالمال لتلبية احتياجاتهم الضرورية بعد عامين من الحرب، وفي ظل شبه انعدام لكل شيء، أو توفره بأسعار خيالية.
في قطاع غزة، فقد أكثر من 90 في المئة من السكان مصدر رزقهم بعد الحرب. الفلاح فقد أرضه بسبب الاحتلال، أو أصبحت غير صالحة للزراعة نتيجة أعمال الجيش وتدمير آبار المياه. والعمال فقدوا أعمالهم نتيجة النزوح المتواصل وتدمير المصانع وورش العمل. والتجار أغلقوا محلاتهم بسبب النزوح، وفقدان البضائع، وغياب المشترين. أما الطبقة الوسطى من أطباء وأساتذة جامعات ومدرسين ومحامين ومهندسين وغيرهم، فقد فقدوا مصدر رزقهم أيضًا. ورجال الأعمال دُمّرت مصانعهم وتعطلت مشاريعهم التجارية من استيراد وتصدير. والعاملون في مجال الصيد البحري فقدوا عملهم بسبب إغلاق البحر أمامهم واستهدافهم من قبل البوارج الحربية.
حتى النسبة القليلة ممن تبقوا من موظفي السلطة الفلسطينية، وعددهم لا يزيد على 25 ألفًا، يتلقون 50 في المئة من الراتب، وعند سحبها أو التصرف فيها تنقص إلى النصف بسبب انعدام السيولة وجشع الصيارفة والتجار. كما أن وكالة الغوث (الأونروا) أوقفت تقديم المساعدات الغذائية الأساسية لغالبية سكان القطاع من اللاجئين. وهناك عدد محدود من موظفي المنظمات الدولية، وخصوصًا الأونروا أو العاملين مع وكالات الأنباء والفضائيات الأجنبية. كما أن نسبة لا بأس بها من السكان المنتمين للأحزاب والفصائل، كحركتي حماس والجهاد، وكل فصائل منظمة التحرير، كانت تتلقى رواتب ومساعدات عينية توقفت وقت الحرب.
كما أن أقل من 30 في المئة يعيشون في منازل حجرية أو أطلال منازل، إما مملوكة أو مستأجرة، والبقية في خيام لا تحميهم من برد الشتاء ولا من حر الصيف. حتى هؤلاء فقدوا القدرة على شراء خيام أو استئجار أرض لنصبها. والقطاع كله تقريبًا لا تتوفر فيه شبكات مياه للشرب أو مجارٍ للصرف الصحي، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، وتعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة عامين، وتدمير المستشفيات، وانعدام الخدمات الطبية، وفقدان أغلب الكفاءات من الأطباء والمهندسين والعلماء وأساتذة الجامعات، إما بالموت أو الأسر أو الهجرة. وتقارير المنظمات الدولية تتحدث عن كل ذلك بالتفصيل.
ومع ذلك، توجد طبقة أو فئة محدودة العدد اغتنت وقت الحرب، وجمعت الملايين على حساب معاناة الشعب. وهؤلاء من لصوص وتجار المساعدات الخارجية، وممن يطلقون على أنفسهم صفة "المبادرين"، الذين يفتحون حسابات في دول أجنبية لجمع تبرعات لأهالي غزة ممن فقدوا أبناءهم أو هُدمت بيوتهم، أو لبناء مستشفى أو مسجد أو مدرسة أو مراكز إيواء وإطعام للجياع، فجمعوا الملايين، ولم يصل منها للمعوزين إلا أقل القليل، وهناك أسماء معروفة يتداولها فلسطينيو القطاع. أيضًا الصيارفة الذين يخصمون ما يصل إلى نصف المبلغ على كل تحويلة مالية.
والخلاصة أن الغالبية العظمى من سكان غزة تحولوا إلى متسولين، إن وجدوا مُحسنًا دوليًا يتصدق عليهم، أو يتدافعون حول مراكز "الموت الأمريكية" التي توزع بعض المساعدات، ويُقتل يوميًا العشرات في محاولتهم الحصول على كيس طحين أو بعض المعلبات. وفي مخيمات وخيام النزوح في المواصي والمنطقة الوسطى زالت الفوارق الطبقية والنفسية بين الناس، فتجاور الطبيب وأستاذ الجامعة مع ابن المخيم والعربنجي والطوبرجي وعامل النظافة، والجميع يصطفون في الطوابير أمام التكيات للحصول على وجبة عدس أو أرز.
عندما يصبح هذا حال الشعب، فلا نستغرب ظهور بعض مظاهر انهيار المنظومة القيمية والأخلاقية التي طالما افتخر بها أهالي غزة، فمع الصراع من أجل البقاء ومحاولة توفير الطعام للأبناء، يصبح كل شيء مباحًا. كما لا نستغرب رفض السكان للاحتلال ولسلطة حماس معًا، وترحيبهم بأي مبادرة لوقف إطلاق النار، حتى لو كانت مبادرة ترامب.
هذا الواقع المؤلم لا ينفي وجود مظاهر البطولة والشجاعة والكرم والصمود التي اشتهر بها أهالي القطاع وكل الشعب الفلسطيني، لكن للصبر حدودًا، وللشعب قدرة على الصمود، مهما اشتدت المحن.