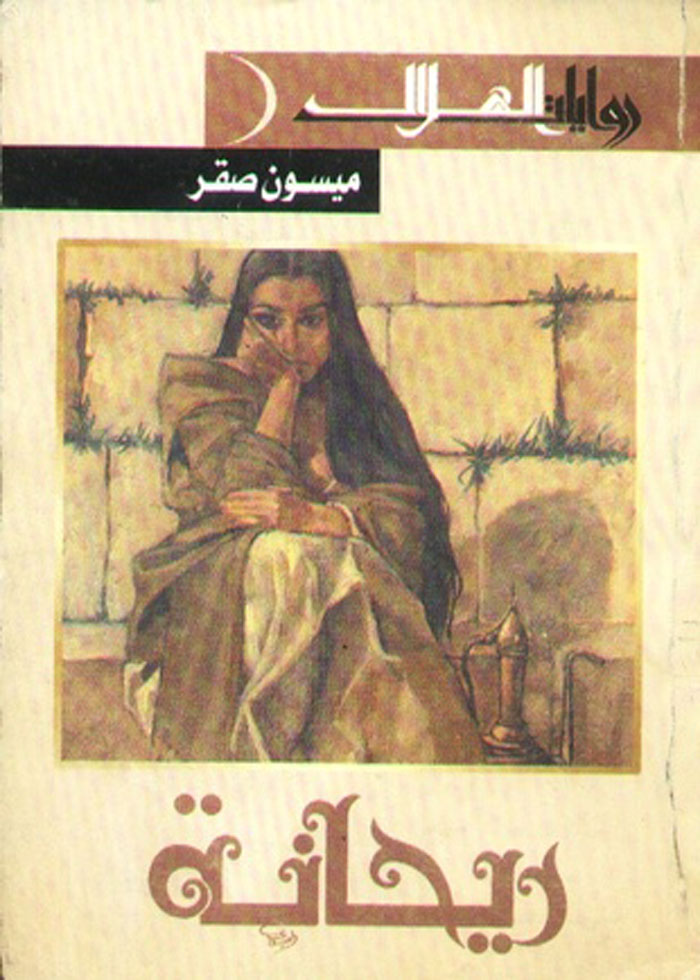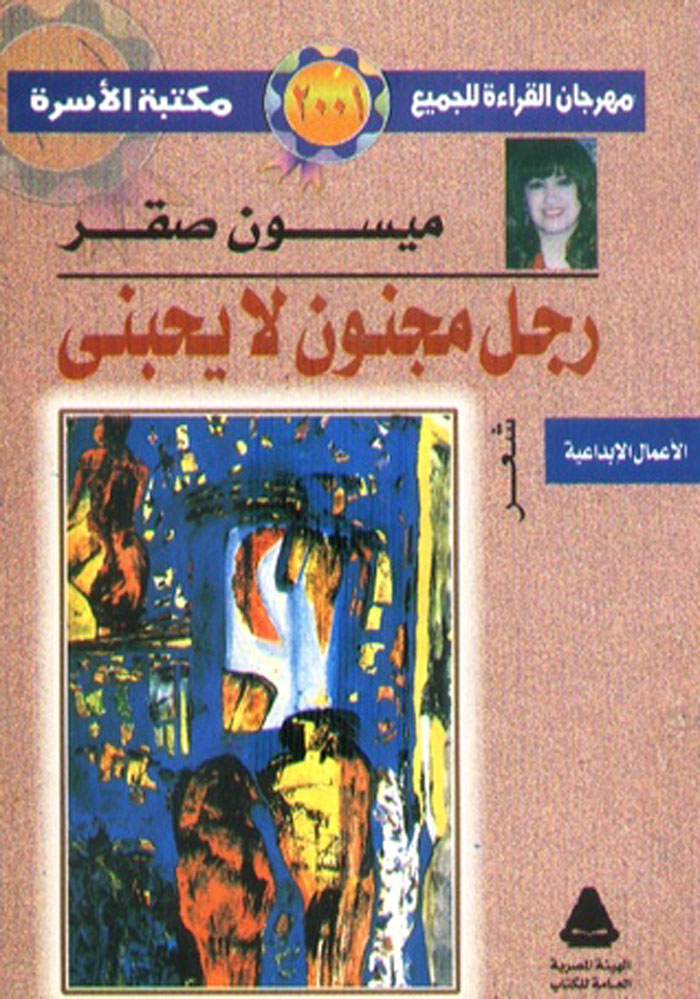لآلئ ميسون صقر تحلق فوق الخليج
"هَلْ مَعَكَ مفْتاحٌ مَا البَابُ لا يُفْتَحُ إلاَّ بسرٍّ واحدٍ" هكذا تسأل ميسون صقر في إحدى قصائدها وكأنها تشي لنا بأن هذه الروح التي تسكن أضلعها مشغولة بسؤال الغربة، وتدور مع سؤال الهوية، وتقتفي سر الحب، حب المكان والألفة والتفاصيل والذكريات التي تتحرك على قدمين، وبالتالي محبة إنسانية الإنسان ذاته أينما حل، وأينما ترك ظله ووشم وشمه وحفر بصمته.
مكان الشاعرة التي تهمس "أرقصُ علي شبرٍ من الأرض" ليس هو الحيز الذي ترسمه من خلال تواجدها بين الجدران أثناء تنقلاتها الكثيرة، وإنما هو مكان النفس والهوية وحفظ الملامح، المكان المحفور على عظامها، الذي يسكن بصرها وبصيرتها على الدوام، صاحب الملامح المرنة في التشكل والوجوه الكثيرة لكنه الأصيل دوماً، الصافي الذي لا يفقد براءته وهواءه السابح في يود الماء المكتنز بالأرواح والأضواء واللآلئ.
عندما تتعامل بشكل مباشر مع ميسون صقر تحتار قليلاً بين كائنيْن يطلان من عينيها، الأول هو الطفلة التي تكاد تقفز للسماء لتسألها كيف أنها لا تكبر أبداً وتشكرها على اللؤلؤة التي تجدها أسفل مخدتها كل يوم، والكائن الثاني هو الأم التي تحتوي الكون كله وتربت عليكَ أينما كنت وتقول هون عليك يا أخي، هي الحياة التي تحتوينا رغم قسوتها، فلنسامحها قليلاً لتخفض صوتها وتُسقطَ من كُمِّها سراً جديداً في كل يومٍ، مفتاحاً يقود خطواتنا ويمسحُ غربتنا.
تجمع إذن ميسون بين الروحيْن الأنقى كما تجمع بين مكانيْن، تحبهما وتنصت لدبيب رقصاتهما وتخوفاتهما من الأيام البخيلة وتشم العبير وتجدل الأسرار في ضفيرتها التي لا تكبر إلا في أيام الصيد كي تظلل على الصيادين وتجلب النسيم لأرواحهم.
لكل مكانٍ من هذيْن المكانيْن اسم، لكنهما عندها أكبر من كل الحروف، الإمارات ومصر، وكما هي في الأولى تقود المبدعات الحداثيات في سعيهن لتغيير الذائقة وتكسير القيود والقبض على الضوء الكامن في أعطاف التراث المضيء، يعتبرها المصريون كذلك جزءاً أصيلاً ومشروعاً شعرياً حقيقياً يتساوق مع منجز جيل الثمانينيات الشعري الحداثي المصري، هي الإماراتية الكاملة والمصرية الكاملة التي تتحدث عن مصرها التي تشكلت فيها أجزاء معتبرة من شخصيتها هكذا:
"مصر أكبر من مجرد وطن أو وتد أو ملاذ، أكبر من كلام عابر تافه، أكبر من مجرد حكي، هي ست الدنيا وأم الشهيد وطفلة المحبين، البلد الوحيد الذي تحس بحنانه يغمرك وطيبة أهله تحضنك، البلد الذي توصفها بالأنوثة في حنانها وصبرها، وبالرجولة بصلابتها وقوة شكيمتها، وبالطفولة في خفة روحها وبكارة أفعالها، السذج لا يعرفونها، الحاقدون لا يعرفونها، الكارهون لا يقتربون منها، لتعرفها لا بد أن تدخل بقلب ناصع محب.."
هذه الشاعرة الحقيقية هي نفسها الروائية المجيدة والفنانة التشكيلية اللامعة وكاتبة السيناريوهات وصانعة الأفلام والناشطة الثقافية والمشاركة في صناعة النهضة الثقافية، وما سوى ذلك من ضربات للفرشاة في دفتر حياة بقوة الأثَر وخفة الريشة في الآن ذاته. هذه الصلبة رغم كل شيء، "بَدَأت حياتها بالهزيمة"، كما تردد دائماً، حيث فتحت عينيها على العالم لتجد انقلاباً على والدها، ووجدت نفسها مطرودة من وطنها، تفتَّحَ وعي الطفلة على الانقلابات السياسية والأسرية، ثم تشبعت ذاكرتها بالتمثيل الأقسى للهزيمة مع هزيمة 67.
تقول ميسون "إنها حين فتحت باب العالم بدأته بالهزيمة"، ومن يومها ربت يقينها على تحويل المرارات إلى فن وكلمات وكتب وأرواح، من يومها، من مبتدأها، والهم المسيطر عليها هو القبض والعض بالنواجذ على ما كان ونفخ الروح في اللحظات كي لا تندثر من بين أصابعنا، وكلما قرأنا عملاً جديداً لها أو تأملنا في لوحات معرض جديد أو حتى تابعنا أخبار نشاط ثقافي تقوده، ندرك أنها قد انتصرت مرة أخرى على كل هذا الفقد بكل هذا الفن.
ماذا تراه قال للأرواح الطيبة التي ترافقه في الحياة الأخرى، هذا الأب الحاكم والسياسي الكبير والشاعر الحالم الفنان، عن الجهد الأسطوري الذي بذلته ابنته ميسون التي وصفها من قبل في صغرها باللؤلؤة عندما حصلت على شهادة تفوق في سنواتها الدراسية الأولى، لحفظ ديوانه وفرش سعادتها بالالتصاق الفني الكامل به على مسافة عشر سنوات كاملة مضمخة بالدأب والإصرار لتصل إلى جمع وتحقيق كل ما يخصه من أشعار عربية ونبطية وأغنيات وصور وأوراق وأسرار في أربعة أجزاء من القطع الكبير مجموعها أكثر من 1700 صفحة، لتُثَبِّت الصورة على حياة كاملة وعصر كامل عاينتهُ وأرخته لبلدٍ يجري منها مجرى الدم.
ربما صحت بعد كل العَدْو واللهاث الذي يشبه الغناء ونظرت للأب الحاني نظرة الأم وقبلت يده المبدعة وابتسمت من قلبها وهو يقول بوركتِ يا أم أبيكِ. ولكن هل اكتفت من غاية حفظ روح هذا الوطن بسيرة ومسيرة وفن أحد أعظم أبنائه؟ بالطبع لا، بل دلفت ميسون إلى الطرف الآخر من اللوحة لتقبض على حياة الغواصين البسطاء وهم يطاردون اللؤلؤة الخالدة ذات الحياة المتوهجة والمخفية في القلب، الذين يضحون بحياتهم في سبيل شمس بلدهم التي تصهرهم ليضيئوا، يغوصون بفدائية الصوفي المهووس بالسر، هل تستطيع يا صديقي وَصف لحظة القبض على اللؤلؤة التي تبرق بعد أن تكون روحك قد قاربت على التحليق ومغادرتك أكثر من مرة في كل مرة؟
بالطبع تستطيع لكن قلمك لن يرتعش بالمحبة الغامرة له مثلما فعل قلم ميسون أثناء كتابتها رواية "في فمي لؤلؤة".. كان يرتعش رعشة شم أريج لحظات مبهرة من حياة بلادها الغالية أو بالأحرى حياتها التي تماهت فيها.. هذه الرواية الفاتنة هي روايتها الثانية بعد روايتها الأولى "ريحانة" التي كتبتها وهي ترافق أمها في المستشفى، الأم الإماراتية العظيمة التي تحمل على ظهرها الكثير من الأحداث والحوادث، فكأن إبداع ميسون هو تحية دائمة لروحها التي دخلتها ذاتَ نورٍ ولم تخرج أبداً..
"أمُّهُ مُتَّشِحَةٌ بِردَاءٍ بَسيطٍ وعَلَى رَأْسِهَا.../ لَم تُظْهِرْ الصُّورَةُ سِوَى الجُزءِ العُلويِّ مِنْ الجَسَدِ/ أمَّا أُمِّي فَكَانَتْ تَجْلِسُ مُعْتَدِلةً/ عَلى كُرْسِيٍّ عَرِيضٍ مُذَهَّبٍ/ يَدَاهَا على المَسْنَدينِ، كَمَا يَلِيقُ بأَمِيرَةٍ".
في الروايتين تجمع ميسون بين الإبداع المركب من طبقات عدة والأداء الفني المحكم وبين غرض حفظ الهوية وحفظ التاريخ وتوثيق تفاصيل الحياة والروح الحية النابضة للبلد بما يكافئ عشرات الأعمال التاريخية. ظلت ميسون تُذَكِّر نفسها دائماً بأن ارتباكها مع العالم في البداية، كان في حاجة إلى لغة، إلى شفرة للتواصل مع الآخر، هذا الذي قد يحمل الجحيم مثلما يشي بالنور، هذه اللغة تتكون من حرفين كبيرين هما الشعر والفن التشكيلي، اللذان تحكي من خلالهما وتبوح، كما قد تتخفى من خلالهما وراء المجازات والألوان المتشابكة.
وبعدما قادتها قصيدة النثر بسرديتها العالية للرواية قادها الفن التشكيلي لصناعة الأفلام، وكما اعتادت أن ترى كل إبداعاتها، مستويات متعددة من لغتها الخاصة، التي بها تتواصل مع العالم، ومنظورات متباينة لعيون متقدة ترى الفن إجابة على سؤال الزمن واللعب الإيجابي مع الموت، فإنها ظلت بالنسبة لنا طائراً يحمل على جناحيه وَهَجاً ينبعُ من لآلئ كثيرة وحميمة وصادقة في كل مرة. هذا الفن الجميل وإن كان يهدف دوماً للقبض على الهوية فإنه يحلق كذلك مع أحدث التقنيات وأكثرها طموحاً للخصوصية والتجاوز.