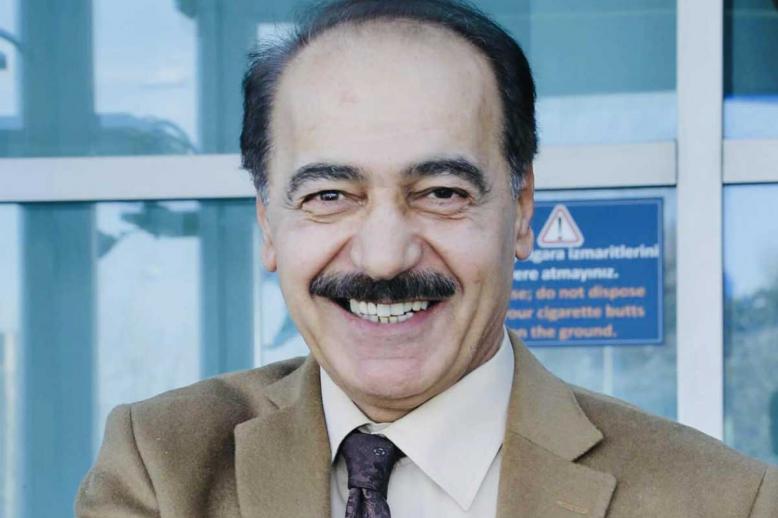محمد مزوز: آن للأحفاد أن يعيدوا قراءة تاريخ الأجداد لإعادة السيوف إلى أغمادها
يفتتح الباحث د. محمد مزوز كتابه "فلسفة الدين بين التجربة الباطنية والتأمل النظري" الذي يجئ خارطة طريق للمؤمن، يوزع العلامات على جانبي الطريق، من اهتدى بها نجا، ومن أخفق في التقاط الإشارات ضل وتاه، متسائلا: لِمَ هذا الكتاب عن فلسفة الدين؟ ما الإضافة المفترضة إلى كل ما كُتب ويكتب عن فلسفة الدين؟ ويعتقد أن هذا النوع من التصنيف ضروري في زماننا هذا أكثر من أي وقت مضى، ما دمنا نعيش فترات عصيبة يهيمن عليها الغلوّ من هذا الجانب أو ذاك. فليس الغلوّ الذي نلحظه اليوم بالعابر كما قد نتوهم، بل قد يستمر لعقود أو لقرون. فحياة الشعوب لا تقاس بالفترة والمدة والعقد والعقدين، وإنما تقاس بالعصور الثقافية وبالدورات الحضارية.
ويقول: "وضعنا الحضاري لا يجعلنا في المقدمة ولا في المؤخرة، نحن في وضعية بينية. وهذا بالضبط ما يجعل الانحراف ممكناً وسهلاً: الانحراف الذي يعيدنا إلى الوراء، أو الانحراف الذي يرمي بنا إلى الأمام. الاغتراب له وجهان: وجه أصيل يختزلنا في هوية واحدة ولون وحيد، ووجه معاصر يريد أن يستأصلنا من الجذور. ما نعتقد أنه أصيل فينا ولا يشترك معنا فيه الغير، ضارب في أعماق التاريخ السحيقة. الأصالة ليست لها بداية، هذا مجرد وهم نتمسك به لحماية الذات من خطر مفترض. الحداثة ليست ملك أيدينا، لم نصنعها بمعيّة غيرنا، بل استقبلناها في عقر دارنا عندما دخلت علينا دون استئذان".
ويلفت د. مزوز في كتابه الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود أن ليس المقصود بفلسفة الدين دراسة موضوع دين بعينه أو عقيدة محددة، وإنما هي نظر في تجليات التعالي وتمظهرات القداسة بصرف النظر عن الملابسات التي تشكلت فيها. فتجربة التعالي ليست حكراً على أمة أو شعب، والعلاقة مع المقدس ليست مشروطة بحقبة خاصة ولا بمجال محدد.
ويؤكد وهم من يعتقد أن الغلوّ يأتينا من الخارج، مادام كل خارج بالنسبة لنا هو داخل بالنسبة لغيرنا، بالطريقة عينها التي ينظر بها إلينا الغير بوصفنا ذلك الخارج. تحميل المسؤولية للغير، هو نوع من الإسقاط الذي يتوخى توفير الحماية للذات أو التستر على عيوبها. تأتي عيوب الذات من الأسرة (تربية وتنشئة)، من البرامج والمناهج الدراسية، من الوعظ والإرشاد.. المصادر متنوعة والهدف واحد: خلق مواطن متمركز حول ذاته (معتقداً، ولغة، وعرقاً). فكيف لمواطن من هذا الطراز، أن يتعايش مع كل من لا يرى رأيه، ولا يدين بمعتقده، ولا ينتمي إلى سلالته؟! وأنّى له أن يكون متسامحاً مع الغير، وأن يعترف بفضل الآخر؟
لا أمل هنا، هنا الأسى والحزن فقط، لا شيء يبعث على الرضا، الإنسان متنطع لا يرعوي. مباهج الحياة تغري، النزوات تضغط بلا هوادة، وسائل المقاومة والردع إزاءها غير ناجعة. فما العمل؟
ويشير مزوز إلى إن كان لفلسفة الدين من فضل علينا، فلعله ذاك الذي يتأتى من كشف النقاب عن أوهامنا المتجذرة، وعلى رأسها وهم الهوية، ووهم الأصالة، ووهم أفضلية المعتقد. تُظهر لنا فلسفة الدين أن ما نحسبه خصوصية تجعلنا بلا نظير ولا مثيل، هو في الواقع كونية ومشترك إنساني.
الحكمة الدينية الموجودة في كتابنا، يوجد لها مثيل لدى أنبياء العهد القديم، وما قاله هؤلاء يوجد له نظير عند حكماء بابل ومصر. ليس لدينا ما نباهي به غيرنا في مجال المعتقد، كما ليس لدى الغير ما قد يجعله متفوقاً علينا. نحن سواسية في المعتقد، ما دمنا ننهل جميعاً من تراث بشري موغل في القدم. لذا، فإن الحروب التي خيضت وتُخاض باسم الدين لا مبرر لها، مادام الإله الواحد إرثاً مشتركاً لا يحق لأي طرف أن يدعي الانتصار له أو الدفاع عنه أو إعلاء كلمته. فهو مستغنٍ عن الجميع، وفي غير ما حاجة إلى من يحميه أو يكون وصياً عليه.
أما ما وراء السدّ - بتعبير الأستاذ العروي - فلا نعلم ما إذا كان المؤمنون هناك، يخوضون حروبهم باسم معتقداتهم أم لا. وفي حالة ما إذا كان لديهم مشترك عقائدي يجمعهم - على غرار المشترك التوحيدي - ومع ذلك يخوضون الحروب باسمه، فمعنى ذلك أن تجارب الأمم متشابهة. في زمن الغلوّ نحن في أشد الحاجة إلى تغيير البرامج والمناهج، كي تكون مطابقة لفلسفة في التربية تروم تكوين مواطن الغد، مواطن يمارس اعتقاده الخاص دون أن يفكر في فرضه على الغير. ولن يتأتى لنا صياغة فلسفة للتربية تنشد هذا المبتغى، دون الاسترشاد بما توصلت إليه فلسفة الدين. لأن الديانات هي أنساق مغلقة على ذاتها، وليس بوسعها أن تقف على أرضية محايدة للنظر إلى بعضها البعض. أما فلسفة الدين - بما هي فلسفة أولاً وبالذات - فبمقدورها توفير تلك الأرضية المحايدة، بحيث تبدو المعتقدات متساوية وغير متفاضلة.
ويقول "لكل أمة كتاب، لكل شعب ذِكر، لكل حقبة رسول أو تابع أو ولي أو مصلح أو داعية. الزيغ عن الطريق وارد في كل حين، إغواء التشبيه والتجسيد وعبادة الشخصية لا يُردّ بيسر. إذاً لا مندوحة من التذكير والذكرى، لا مناص من الوعظ والإرشاد، لا بد من دور للعبادة قصد الابتهال والتوسل؛ طلباً للنجاة، وهروباً من الإغواء. بيد أن أخذ الحذر والاحتياط ليس فعلاً محايداً تجاه أفكار وانفعالات وحسب، بل هو اتخاذ لمسافة فاصلة بين الأنا والغير، بين الأصيل والدخيل، بين العريق والطارئ. فالإغراء والزيغ والتشبيه والضلال والبدعة والزيف، لها أسماء وعناوين وأشخاص، يمثلونها ويرمزون إليها. ولذلك يلزم استبعادهم ودحرهم وحرمهم، لأنهم يشكلون مصدر الخطورة على صفاء العقيدة، ويهددون بالعودة إلى الماضي المظلم، أي الماضي الذي تبرأ منه الكتاب. فهل نَصبُ العداء للخصوم ناتج عن الاختلاف في الإيمان فقط، أم أن للقضية وجهاً آخر؟ فما يُضير المؤمن أن يوجد مؤمن آخر يدين بغير معتقده؟ أيّ ضرر يلحق بالمعتقدات إن هي تباينت وتعارضت؟ وهل تَسلم المعتقدات من الشنآن إن هي تآخت وتآلفت؟ ألم تُنتج العقيدة الواحدة فِرقاً وطوائف "يكفر بعضها بعضاً، ويلعن بعضها بعضا"، والتعبير لابن عربي أيضاً؟".
ويضيف د. مزوز "المؤمن شخص حزين بالتعريف حتى لو أظهر العكس، ولو في حالة عدم خوض الحروب مع الخصوم. فلباسه المأتمي إبّان أداء الشعائر، دليل على أسفه إزاء مُلك ضاع أو هو في طور الضياع، فالدنيا القصيرة الأمد تنصرف أمام ناظريه إلى غير رجعة. لسان حاله يقول: ما الذي يستحق أن نعيشه بمَرحٍ بعد انفصال مملكة السماء عن مملكة الأرض؟ كيف يمكن استعادة الرتق بعد الفتق الكبير؟ إن كان هذا غير ممكن في هذه الدار، فهو في الدار الأخرى يدخل في حكم المباح بل هو الفوز المستحق.

لا أمل هنا، هنا الأسى والحزن فقط، لا شيء يبعث على الرضا، الإنسان متنطع لا يرعوي. مباهج الحياة تغري، النزوات تضغط بلا هوادة، وسائل المقاومة والردع إزاءها غير ناجعة. فما العمل؟ لن يبقى سوى الدعاء والابتهال، طلب الهداية والغفران. الرجاء والتمني هما الغاية، لا بديل عن الانتظار بما سيجود به إله العقيدة. سيكولوجية الانتظار هي دعامة المؤمن، استناداً إليها يقاوم المحن، وبالعودة إليها في كل وقت وحين يجد العزاء لإخفاقاته وإحباطاته. أمام ضياع مملكة السماء التي كانت فوق الأرض، لم يبق سوى الاستعادة الرمزية لها بالحج إلى البقاع المقدسة، والبكاء على أطلالها، وتقبيل ما تبقى من مآثرها. وهل هناك حل آخر غير هذا؟ انتهى زمن الحاكم المؤله، مضى زمن الحفلات المقدسة، أُغلقت أبواب المرح والانتشاء وإشباع الغرائز حتى التمام. كل ذلك دخل في باب الممنوع والمحرم، وحدث الشرخ الأبدي بين عالم الغريزة وعالم الفضيلة. في هذه النقطة تتشابه العقائد إلى حد التماهي، فما الداعي - بعد هذا - إلى التنابذ والصراع، والاتهامات المتبادلة بالزيف والتحريف؟".
ويرى أنه من غير المفهوم أن يحدث ذلك، على الأقل بالنسبة لديانات التوحيد "الأخوات الرضيعات من ثدي التجربة الإبراهيمية". ومن هذا المنظور، يحق لنا أن نتساءل أو نطرح السؤال على مؤرخ الأفكار: ماذا كان سيحصل لو انتصرت الأريوسية، مثلاً، في النسخة الثانية من التجربة الإبراهيمية؟ إذ في هذه الحالة سوف تتناغم النسخ الثلاث، وتتقلص الهوة بينها إلى حدود التطابق الوشيك. وتزداد وجاهة السؤال وحدّته بخصوص النسخة الثالثة من تلك التجربة: ألم تستمد العقيدة الإسلامية مشروعيتها من خلال الدعوة إلى تجديد التجربة الأولى، وذلك بالوقوف في وجه الانحراف نحو التشبيه الذي وقع في النسخة الثانية بعد فشل محاولة أريوس؟
لو تطابقت النسخ الثلاث أو كادت، ما كنا سنميز بين الرسالات والدعوات بوضوح تام، وما كنا لنقف على مظاهر التنابذ والتباين الحاد بينها. ولأن العكس هو الذي حصل، فقد سار تاريخ التوحيد على أسنان المنشار: التنزيه تلاه التشبيه ثم العودة إلى التنزيه. وذاك هو مضمون ملاحظة ماكس فيبر - كما مر - التي ذهب فيها إلى القول: إن الديانتين التوحيديتين الحقيقيتين هما اليهودية والإسلام. ولكن ماذا كان سيحدث لو انتصرت دعوة أريوس على دعوة التثليث، وهي عينها الدعوة الإسلامية بشهادة القرطبي؟ في هذه الحالة ستجد الإنسانية - التي يحدّها السدّ (بلغة العروي) - نفسها أمام ثلاثة كتب تكرر الوصية/الوصايا نفسها، وإن بلغات مختلفة ولكن بلوينات متقاربة. ما الدعوى آنذاك؟ وما الغاية؟ سوف نكون آنذاك أمام رواية وحيدة تعيد القصة نفسها برموزها وأسمائها المستعارة، بإدخال الطابع المحلي للثقافات الوطنية (الطابع الثقافي اليوناني بالنسبة للنسخة الثانية، والطابع الثقافي العربي بالنسبة للنسخة الثالثة). ما مضمون القصة؟ وما المغزى؟
ويخلص د. مزوز "إنها الوصية الكبرى المحمّلة بالحكمة الإنسانية، كما اختزلها التراث الشفوي الذي ظهر على ضفاف الأنهار (وادي النيل، وادي الرافدين). وهي الوصية التي انتقلت من الطابع الشفوي إلى الطابع المكتوب بالآرامية أولاً، ثم العبرية ثانياً، بعدها جاءت الترجمات إلى اليونانية ثم اللاتينية فالعربية.
حافظت الأجيال على وصية الأجداد، جددوا القراءات والتفسيرات والتأويلات، فكان لا بد من ظهور الاختلافات والتباينات، فتشكلت الفِرق والطوائف: ظهر أرباب المِلل وأصحاب النِّحل. دخلت السلطة على الخط، فتحولت الملل والنحل إلى إيديولوجيا للمعركة، فسالت الدماء في ساحات الوغى وما تزال.
فهل تبخرت الحكمة الإنسانية في السياسة؟ هل تنكّر الخلف لوصية السلف؟ أم أن أحفاد الفراعنة هم الذين استفاقوا من سبات الزمن، وخرجوا من لفائف الصحف الأولى، لإعادة ترميم معابد الوادي المقدس؟ أمَا آن للأحفاد أن يعيدوا قراءة تاريخ الأجداد، لإعادة السيوف إلى أغمادها، ويعلّموا أبناءهم أن إلههم واحد، ولا يجوز أن يتقاتلوا من أجله؟".