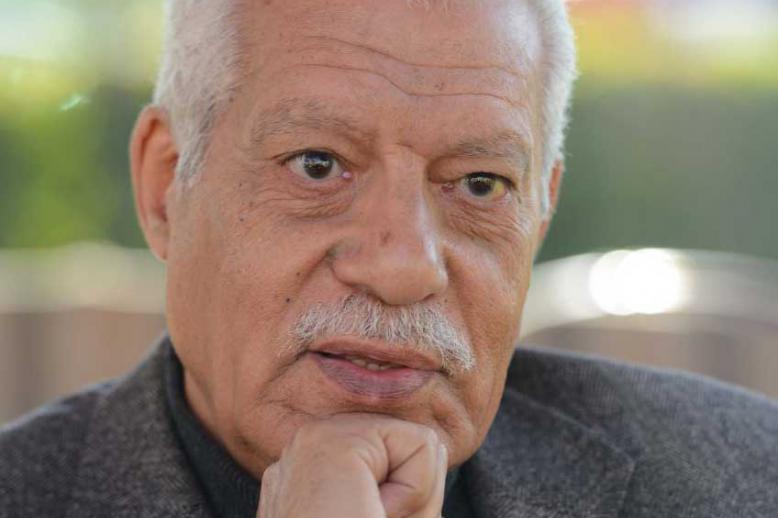ميادة كيالي: المرأة دفعت الثمن الأغلى عبر التاريخ ولا تزال

تواصل الباحثة السورية د. ميادة كيالي بحثها عن وضع المرأة والعائلة والزواج في حضارات العراق ومصر، حيث أصدرت العام الماضي كتابها "المرأة والآلهة المؤنثة في حضارة وادي الرافدين"، ووقعت أخيرا ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب كتابها الجديد "هندسة الهيمنة على النساء.. الزواج في حضارات العراق ومصر" الصادر عن دار مؤسسة مؤمنون بلا حدود، والذي سعت فيه إلى تسليط الضوء على أصل العائلة، وعلى تنازعها الأهمية مع مفهوم الزواج، وعلاقة الزواج المتأثرة والخاضعة لتغييرات الاقتصاد وتشكيلة المجتمع ونوع الحكم الناظم له، في محاولة لاستقراء شكل الزواج القادم في المجتمعات المعاصرة، في ظل الثورة المعلوماتية الرقمية، ومقدرة الزواج في البقاء كحامٍ لحمى العلاقات الجنسية، باعتباره يمثل، على الأقل للكثير من المجتمعات، السبيلَ الوحيد للممارسة الجنسية والحصول على المتعة وعلى الإنجاب.
وقالت كيالي إنه في لغة السومريين، كانت كلمة "الحب" فعلاً مركباً، يعني حرفياً "قياس الأرض"، أي "وضع علامة على الأرض". فلم يأت أبداً مرادفاً للزواج ومعرّفاً له، فالسومريون والبابليون وحتى الآشوريون كان الزواج بالنسبة لهم ترتيب عمل يهدف إلى ضمان وإدامة مجتمع منظم.
وعلى الرغم من وجود عنصر عاطفي لا مفر منه في مؤسسة الزواج، فإنَّ نواياها الأساسية في نظر الدولة لم تكن الرفقة ولكن الإنجاب؛ وليس السعادة الشخصية في الوقت الحاضر، ولكن الاستمرارية المجتمعية للمستقبل.
وأكدت أن العائلة الأبوية التي تشكلت وترسخت منذ شريعة حمورابي، رسمت صورة الدولة والمجتمع القديم، وكانت الخلية الأولى التي انبثقت منها الدولة، واستمرت في سيرورتها مدعومة بالممارسات والأيديولوجيات لأكثر من ثلاثة آلاف عام، ولا تزال تهيمن حتى يومنا هذا. لقد حولت الدولة، التي تأسست على الأسرة الأبوية، السيطرة على المرأة من يد الأب إلى يد الملك، وشكل قانون الحجاب الأشوري رقم (40)، المفصل الحقيقي في تاريخ خضوع المرأة، حيث صنفت بناءً على جنسانيتها، وحددت أدوارها، وأقصيت عن دوائر الحكم والسياسة والقرار.
ورأت أن بحثها تبنى فكرة حدوث انقلاب ذكوري على المجتمع الأمومي على أعتاب العصر الكالكوليتي، ظهرت أول ملامحه لاحقاً مع أول مصلح في التاريخ في الألفية الثالثة قبل الميلاد، بفرض الزواج الأحادي على النساء، فكانت بداية إخضاع المرأة، من اللحظة التي اختلت فيها الموازين لصالح الرجل، حين أراد أن ينقل النسب لصالحه فحاصر جنسانيتها، وشكل المجتمع على مقاس رغباته، وتحت سلطته، الأب أخضع العائلة وعلى شاكلته تأسست دولة أبوية، هذا الانقلاب بدا واضحاً في حضارات الرافدين، بينما بقي التأثير الأمومي، الذي خلفته الإلهة إيزيس في ميثولوجيا الحضارة المصرية، حامياً لتوازن أكبر في العلاقة بين الرجل والمرأة ومخففاً من عنف وقسوة الذكورية التي سطعت ملامحها في الرافدين.
وأشارت كيالي إلى أن الرجل المحارب عرف كيف يخضع المرأة، مؤسساً نظامه الأبوي على رفات مجتمعها الأمومي، ليتمتع بالنسب والثروة، وتصبح المرأة مهمشة وتابعة له، وقاد إخضاعها إلى تعبيد الطريق لاستعبادها، فدفعت الثمن الأغلى عبر التاريخ من حريتها ولا تزال.
لقد قادت الفتوحات العسكرية في الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى استرقاق النساء الأسيرات واستغلالهن جنسياً، مما أدى إلى نشوء الدعارة التجارية، لتصبح مصدر دخل للعائلات الفقيرة، وظهر التمايز الطبقي، ورسمت مراتب النساء حسب خدماتهن الجنسية. ومنحت الحقوق حسب الطبقة، وبالتالي تحولت المرأة إلى ظل تابع للأب أو الزوج، وتمت السيطرة على جنسانيتها بالكامل.
وكشفت كيالي أنه بدراسة مقارنة لما حصل في حضارة مصر القديمة مع ما حصل في حضارات الرافدين، يتضح أنَّ الأمور لم تكن كذلك، بل إنَّ الحضارة المصرية منحت حقوقاً للمرأة قد لا نجد لها في زماننا المعاصر أي صدى كمثل حقها في أن تتزوج لكي تنجب ومن ثم تتخلى عن الزوج، وجعل الاتفاق المالي أساساً في اتفاق الزواج بما يشبه ما يحصل اليوم في الزواج المدني، بحيث يكون لها حصة في الأثاث وحصة في المنزل، وبالتالي الطلاق التعسفي من دون سبب سيتوجب عليه تبعات مالية، وكذلك كان التعدد في الزواج خاضعاً لموافقتها، وإلا ستطالب بحقوقها وتنفصل عن الزوج.
وقالت إن الزواج في حضارة مصر القديمة عزز مركز المرأة وحضورها في العائلة، رغم كونها عائلة أبوية تتبع للأب، ومكانة الإلهة في الميثالوجيا المصرية، وجملة المعتقدات الدينية هذه مكنت المرأة من تسلم مقاليد الحكم، وتمكنت من اعتلاء العرش لفترات عديدة، وكل ذلك انعكس على الأمر الواقع وأثر على قوانين الاجتماع، ولعل هذا الأمر هو ما جعل البحث، يؤكد في توصياته بأنَّ حقوق المرأة لن تتحصّل إلا من خلال استقلالية مالية، تضعها في مراكز السلطة وصنع القرار. واليوم، ما برح شبح الماضي البعيد يزور أرض الحاضر، مهدداً المرأة بالموت والعزل والاحتقار إن هي مضت خلف رغباتها، وغامرت من أجل متعتها، بينما الرجل لا يزال صاحب الحظ الأوفر من القانون ومن التشريع الديني، ولا يزال المتحكم بمصير العائلة ومصير الدول.
وأوضحت كيالي إنّ التعرض لموضوعة الزواج اليوم، لا بد أن يمس حائط المقدس، ولا بد أن يقف عند الحلال والحرام، ويصمت أمام وطأة الفقه، والناطقين باسم السماء، لكن إلى متى يبقى الخلل في توزيع الحريات، وفي اختلال ميزان العدل، والتقليل من احترام المرأة ورغباتها وفردانيتها، واستقلاليتها، وربطها دائماً بالفتنة والخطيئة والدنس؟
ولفتت إلى إنّ ما حصل في العصر الفيكتوري يشبه ما حدث في الحضارات القديمة في الألفية الثالثة قبل الميلاد، فقد احتكر الزواج كامل المتعة الجنسية. لكن ما حدث في العالم القديم حدث على المرأة وحدها، مما أسس للطبقية وأسس للدعارة التجارية وتسليع الجنس.
إنَّ غائية الزواج وتشريعاته في القديم كانت من أجل ضمان النسب وانتقال الثروة وتأكيد للملكية الفردية، تتقاطع مع غائية العصر الفيكتوري في النهوض بالصناعة على أكتاف العمال، وحرمانهم من لحظات المتعة، وتحويل تفكير المجتمع كله لجعل طاقة العمل في أقصاها، بعد إخراج المتعة بعيداً عن يوميات الحياة، واعتبار الجنس وسيلة للحصول على الأبناء، وللمتزوجين فقط، وكليهما وجهان لعملة النظام الأبوي، الذي قيّد جنسانية المرأة، وخلق ثقافة تعزز من ضعفها واتكاليتها، ومن عدم ثقتها بنفسها، بحيث نجد أنّ دورها الأمومي، حتى هذه اللحظة، يتصدر كل الأدوار أهمية، وعليه وبسببه أصبحت مقدرة المرأة على الإنجاب مؤشراً ينعكس على كامل حياتها، وتعززت مفاهيم الغيرة والعاطفية والنقص العقلي، وألصقت بها وكأنها محايثة لها بالخلق، وبالتكوين.
أما مسألة العرض والشرف فكانت ولا تزال حاضرة في أدبيات حياتنا بوصفها من ميزات الرجال، وانعكاساً لأفعال النساء، فالمرأة التي تقيم علاقة غير شرعية تسيء لشرف رجل في القبيلة، سواء كان الأب أو الأخ أو الابن، أو أي رجل تربطها به أية صلة قرابة، تمتد حتى الأحفاد والأصهار، وغيرهم.
وأشارت كيالي إلى أن ذلك الكبت الفكتوري تبعته ثورة قلبت كل المفاهيم، وأضرمت النار في قدسية الزواج، وقدسية أسطورة المرأة والرجل المخلوقين من بعضهما البعض، وبأنّ ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، وفتحت الباب لكل أشكال المتع، فلم يعد الزواج هو الاتحاد ما بين رجل وامرأة كاتحاد المسيح بالكنيسة، وأصبح مفتوحاً للمثليين، في وقت أصبح تبني الأطفال ممكناً لتكتمل العائلة، ولم يعد هناك موجب لكتابة عقد زواج، طالما أنّ الزوجين يعيشان معاً بملء إرادتهما، والدولة تسهر بقوانينها على حماية الأطفال في حال أثمرت العلاقة أطفالاً.
لقد تحوّل الزواج في المجتمعات الحديثة إلى عقد حياة مشتركة، لذلك عند إرادة الانفصال يتم ذلك بإعادة الحقوق لأصحابها، وكل ما كسبته العائلة في هذا العيش المشترك هو من نصيب الزوجين معاً، وكل ما خسرته أيضاً يتحمله الزوجان، فإن اضطرت المرأة لترك عملها والتفرغ للبيت والأولاد حين طلاقها ستطالب بكل ما خسرته من جراء ذلك، وستطالب بكل ما جناه الرجل من عمله الناجح وهي ترعى له بيته وأبناءه.
وأكدت إنّ الزواج، الذي هو شكل ثقافي ووليد صيرورة تاريخية وتطور تاريخي طويل، يتجاوز العلاقة الطبيعية ويتبارك بمباركة البطريرك "الإله المنتصر على الإلهة الأنثى". إنه الابن البار للنظام الأبوي، ترعرع في ظله، وانبنت مفاهيمه في رعايته، وفيه أخضعت المرأة وتحول خضوعها مع الزمن إلى ثقافة، وسلوك، وتحولت إلى واقع يشي بدونية المرأة وضعفها، ويحدد لها وظيفتها داخل المنزل مقابل حماية ورعاية رجل لا بد وأن تتبع له سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً.
لقد قضت التغييرات الاقتصادية على شكل الزواج الثنائي، منذ أن أصبحت الثروات ملكية خاصة للعائلات وتراكمت بسرعة كبيرة، مسددة بذلك الضربة القاضية للمجتمع الأمومي، ليتحول إلى زواج أحادي كرس تبعية مطلقة. أما إسقاط الحق الأمومي فمثّل هزيمة سجلها التاريخ للجنس النسائي، انتزعت من المرأة دفة القيادة ليتسلّمها الرجل في البيت وفي المجتمع أيضاً، وأصبحت المرأة تابعة وفي أحيان كثيرة عبدة تحت تصرف الزوج، وآلة تفريخ لإنتاج الأبناء.
لا يُعد الزواج الأحادي في التاريخ، كما يسوق له، اتحاداً اختيارياً بين المرأة والرجل، أو الشكل الأرقى والأسمى لهذا الاتحاد، بقدر ما يعكس استعباد جنس من قبل جنس آخر، مما ولّد أول أشكال التناقض بين الجنسين، وتوزيع الأدوار وتقسيم الأعمال.
وقالت كيالي إن جنسانية المرأة خضعت وتأثرت بجملة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تأثرها بالمعتقدات الدينية، فكان التغيير الذي طال الديانات الأمومية، وتحول الألوهة من زعامة الإلهة الأم مع مجمع آلهة، إلى الإله الذكر وتفرده، إضافة إلى ظهور الملكية الفردية وظهور طبقة العبيد ما من شأنه أن يحكم سيطرة الرجل على جنسانية المرأة، ويؤسس للدعارة التجارية، ومن ثم يتم الفرز الطبقي على أساس خدمات المرأة الجنسية، فتكون الزوجة (التي تصون زوجها وتدعى بالحرة)، على قمة الهرم، وتحتها الابنة (سواء أكانت متزوجة أم عذراء فهي أيضاً حرة)، ثم الأمَة المملوكة، وفي الأسفل العاهرة التي تبيع جسدها، في حين كان التوزيع الطبقي للرجل بحسب مكانته السياسية والاقتصادية. ومما لا شك فيه بأنَّ التقييد، في مختلف القوانين والتشريعات التي سُنّت في حضارات الرافدين، يخدم مصالح نظام اجتماعي ذكوري، ويقود إلى أن تنزل المرأة في المرتبة الاجتماعية وتنعزل في البيت فتفتقر، بانحصارها في الإطار المنزلي، إلى حرية الوصول إلى أنواع السلطة أو المركز أو القيمة الثقافية التي هي من امتيازات الرجل.
وخلصت إلى إنَّ ظهور قوانين الزنا في حضارات الرافدين، كصيرورة حتمية تلت إصلاحات أوركاجينا، كانت الحامل الضامن والحارس على طهورية النسب، وإعلان واضح على خضوع المرأة للنظام الأبوي، إذ أصبح للرجل حق في المرأة، وليس العكس، واشترك الزوج والملك والإله في منظومة واحدة أحكمت الخناق على المرأة، وحولت مسيرة تطورها إلى رحلة شاقة خاضتها وما انفكّت. فحين تم التشريع في موضوعة الزنا، في قوانين حضارات الرافدين، كان المعنى يستهدف المرأة المتزوجة. وفي العصور اللاحقة، وتحديداً في الأديان التوحيدية، أصبح المفهوم يشمل المرأة العازبة، وإن بعقوبة أقل من المتزوجة التي لا يُغفر ذنب ارتكابها الزنا، لأنَّه يتوجّه بالأذى لمركز الكون: "الرجل"!
هذه القوانين، أي قوانين الزنا في حضارات الرافدين، بينت أنَّ عقد الزواج هو عقد توقع فيه المرأة صك العفة، والالتزام بالعلاقة الأحادية، فقط من جانبها، وإلا ستكون نهاية حياتها، والمرأة الأمَة لا ينطبق عليها ذلك فهي تباع وتشترى وتهدى، إلا إن أعلنها الرجل "زوجة" حين تنجب له أولاداً، حينها تصبح زوجة ثانية لها حق النفقة، وإن بمرتبة متدنية عن الأولى.
ورأت إنَّ تشريع الزواج الأحادي، وفرض عقوبة الزنا بحق المرأة، أسس لهيمنة أبوية، ربطت جنسانية المرأة بالرجل، وساهمت في إخضاع المرأة، وهذا الخضوع مهّد لظهور طبقة العبيد، وسبقها، فنشأة النظام الأبوي كانت على أكتاف السيطرة على المرأة، وتالياً السيطرة على طبقة، وتولي زمام الحكم وتوزيع الثروات، وجاءت الحروب لتكمل الصورة في تفشي الإتجار بالخدمات الجنسية للعبيد، فتمأسست الدعارة التجارية التي اكتملت معها صورة المجتمع الذكوري، الذي قام على إخضاع النساء وتسليع خدماتهن الجنسية.
ومع المادة رقم (40) من القوانين الآشورية انتقلت الهيمنة من الزوج إلى الملك، ليصبح إخضاع المرأة أمراً مفروغاً منه ويقع بالكامل تحت سلطة الملك، هذه السلطة لاحقاً ستظهر في اقترانها بسلطة السماء، فتكفّل اللاهوت بمعاقبة المرأة بالدرجة الأولى، بعد تكريسها صديقة الشيطان، وسبب الفتنة، والخطيئة الأولى.
ومن خلال القانون (40) من القوانين الآشورية، تم نقل الهيمنة الأبوية من الممارسة الخاصة إلى القانون العام. فقد كانت جنسانية المرأة، فيما مضى، بيد الزوج، أو رب الأسرة، لكن منذ العصر الآشوري أصبحت الجنسانية النسوية مسألة بيد الدولة تقننها حسب رغباتها، وسيكون هذا تحضيراً لما سيتبع من تطور في فكرة سلطة الدولة واطرادها، وتأسيس القانون العام.
وشددت كيالي على أنَّ قوانين الزواج في مصر القديمة في تلك العصور الغائرة في التاريخ، تكاد تكون أكثر تحضراً مما هي عليه الآن في العديد من المجتمعات، حتى إنَّها تعكس مكانة متميزة بشكل واضح للمرأة في ذلك التاريخ تعلو على بنات جيلها من حضارة وادي الرافدين، التي يظهر فيها الانقلاب الذكوري على المرأة بشكل واضح، ويظهر فيه المجتمع الأبوي كذلك أيضاً، بعد أن دحر بقساوة المجتمع الأمومي.
أما تشريعات حضارات الرافدين، فساهمت في إرساء حدود واضحة بين نساء الطبقات المختلفة. ومع أنَّ سيرورة تأسيس تلك الشرائع منحت المزيد من حقوق الملكية للنساء من الطبقات العليا، إلا أنَّها زادت في تقييد حقوقهن الجنسية، إلى أن انمحت واندثرت، وتأصلت معها اتكالية النساء على الآباء والأزواج، إلى أن تحولت مع القوانين والأعراف إلى اتكالية بالفطرة وبالطبيعة، وبأنَّ الله خلقهن هكذا.
لا مندوحة من الاعتراف بأنَّ الزواج لم يكن بالضرورة حافظاً للحب، كما لا يمكن للحب أن يحمي الزواج واستمراريته، طالما أنَّ فيه جهة تخضع لجهة. إنَّه لا يزال إلى اليوم يحمل مفهوم التبعية من أجل مقابل، إنَّه التبعية مقابل الحماية، أو للحصول على الشريك العاطفي، والكفيل الاقتصادي، أو الحصول على الأبناء.
وختمت كيالي أنه إذا كان لا بد من توصيات في بحث شائك كبحث الزواج، فلا بد من استحضار أمور من الصعب إغفالها، منها الدين، وحالة الاجتماع، ودرجة الوعي. وقد يكون من أهم التوصيات، التحذير من أنَّ الاستمرار في عدم إدامة الزواج، ومواصلة النهج السابق نفسه دون أية محاولة للتطوير، سيعظّم ويكاثر مَن يكفرن به ويتمردن عليه.