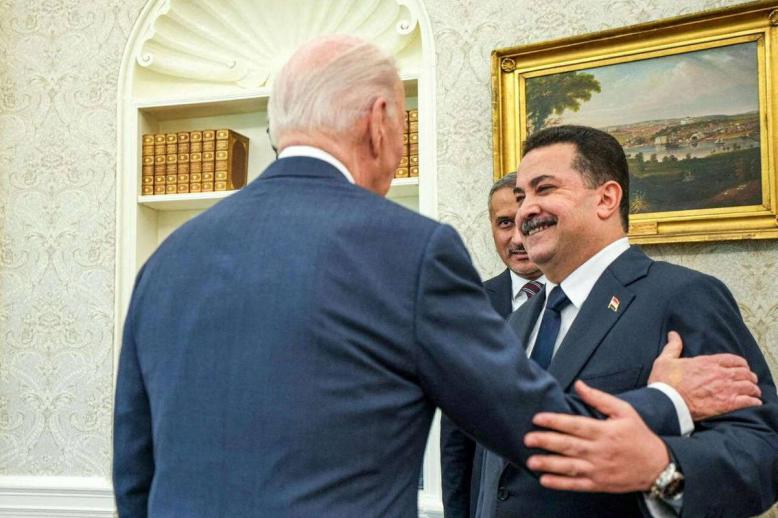من يمثل الناس؟
قبل أن يسيطر القادة السياسيون عموما على الناس، فليسيطروا على أنفسهم أولا ويلجموا نزواتهم وجموح طموحاتهم لتتألف الحكومة. إن شهوة السيطرة هي تعبير عن فقدان سيطرة الشخص على أهوائه. وإذا كان أحد أهداف وضع القوانين هو إبقاء تصرف المواطن في إطار النظام العام، فأحد أهداف وضع الدساتير هو إبقاء الحاكم ضمن حدود الدولة، فلا يستأثر بالسلطة وبالشعب. وأصلا هذا هو الفارق بين المجتمع الحضاري والمجتمع الهمجي، وبين النظام الديمقراطي والنظام الديكتاتوري. وحسب علمي، نشأت دولة لبنان لتكون مجتمعا حضاريا ونظاما ديمقراطيا.
في الأنظمة الديمقراطية، الانتخابات النيابية هي المعيار الأساسي للتمثيل الشعبي أكان القانون أكثريا أم نسبيا، وأكانت الدوائر محافظة أم قضاء، لكن صحة هذا التمثيل تبقى رهن نزاهة العملية الانتخابية ونسبة الاقتراع. والنزاهة لا تقتصر على عدم نقل أصوات مرشح إلى مرشح آخر، بل هي أداء متكامل يبدأ من وضع قانون الانتخابات، إلى شروط الترشيح والسقوف المالية والمساواة في الإعلان والإعلام، مرورا بملابسات تأليف اللوائح ودور السلطة الحاكمة أو القوى المتحكمة بالمناطق، وصولا إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج النهائية.
وأي انتخابات لا تخضع نتائجها لهذه المعايير الدستورية والقانونية والأخلاقية المعترف بها عالميا، مطعون فيها سياسيا وشعبيا سلفا، وإن لم يطعن أحد فيها دستوريا لألف سبب وسبب. واللافت أن دعاوى الطعن أمام المجلس الدستوري اليوم، تطال الحصاد وليس الزرع، أي النتائج وليس مسار الانتخابات المحفوف بالمخالفات القاتلة.
في لبنان، حيث الانتخابات خالفت القواعد العامة والعالمية المذكورة أعلاه، أصبح التمثيل النيابي، بالتالي وحكما، غير كاف ليدعي الفائزون حصرية تمثيل الناس، ولينكروا الصفة التمثيلية على أفرقاء آخرين ومراكز قرار أخرى.
ولقد كشفت الانتخابات أن سبعة نواب جنوبيين وثلاثة شماليين فقط، نالوا في الصوت التفضيلي بين 36% و86% من مجموع الناخبين في دوائرهم، فيما حصل الفائزون الآخرون على نسب تراوحت بين 0.4% و19%، وهي حصيلة ضئيلة جدا كالفوز بفضل "ركلة جزاء". وإذا كان من الطبيعي أن يفوز هؤلاء على أخصامهم، فمن غير الطبيعي أن يدعوا تمثيل ألـ 100% من الناس. إن النواب يمثلون ناخبيهم لا المواطنين، وإذا كان كل ناخب مواطنا فليس كل مواطن ناخبا.
حتى في الدول الديمقراطية فعلا، حيث الانتخابات نزيهة كالبلور، تعاني الشعوب من محدودية الصفة التمثيلية السياسية الناتجة عن الاستحقاقات الانتخابية التقليدية. وما المفاجآت الانتخابية التي تشهدها دول عريقة بديمقراطيتها سوى تعبير عن البحث الصادم أحيانا عن تمثيل آخر. يكفي أن نسترجع نجاح تسيبراس في اليونان، وترامب في أميركا، وماكرون في فرنسا، وكورتس في النمسا، وخيار "البريكست" في إنكلترا، إلخ... لنتأكد من حالة التمرد على المألوف والتقليدي والمكرر والجمود الحزبي والمؤسساتي. إنها رسائل الشعوب إلى ما يسمى بالـ"استبلشمنت - مؤسسة الحكم".
بانتظار ابتكار نظام بديل أو آلية تصحح رتابة التمثيل الانتخابي ومحدوديته، تبتدع تلك الدول هيئات تمثيلية موازية ورديفة وإضافية لتضمن شمولية التمثيل الشعبي. مع العولمة واللوبي والاختصاص ودور المؤسسات الصناعية والمصرفية والمعلوماتية الكبرى وبعد سقوط الأنظمة الشيوعية، باتت الديمقراطية إطارا يضمن الحريات أكثر من نظام يضمن حسن التمثيل السياسي والقطاعي.
ما عدا الحماسة لانتخابات تتمحور حول خيارات مصيرية كدخول فرنسا إلى "اتفاق ماستريخت"، وانفصال اسكتلندا عن بريطانيا، وحصول الجبل الأسود على الاستقلال الذاتي، وانسحاب الجيش السوري من لبنان، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تحول الاقتراع في الأنظمة الديمقراطية ممارسة تقنية متثائبة بعدما كان، في ما مضى، خيارا وطنيا تحديدا. والدليل ظاهرتان: الأولى، ما إن تنتهي الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، حتى يبدأ الناخبون بالتأفف والمعارضة والتظاهر، كأن خياراتهم لم تكن لا سياسية ولا ثابتة؛ والأخرى، تدني نسبة الاقتراع في العالم مقابل ارتفاعها في هيئات التمثيل المدني والنقابي.
لم يعد التمثيل السياسي وحده يلبي أحلام الناس وطموحاتهم. صارت الأجيال ترى نفسها في غير الزعماء والنواب والوزراء والرؤساء. صارت ترى نفسها في من يدير العالم لا في من يحكمه. صارت ترى نفسها في مؤسسي غوغل وفيسبوك وأبل وآيفون، في الكتاب والصحافيين، في المصرفيين ورجال الأعمال، في النقابيين والناشطين اجتماعيا، في الفنانين والرياضيين، في الباحثين والمبدعين، في صانعي الخير والبر، في حائزي جوائز نوبل وپوليتزر وﻏونكور، في منقذي الأطفال من الغرق والحرائق والأعاصير. هؤلاء يقدمون إلى البشرية السلام الداخلي، فيما السياسيون يقدمون القلق. هؤلاء ينقلوننا من نور إلى نور، فيما يبقينا أصحاب الصفة التمثيلية في لبنان بين مكبي "برج حمود" والـ"كوستابرافا".
وإذا كان نفوذ السياسيين في لبنان كما في العالم المتخلف لا يزال قويا، فليس بفضل صفتهم التمثيلية، بل لأن الشعب المقيم يعيش خارج هذه التطورات العالمية العظيمة، ولأن الدولة لم توفر للمبدعين اللبنانيين فرص الإبداع والشهرة. هكذا، وقعنا كشعب اضطرارا في الولاء للمبدعين الأجانب، بموازاة ولاء السياسيين خيارا للخارج.
ورغم ذلك، يأتي من يريد أن يقرر في الظلام تمثيل شعب يصمد في النور منذ ألفي سنة، وفي التاريخ منذ ستة آلاف سنة، وفي هذه الجبال منذ ألف وستمائة سنة! لا الرسل ولا الأنبياء ولا الكنيسة، ولا حتى يسوع المسيح احتكروا تمثيل المسيحيين ("فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا" إنجيل يوحنا)، و ("كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء" مار بولس إلى الكورنثيين).