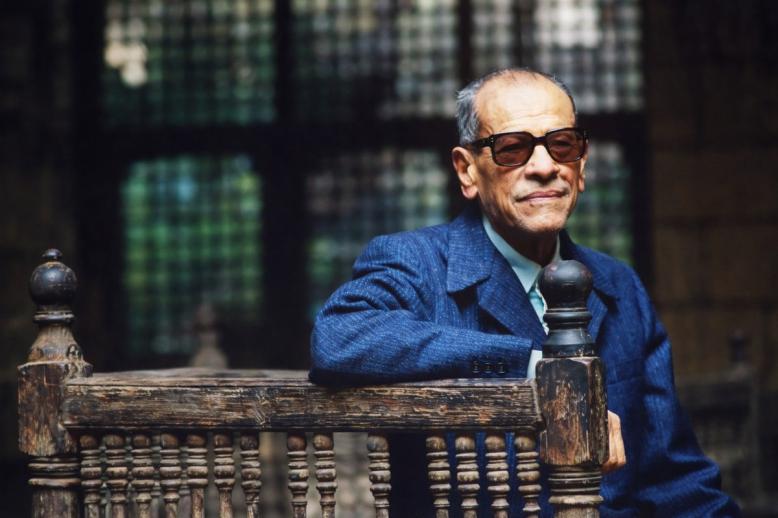اعتراف مفتوح لصحفي الغجر باتريك بانغا في 'طريق الخروج'
يقدم الكاتب الصحفي والقاص التشيكي باتريك بانغا بعد مجموعتين من القصص القصيرة، كتابه "طريق الخروج" الذي يحمل حكايته الواقعية حيث يسرد قصة حياته، كيف أنه وصل إلى منصب صحفي مرموق في وسائل الإعلام التشيكية البارزة قادما من حي يسكنه الغجر؟ وقبل ذلك كيف كان الإفلات من القوالب النمطية، والغبن، والتجارب الدرامية التي تعرض لها المجتمع الغجري في حي شيشكوف بمدينة براغ في تسعينات القرن الماضي؟.
يقول بانغا في كتابه الذي ترجمه د.خالد البلتاجي وصدر عن دار الترجمان "بدأت بتأليف الكتاب عام 1999 بعد عودتي من يوغوسالفيا بأيام قليلة، كانت فكرة يوزيف دودو مورين الذي أصر على ضرورة أن نطلع الرأي العام على الصعوبات التي واجهها شاب غجري صغير، وسنوات النضج المليئة بالعنف والعنصرية والرفض، وكما هي العادة مع النصوص ظلت الفصول الأولي من الكتاب قابعة في الدرج لخمسة عشر عاما قبل أن يظهر دودو مورين في حياتي مجددا، وظل يذكرين، ويدفعني إىل التفكري يف كتابة النص، خاصة بعد أن نجح في العثور على الصور التي التقطتها في بودجوريتسا، مات دودو قبل أن يرى النص، لذلك اسمحوا لي أن أتذكره بهذه الطريقة على الأقل، وأشكره على أنه شاركني جزءا من حكايتي، أود كذلك توجيه الشكر إلى لينكا، وأديلا، بدونهما لما حدث أي مما ذكرت، كذلك أشكر تريزا يانكوا التي قضيت معها ساعات كثيرة لتصحيح هذا النص".
ويعلن بانغا "أود هنا أيضا أن أتذكر كل أصدقائي الذين راحوا ضحايا تنمر رجال الشرطة، وخاصة تنمرهم على الغجر في التسعينات، المأساة هي أنني حين عملت موظفا في إدارة شئون اللاجئين بوزارة الداخلية التقيت بنفس رجال الشرطة الذين فعلوا بي ما تحدثت عنه في هذا العمل، وما زالوا حتى اليوم يواصلون عملهم في الشرطة، كل ما أتمناه هو ألا يتكرر يوما أي ممام حكيت عنه".
يبدأ الكتاب الذي تكتمل فيه كافة تقنيات السرد الروائي أسلوبيا وفنيا، في تسعينات القرن الماضي في حي شيشكوف بمدينة براغ، ولم يكن حيا منفتحا كما هو الحال اليوم، بل مكانًا كئيبًا، مفعمًا برائحة المخدرات، والخمور، والدعارة، والشجارات. أن تولد في مجتمع غجري مثله لا يعني سوى أمر واحد ـ أن تُصنّف ضمن غيرك من المنحرفين اجتماعيًّا.
يصف بانغا بطريقة مباشرة وقاسية واقع واقع حياته كصبي غجري يقابل في سنواته الأولى بالرفض، والجريمة، والعنصرية، والعنف من قبل الشرطة. يبحث عن طريق حقيقي للخروج. مرات عديدة يعثر عليه، مرات عديدة يضيع منه. الكاتب على قناعة بأن كل إنسان هو حالة فريدة. يصف في روايته التي تعد من روايات السير الذاتية نجاحاته وإخفاقاته، الصراع الداخلي مع الثقافة الغجرية، ومحاولات الخروج من تصنيف "الغجري".
يتأقلم الراوي/ الشاب بانجا مع الواقع المحيط ويخترق تدريجيا الروابط الاجتماعية المعقدة. وعلى الرغم من أنه يصف التجارب المشتركة المرتبطة بالنمو، إلا أنه يتعين عليه أيضا مواجهة التعبيرات العنصرية المستمرة على جميع المستويات الاجتماعية والتعامل مع نوع من التكامل الذي تطلبه السلطات.
إن قصة الخروج التي تتكشف في أحداث وسرد بانغا قصة من الذل والفقر اليومي، وهي لا تفتقر إلى التلوين العاطفي. على الرغم من أن بانجا يصف تجاربه دون استعارات غير ضرورية، إلا أن أسلوبه كبطل من أفلام الحركة واضح للعيان، كما لو كان يقف بمفرده ضد جمهورية التشيك بأكملها وأحكام سكانها المسبقة. هناك قدر معين من الرثاء. في بعض الأحيان، لا يدخر الراوي توجيه انتقادات للغجر. لكن السؤال الأهم الذي يتجلي بوضوح في النص ويبقى دون إجابة: ما الأسباب وراء الكراهية بين مجموعتين عرقيتين تعيشان في نفس المنطقة منذ بداية القرن الخامس عشر؟.
يقول بانغا " الحقيقة هي أنني لم أعرف المقصود بكلمة اندماج، لكنني سمعتهم يقولون في كل مكان من حولي إنه يجب أن أندمج، فتخيلت أن كل ما سأفعله مع البيض هو اندماج، لم أتوقع بالطبع أنها ستكون ألف باء كل المنظمات الأهلية التي سوف تهتم لاحقا بقضايا الغجر، ولم أتوقع أبدا أنه في عام ألفين واثنين وعشرين ستظهر استراتيجية حول اندماج الغجر خلال السنوات العشر التالية، لكن معنى الاندماج في ذلك الوقت اقتصر عىل المضايقات الكثيرة، وطمس الهوية، وتقبل عادات البيض التي لم نفهمها تماما. لكن لا بأس، كان على الاندماج، فاندمجت، انضم إلى مصطلحات الغجر، وغجر الأولاش، وإلى البيض، مصطلح آخر، وهو البيض المؤمنون بالله".
ويلفت إلى أنه "لا يمكنني القول إن جميع غير الغجر متشابهون، ليس كل شرطي أبيض أراد أن يضربني بأي وسيلة من باب التسلية، من ناحية أخرى حين عملت لاحقا مع رجل شرطة كان يخدم في حي شيشكوف في ذلك الوقت أخبرني صراحة بأنها كانت الوسيلة الوحيدة لقتل الوقت، وتكريس الخوف في نفوس الغجر، ورغم اعتذاره ظل هذا الشعور بالظلم منطبعا في نفسي، ولم يمحه أحد أبدا، لكنني التقيت في حياتي بكثير من غير الغجر الذي تركوا أثرا إيجابيا في حياتي، كانت مديرة مدرسة فلكوفكا واحدة من هؤلاء ـ السيدة مرداشيتشوفا، كانت أول من أخبرتهم بما فعله رجال الشرطة معنا، وكانت أول من أقنع أمي بتقديم شكوى، وسعت إلى معالجة الأمر بالطرق الرسمية، لكن أمي كانت تخاف من رجال الرشطة أكثر مني، كانت لا تزال تتذكر أيام الاشتراكية حيث كانت الشرطة أسوأ مما عليه اليوم. الشخصية الأخرى التي تركت أثرا طيبا في نفسي كانت السيدة زازولكوفا المحامية، كانت أمي عاملة نظافة في مكتبها في ميدان تيلوفا، بسببها شعرت لأول مرة في حياتي بأني قادر على تعلم شيء، كنا نرافق أمي وهي ذاهبة إلى المكتب لمساعدتها في تنظيفه، كثيرا ما كنت أقرأ في كتب القضايا الجنائية وأساليب الدفاع كلما سنحت الفرصة، كانت السيدة زازولكوفا إنسانة ودودة للغاية، وسيدة متفهمة، في كل مرة يستعصي على شيء أسألها فيه فتجيبني".
ويضيف "اندرجت ضمن مصطلحاتي، "الجادشو"، والغجر، وغجر الأولاش، والمسيحيون مجموعتان إضافيتان: النازيون، الذين سموا أنفسهم في ذلك الوقت باسم حليقي الرؤوس (وكنا نطلق عليهم "الصلع" من باب الاختصار)، ورجال الشرطة الذين كان لنا تجارب سابقة معهم، غالبا ما تشابهت طبيعة هاتين المجموعتين، ظهر هذا جليا عندما يختار رجال الشرطة رجلا غجريا، ويلقون القبض عليه، ويوسعونه ضربا، كنا نعرف جميعا أن من الضروري تجنب الفاشيين، سواء كانوا بزي رسمي، أو جاكيت قتالي، أو رأس حليق، كنا على يقين من أنه لو حدث مكروه لأحد منا فسوف ينجو حليق الرأس من العقاب، وأن من سيحقق في الحادث حليقو رؤوس آخرون، لكن في زي رجال الشرطة، الغريب في الأمر أن حليقي الرؤوس الأصليين كانوا وطنيين متشددين، يعارضون العنصرية والمخدرات، وليس لهم علاقة بالسياسة، بينما كانوا في التشيك سكارى يرتدون معاطف خضراء، ولديهم أشرطة بيضاء على أحذيتهم الجلدية الثقيلة، يظهرون في الفعاليات السياسية التي ينظمها دكتور سلاديك، وكانت له آراء فاشية قد لا يختلف معها أدولف هتلر نفسه، بالتأكيد رأيتموهم بأنفسكم في كل حفل موسيقي لفرقة "أورليك"التي كان حليقو الرؤوس يعتبرونها بمثابة "كارل جوت" المتقاعدين، وفي مطعم "أوهولانو" الذي كان قلعة النازيين التشيك".
ويتابع "في هذه الفترة من حياتي كان عليّ توخي الحذر الشديد، وتجنب حليقي الرؤوس، كلام رأيت أحدا بزي أصاب بهلع شديد، وأهرب بأسرع ما يمكن، رجال الشرطة الذين أوسعوني ضربا في شارع لوباتشوفا طبعوا في ذاكرتي وإلى الأبد تجربة مازلت أتذكرها حتى اليوم، أتذكرها حتى عندما تستوقفني شرطة المرور لفحص أوراقي، انقسم الناس من حولي إلى موالين لحليقي الرؤوس، وكارهين لهم، ما زلت حتى اليوم لا أفهم هذا العدد الكبري من مناصريهم، وصل الأمر إلى قلب أصحابه عليّ زميل الدراسة الذي كنا نلعب كرة القدم معا، صديق يوم الجمعة، ونازي يوم الاثنين يصيح: "أرسلوا الأفواه السوداء إلى غرف الغاز!"..
ويوضح "كانت ميزة حليقي الرؤوس سهولة التعرف عليهم، أشرطة في الأحذية، ومعاطف منفوخة، وعصي بيسبول لا تخطئها الأعين، فضلا عن هذا أنهم بدأوا يجاهرون بالعنصرية، وفي أماكن لا يكن توقعها، سألني الطبيب الذي أتردد عليه منذ الطفولة أثناء فحص طبي عن أنواع المخدرات التي أتعاطاها، هكذا بكل بساطة، كنت في سن الرابعة عشر، والمخدرات الوحيدة التي رأيتها يوما كانت في أفلام الفيديو التي شاهدتها. بدأت الشرطة في ملاحقة كل غجري في المتاجر، وتفتيش شخصي بعد الشراء، وصار هذا من تفاصيل الحياة اليومية، لا يمكن أن تتخيلوا مدى العار الذي شعرت به كلما فتشوني في كل مرة ترسلني أمي لشراء حليب من السوبر ماركت. تواصلت الأمور على هذا النحو إلى درجة أننا اعتدنا عليها، واتخذناها مع الوقت مادة للسخرية، هل شعرتم يوما بمثل هذا الهدوء والحماية وأنتم ترون أحدا يتتبعكم في كل مرة تذهبون فيها للشراء؟ إنه أمر رائع!".