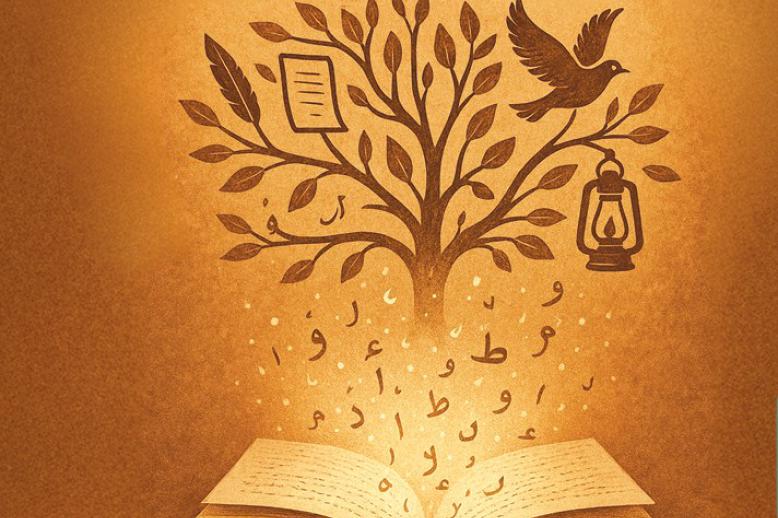عندما يصبح الموت فرصة للاستعراض في الأوساط السينمائية
يكشف واقع المشهد السينمائي والتلفزيوني والمسرحي في المغرب عن مفارقة أخلاقية حادّة بين صورة التضامن التي يروّج لها الخطاب الإعلامي وواقع العلاقات المهنية الهشّة داخل الوسط الفني، فبين المهرجانات واللقاءات الرسمية نرى الروابط متماسكة، لكنّها تتفكك عند أول اختبار إنساني كالمرض أو الشيخوخة أو العزلة، فتتكاثر المجاملات وتندر المبادرات الصادقة، ويحلّ الحضور الشكلي محل السؤال الحقيقي عن الذات في ذاتها.
لذلك يصبح الموت لحظة ضجيج، في حين يجب ان يكون لحظة وعي، فتنقلب الصفحات إلى دفاتر عزاء إلكترونية.
ومن هنا تبرز ظاهرة النفاق السينمائي بوصفها سلوكًا جماعيًا متكررًا في كل حدث وفاة.
وتجسّد هذه المهزلة في التحول المفاجئ الذي يطرأ على الخطاب العام عند وفاة أي فنان مغربي، إذ ينتقل المحيط المهني من صمت شبه كامل إلى ادعاء قرب حميم، حينما تُستخرج صور قديمة من أرشيف المناسبات لتبدو دليلًا على صداقة عميقة، وتُكتب عبارات رثاء متشابهة تكاد تكون قوالب جاهزة للاستخدام، فيتحوّل اسم الراحل إلى وسم متداول لساعات أو أيام ثم يُنسى من جديد.
وهذا السلوك يكشف أن الحزن يُؤدَّى بوصفه واجبًا اجتماعيًا ولا علاقة له ضمنيا كونه إحساسًا صادقًا، فيغدو العزاء فعلًا استعراضيًا عوض ان يكون لحظة وفاء، وهكذا تفقد المناسبة معناها الإنساني.
فما فائدة البكاء بعد الموت؟ سؤالًا يتصل بجوهر المسؤولية, لأن الرثاء المتأخر لا يعوّض لحظة وحدة عاشها المريض في سريره ولا ضائقة مرّ بها في صمت، وقد شهد الوسط الفني المغربي حالات لفنانين اشتكوا من الإهمال في حياتهم، ثم حصدوا بعد وفاتهم سيلًا من المراثي، وهذا التناقض يبرز خللًا في ترتيب القيم، حين يتقدّم الكلام على الفعل، بينما تقاس القيمة الأخلاقية لأي موقف بتوقيته الحاضر وليس بحجمه البلاغي المزيف، لذلك تبدو الدموع اللاحقة أقرب إلى تبرير الذات منها إلى مواساة الراحل. ويصبح الحزن تعويضًا نفسيًا افتراضية فقط.
فما فائدة إظهار الحزن وأنت طول حياتك لم تبالِ؟
إن بعض العلاقات داخل المجال الفني تُدار بمنطق المصلحة والظهور، لأن المشاعر تتحول إلى رأسمال رمزي يُستثمر لتحسين الصورة العامة، فيتجلى ذلك في البيانات الطويلة والتصريحات المؤثرة التي لا يسبقها أي فعل تضامني حقيقي، ويغدو التعاطف وسيلة للتموضع الإعلامي لا للمواساة. فيختلط الإنساني بالدعائي، والصدق بالتمثيل، فيتكرر الأداء نفسه الذي نراه على الشاشة لكن في الواقع بصورة أكثر من المشهد التمثيلي احترافية.
فما فائدة الاهتمام بعد الرحيل؟
أليس هذا نفاقًا وقلة حياء لتؤكد أن الوفاء قيمة استباقية لا لاحقة، لأن الاهتمام الذي يأتي بعد الدفن لا يصلح ما أفسده التجاهل والغياب الطويل، فكان يمكن لاتصال بسيط أو زيارة قصيرة أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في نفس الراحل، لكن الضمير يؤجل واجباته حتى يفقد أثرها، وعندئذ يتحول الحزن إلى محاولة لغسل التقصير أمام الناس، فيصبح العزاء تبرئة للذات لا تكريمًا للميت، وهو خلل أخلاقي واضح.
وما فائدة البوز الإعلامي في المقابر وراء الأموات بينهم؟
حين تتحول الجنازات إلى فضاءات تصوير وتصريحات، ترتفع الهواتف قبل الأكف، وتُلتقط الصور قبل قراءة الفاتحة، ويتسابق رعاع الخلق نحو الكاميرات بدل الاقتراب من أسرة الفقيد، وهذا السلوك يعبر عن هيمنة ثقافة الفرجة حتى في لحظات الحداد، فيغدو المأتم حدثًا إعلاميًا عوض تجربة إنسانية صامتة، وتفقد المقبرة هيبتها لصالح اللقطة الجيدة، وهو مشهد يسيء للفن قبل أن يسيء للميت.
ونستحضر قول أجدادنا: "البكاء وراء الميت خسارة" باعتباره خلاصة حكمة اجتماعية مغربية متجذّرة, لأن الثقافة الشعبية كانت تقدّم الفعل على القول، وتعتبر الدعاء والعمل الصالح أصدق من الضجيج، ولم تكن الجنائز مناسبة للظهور بل لحظة سكينة وتواضع، وكان التضامن يتم في البيوت وليس على المنصات، وهذه المقارنة تكشف المسافة بين قيم الأمس وممارسات اليوم، إذ انتقلنا من أخلاق الجوهر إلى أخلاق الصورة، ومن الصمت الوقور إلى الاستعراض الرقمي.
ويبرز السؤال عن أحوال المرضى بينهم هو الاختبار الحقيقي لصدق العلاقات المهنية، فالمريض يكشف معادن الناس أكثر من أي مهرجان أو احتفال، غير أن كثيرًا من الفنانين، خصوصًا كبار السن، يعيشون أمراضهم في عزلة قاسية، فتمرّ أسماؤهم مرورًا عابرًا كأنهم خارج الذاكرة الجماعية، فلا زيارات ولا مبادرات دعم ولا التفاتة إنسانية بسيطة. بينما تُفتح دفاتر المديح فور وفاتهم، وهنا يتجلى التناقض بأوضح صوره.
ويكشف حتى اليوم أن العديد من رواد السينما والتلفزيون والمسرح يعيشون في غيابات النسيان رغم تاريخهم الطويل وعطائهم الكبير، فبعضهم مرضى أو متقدمون في السن أو يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة دون سند حقيقي، فلا تُذكر أسماؤهم إلا لمامًا ولا يُستدعون إلا نادرًا، لكن ما إن يموت أحدهم حتى يبدأ النفاق الفيسبوكي بالانتشار كالنار في الهشيم، وفجأة يصبح رمزًا وطنيًا وقيمة فنية كبرى وخسارة لا تعوض... وتُكتب القوائم الطويلة: كممثل عظيم، مخرج عظيم، فنان كبير، بينما في الواقع كان منسيًا في حياته، يمرّ بجوارنا دون أن يلتفت إليه أحد.
ويشبّه الأمر بمن تهتم به وتخلص له وتحفظ تفاصيل حياته بينما هو لا يحفظ حتى رقم هاتفك، لتوضيح اختلال ميزان العلاقات، فتمنحه وقتك وذاكرتك واهتمامك، لكنه لا يمنحك الحد الأدنى من الاعتراف، وبعد رحيلك يخلق دراما وهمية وكأنه كان أوفى الناس لك، ويبالغ في الحزن ويروي ذكريات لم تحدث أصلًا، فتتحول المشاعر إلى رواية مفبركة للاستهلاك العام. وتعتبر هذه خيانة مزدوجة، إهمال في الحياة وتمثيل في الموت، وهذا أقسى أشكال الزيف.
فانظروا كيف تتحول وسائل التواصل إلى مسرح للحزن المزيف حينما تُختزل الفواجع في منشورات ووسوم وصور أرشيفية، فيتنافس البعض في سرعة النشر بدل سرعة المساعدة، ويُقاس التعاطف بعدد الإعجابات لا بعمق الفعل، وتصبح المأساة محتوى عابرًا في خوارزميات المنصات، بينما يغيب أي مشروع حقيقي لحفظ ذاكرة الراحل أو دعم أسرته، وهكذا يذوب الإنسان في ضجيج رقمي سريع الاستهلاك، فيموت مرتين، مرة في الواقع ومرة في الذاكرة،
ومن الحكمة إعادة تعريف الوفاء بوصفه ممارسة يومية هادئة بعيدة، لا تحتاج كاميرا ولا جمهورًا، فالوفاء أن نسأل عن زملائنا المرضى، وأن نكرّم روادنا وهم أحياء، وأن نصون كرامة الشيوخ قبل أن نرثيهم. فالاحترام الحقيقي يُقدَّم في الحياة وليس في بيانات النعي. وعندما يستعيد الوسط الفني حسّه الإنساني، يستعيد الفن نفسه قيمته الأخلاقية، أما الاستمرار في هذا السلوك الوقح فلن ينتج سوى مزيد من التمثيل خارج الشاشة، وحينها يبقى النفاق السينمائي هو الدور الوحيد الذي يُتقنه الجميع.