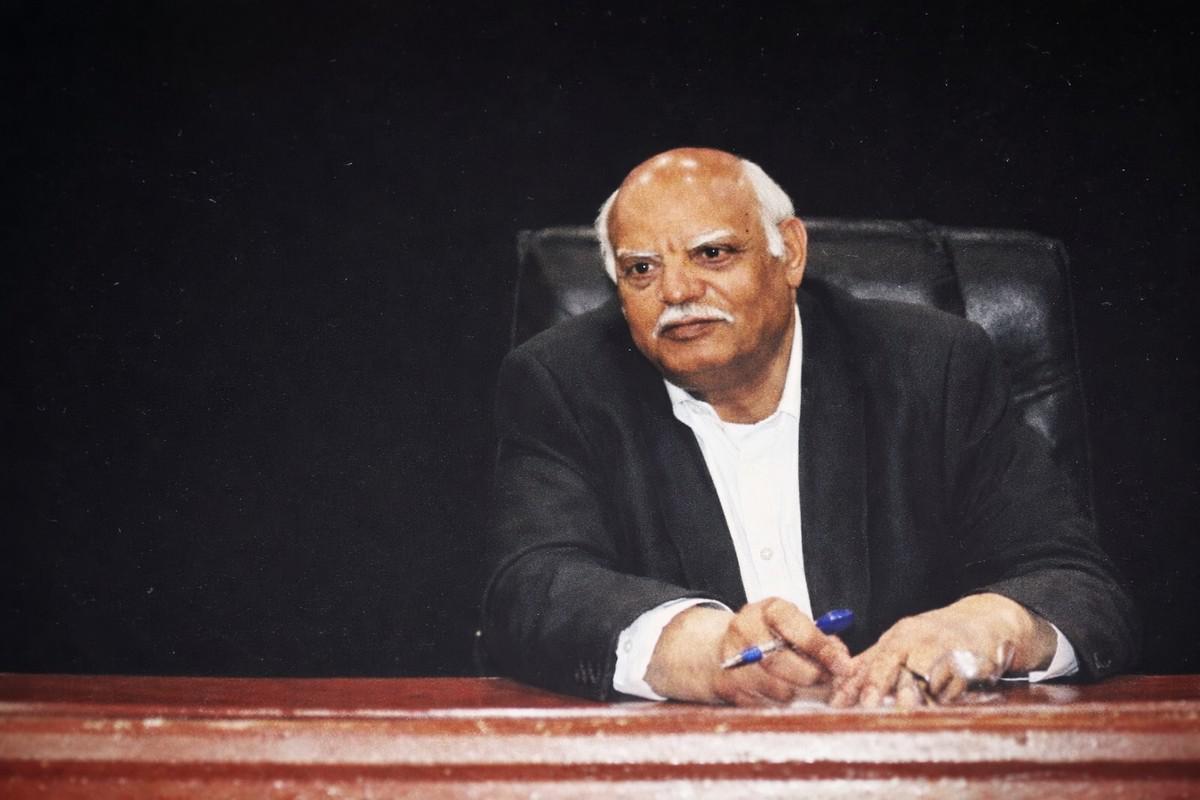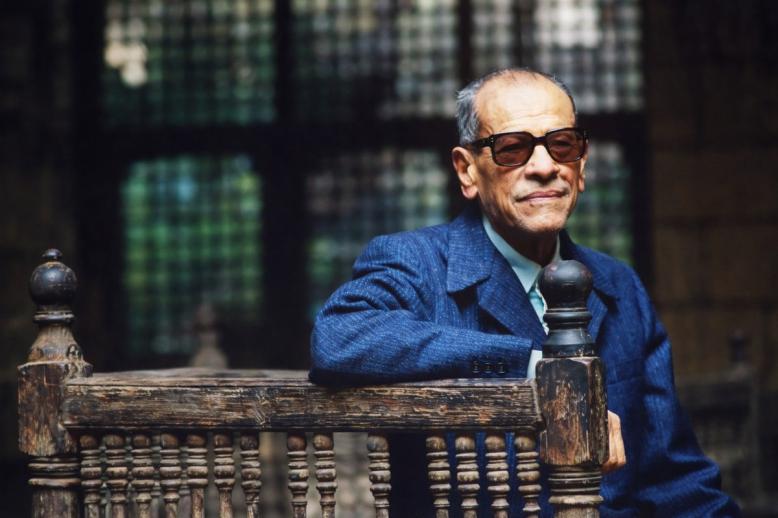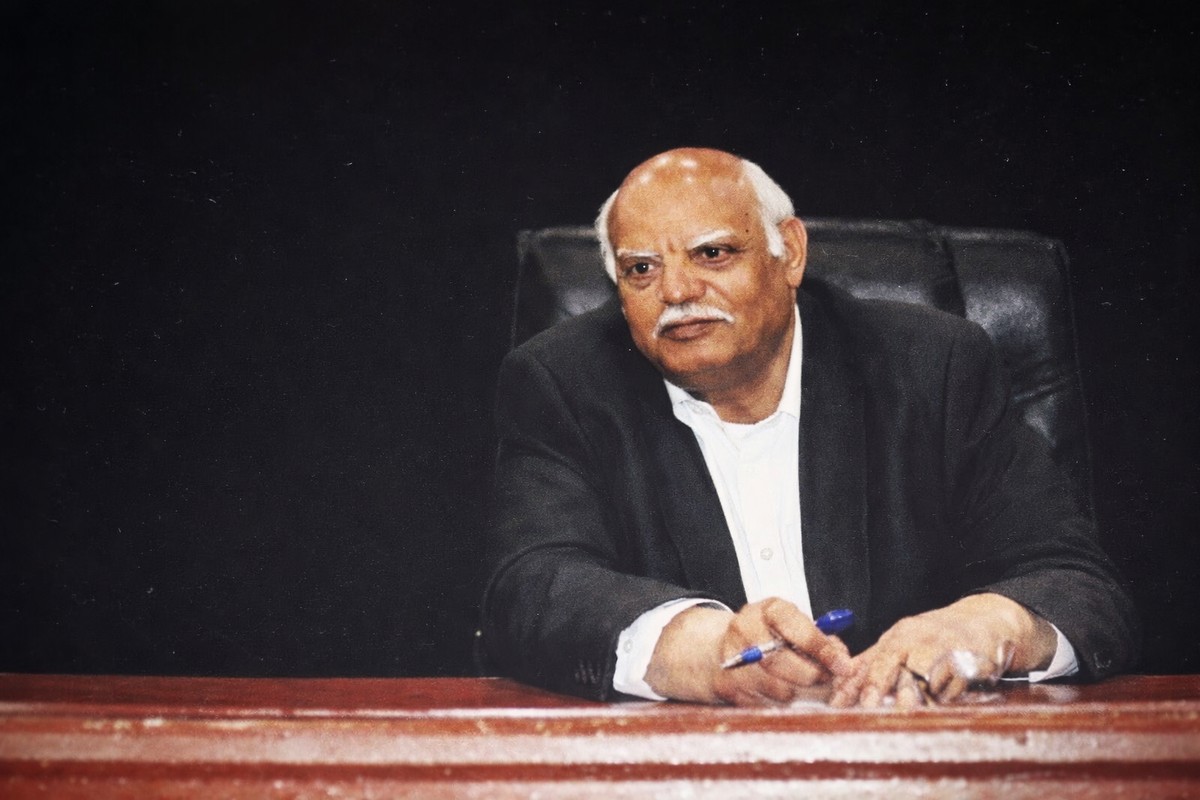اغتراب الكائن داخل كلماته في 'عندما بكت عليّ شجرة البلوط'
يبدأ المعنى في قصة "عندما بكت عليّ شجرة البلوط" للأستاذ الطيب صالح طهوري من ارتباك السؤال لا من وضوحه، ومن اللحظة الأولى التي يُلقى فيها السؤال على شجرة البلوط. ليس السؤال هنا استفسارا سطحيا عن الاسم أو عن أصله، ولا دعوة بسيطة للتأمل في تصريف الكلمات؛ إنه سؤال وجودي ولغوي في الوقت ذاته، يتصل بالطريقة التي يصير بها الكائن ما هو عليه داخل اللغة، وبالكيفية التي تستقر بها هويته في شبكة الحروف واللفظ. منذ أن تنبه الفكر الإنساني إلى هذه المفارقة، تحول السؤال عن الاسم إلى سؤال عن المصير، وصار الحرف وحدة وجود لا مجرد صوت يُلفظ بلا معنى. اللغة بهذا المعنى ليست أداة لنقل الأفكار فقط، إنها فضاء حي للوجود وميدان للشك الأخلاقي والفكري، حيث يغدو كل حرف مرآة لوعي الكائن ومكانه في العالم.
عندما تُسأل الشجرة في النص عن تحوّلها، وكأنها تمتلك ذاكرة بشرية، يتردد في الخلفية صدى أفلاطون في محاورة "كراتيلوس" وهو يتساءل عن علاقة الاسم بالشيء: أهي علاقة اتفاق اعتباطي أم ضرورة كامنة في طبيعة الموجود؟ لا تمنح القصة جوابا حاسما، لأنها لا تسعى إلى اليقين، إنما إلى التأمل في المنطقة الرمادية بين المعرفة والشك، بين الوجود واللغة. ليس الشك هنا أداة معرفية خالصة كما عند ديكارت؛ إذ هو تجربة وجودية ولغوية في الوقت نفسه، حيث يتحول السؤال إلى فعل وجودي، ويغدو البحث عن الكلمة الصحيحة رحلة لفهم الذات والآخر والعالم.
تتكلم الحروف داخل القصة، فتغادر اللغة حيّز التجريد إلى حيّز الأخلاق والعدالة، وتغدو الحروف كائنات صغيرة لها رغباتها ومواقعها في العالم، ولها حق التعبير وحق الاحتجاج. يلتقي هذا مع ما لمح إليه الجاحظ حين قال إن المعاني مطروحة في الطريق، والشأن كله في إقامة اللفظ، أي في كيفية صوغ المعاني في قالب لغوي يتيح لها أن تُرى وتُسمع وتؤثر. ليست إقامة اللفظ هنا بناءً نحويا فحسب، وإنما هي بناء عدالة لغوية وأخلاقية، حيث يُفهم المعنى من موقعه داخل النص ومن التفاعل الذي ينشئ علاقة بين الحروف والكائنات التي تحملها الكلمات.
عندما تحتج اللام على موقعها في الكلمة، يتجسد سؤال قد شغل الفلاسفة السياسيين من أفلاطون إلى جون رولز: من الذي يحدد توزيع المواقع؟ وعلى أي أساس يُمنح السكون لهذا ويُفرض التيه على ذاك؟ القاعدة النحوية، كما تتجلى في نسيج القصة، تشبه القانون الوضعي؛ فهي تدّعي الحياد، لكنها تكشف عن انحياز صامت وتوزيع للسلطة يخفي أثره. تتحول اللغة هنا إلى نظام سلطوي مقنّع، كما أشار ميشيل فوكو، الذي رأى أن الخطاب المفروض يغدو ممارسة للسلطة، فتتحول الكلمات إلى مراكز قوة، والحروف إلى وحدات للمراقبة والاحتجاج.
امتداد اللام، ذلك الطول الذي يشير إليه النص بوصفه قربا من المتكلم ومن الجسد، يذكّر بما قاله هايدغر عن اللغة بوصفها بيت الكينونة. ليس هذا البيت دائما ملجأ دافئا؛ فقد يكون سجنا أنيقا أو فضاء يسمح بالكشف ويؤجل الخلاص في الوقت نفسه. اللام، وهي تحتج وتغضب داخل هذا العالم الحكائي، تفعل ذلك بوصفها وعيا يسائل مكانه داخل بنية أكبر، فتقترب من صورة الذات المفكرة عند ديكارت مع فارق جوهري: هذه الذات لا تقول "أنا أفكر إذن أنا موجود"، وإنما تقول "أنا موضوعة على هذا النحو، ولذلك أحتج"، فيغدو احتجاج الحروف فعل مقاومة على المستوى اللغوي والفكري.
عندما تصف القصة لحظة الاندماج القسري بين اللام والنون، يتداعى إلى الذهن مفهوم الفناء عند ابن عربي، حيث يذوب الحد الفاصل بين الأنا والآخر. لا يحمل هذا الفناء وعد الكشف الصوفي، إنه يتخذ طابع الضرورة القاهرة كما عند سبينوزا، حيث تتحقق الحرية عبر فهم ما يستحيل تغييره. ليس الدخول إلى مسكن النون تصالحا، وإنما اعتراف بأن النظام أقوى من الرغبة، وأن الاندماج قد يكون الوجه الآخر للهزيمة. هنا تتقاطع التجربة اللغوية التي يقترحها النص مع التجربة الوجودية عند سارتر، حيث الإنسان محكوم بالحرية من جهة ومحاصر بالبنى من جهة أخرى، فيغدو السرد مزيجا من حرية وفكر مقيد بالأطر السائدة.
لا يظهر التحسر الطافي في صوت الراوي بوصفه انفعالا شخصيا، إنه بيان وجودي عن حركة بلا سكن. أربع وثلاثون سنة من الحركة المستمرة دون ملاذ، تستدعي مفهوم الإرادة العمياء كما صاغه شوبنهاور، تلك القوة التي تدفع الكائن إلى الاستمرار دون غاية واضحة. مهنة لا يُنال فيها الموت ولا تُمنح فيها الحياة تستحضر صورة سيزيف عند كامو، غير أن الصخرة هنا ليست حجرا، إنها زمن متراكم، سنوات تتحرك دون أن تبلغ سكونا، وكل لحظة منها مثقلة بعدم اليقين وبالخضوع للنظام القسري للكلمات والحياة.
عندما تبكي الطبيعة كلها في خاتمة القصة، لا يتحول المشهد إلى استعارة رومانسية سهلة، إنه يتحول إلى رؤية كونية تتقاطع مع باشلار في تواطؤ العناصر مع الخيال الإنساني. السحب، الأشجار، الجدران، الأزقة، كلها شهود على انكسار المعنى، تشارك في البكاء لأن العالم بأسره يعلن الفقد. يستدعي هذا المشهد ريلكه، الذي رأى أن الأشياء تنادينا بصمتها، ويستدعي الحلاج حين جعل الكون كله ناطقا بالحق لمن يملك أذن السماع، والسماع هنا لا يقود إلى الطمأنينة، وإنما إلى إدراك عمق الغياب وإلى الوعي بأن العالم يعيش ترنحا دائما بين المعنى والفراغ.
في خلفية هذا كله، تعمل القصة بوصفها سؤالا عن اللغة ذاتها، وهو السؤال الذي شغل سوسير عندما فصل بين الدال والمدلول، ثم عاد دريدا ليفكك هذا الفصل كاشفا عن لعبة الإرجاء التي لا تنتهي، حيث يفتح كل معنى على معنى آخر، ويستدعي كل حرف احتجاجا جديدا. لا تستقر الحروف لأن المعنى نفسه لا يستقر، وكل محاولة للسكون تصطدم بإرجاء متجدد. ليست الحركة هنا عرضا طارئا، إنها شرط وجود داخل نظام لغوي لا يعترف بالنهايات، ويضع القارئ أمام مسؤولية التأويل والتأمل المستمر.
هكذا تنكشف القصة بوصفها مساءلة مركبة للغة والعدالة والهوية دون ادعاء امتلاك أجوبة جاهزة. إنها تضع القارئ في موضع الشريك في السؤال، على النحو الذي أراده أبو حيان التوحيدي حين جعل الكتابة حوارا مفتوحا لا تقريرا.
لا تكمن القيمة في الرمز وحده، إنها تكمن في الطريقة التي يُستدرج بها الفكر إلى حافة التأمل، حيث يكتشف القارئ أن اللغة التي يظنها مأواه قد تكون غربته الأعمق، وأن السكون الذي ينشده قد يكون اسما آخر للنهاية، أو كما تقول القصة: بكاء الشجرة ذاته، الذي يفتح أفق الفهم دون أن يغلقه باليقين، ويجعلنا نلامس الثقل العميق للوجود واللغة معا.