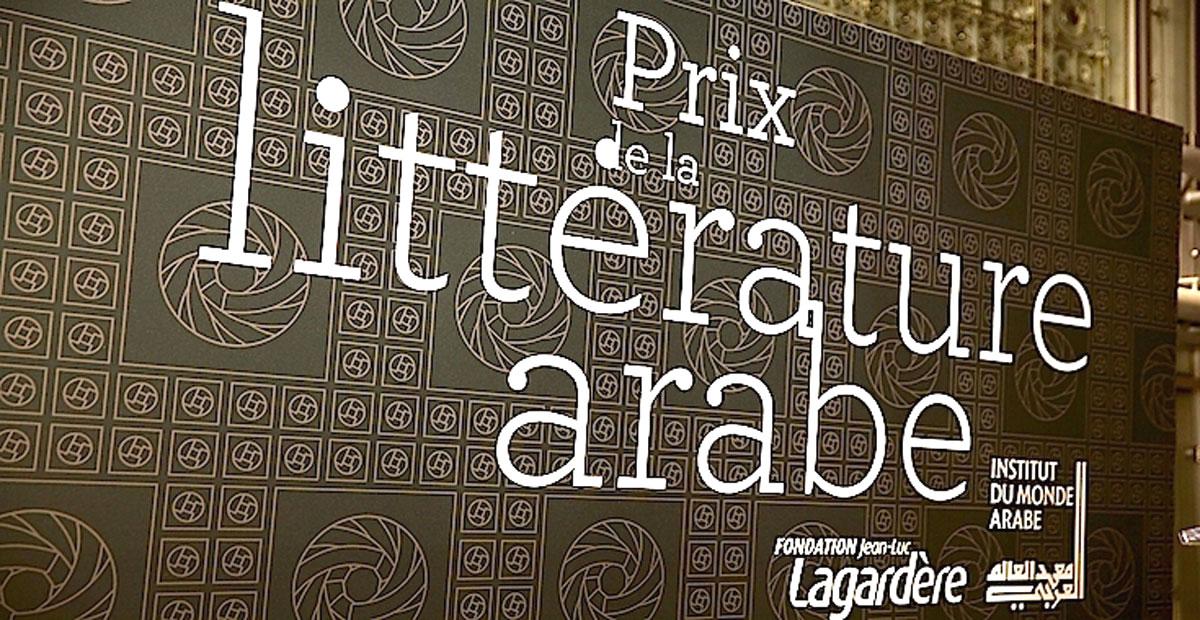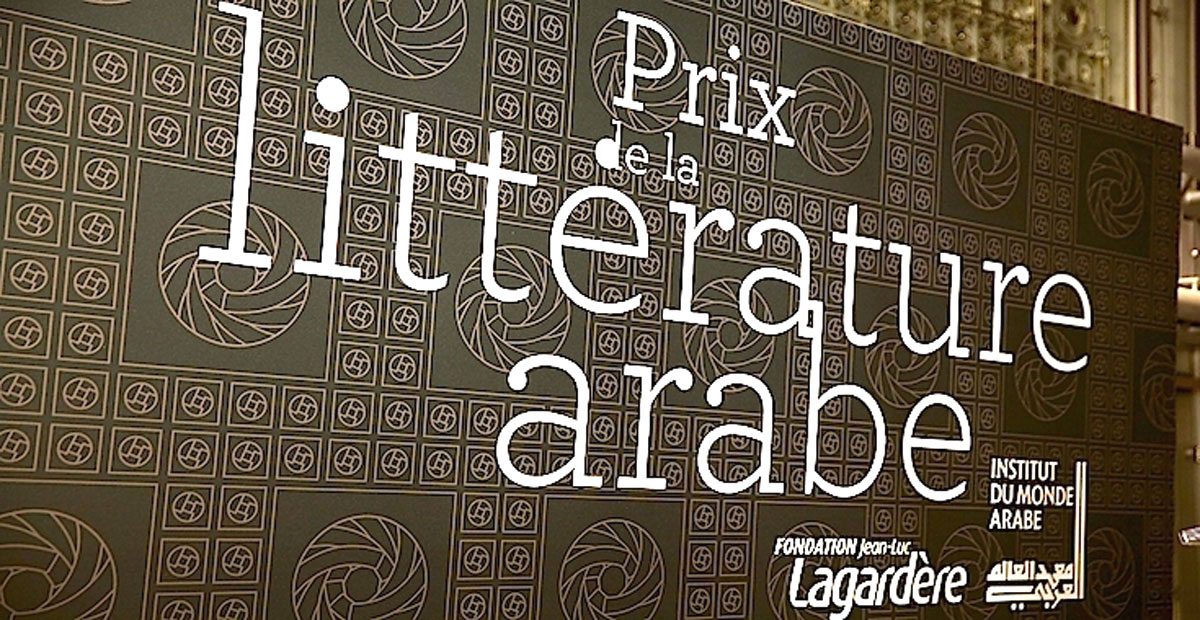البقاء للإبداع وليس للجوائز
تحقيق: مصطفى عبدالله
لا يزال النقاش محتدمًا في الساحة الثقافية في وطننا العربي، وفي بعض المهاجر أيضًا حول خبر توجه جائزة الأدب العربي، التي منحها معهد العالم العربي بباريس ومؤسسة جان لوك لعام 2018 إلى الكاتب البريطاني من أصل مصري عمر روبير هاملتون لا غاردير، وهي الجائزة التي تمنح لروايات عربية مترجمة إلى اللغة الفرنسية أو مكتوبة بالفرنسية أصلا.
وسبب الاختلاف مع معهد العالم العربي راجع إلى أن أغلب المبدعين والباحثين والأكاديميين الذين تحدثوا إلينا يرون أنه من غير المعقول أن تمنح جائزة الأدب العربي لرواية كتبت في الأصل بالإنجليزية ثم وقعت ترجمتها إلى الفرنسية، وأنه لا يكفي أن يكون مؤلفها من أصل مصري ليمنح هذه جائزة الأدب العربي، وهو الذي لم نقرأ له نصًا بالعربية، وتطرق النقاش إلى الأدب وهل ينتسب إلى اللغة التي يكتب بها؟
وما هي معايير تحديد انتماء النص الأدبي: أيكون قوميًا أم لغويًا؟
وأكد الناقد التونسي الدكتور محمد آيت ميهوب أن المدرسة الفرنسية صارمة جدًا في رفض أن تكون جنسية الكاتب معيارًا لتحديد انتماء النص، إذ ترى أن قومية الأدب هي لغته فقط.
لكن الروائي الدكتور شريف ماهر مليكة، الذي يتمسك بالكتابة الأدبية بالعربية على الرغم من أنه مهاجر منذ أكثر من ثلاثين عامًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، اختلف كثيرًا مع مَنْ انتقدوا توجه جائزة معهد العالم العربي، وكتب لنا تعليقُا متوسلًا بأسلوب مغلف بسخرية مرة:
"بعد أن نشرت رأيي في هذ التحقيق الصحفي المهم الذي بثه موقع ميدل إيست أونلاين منذ أيام عن جائزة الأدب العربي التي منحها معهد العالم العربي بباريس لرواية (المدينة تفوز دائمًا)، تبين لي أنني كنت المؤيد الأوحد لهذه الجائزة، ومن ثم فبعد قراءتي لباقي التعليقات التي وردت لتعبر عن امتعاضها من الحدث، قررت استدراك رؤيتي الأولى، ومراجعتها.
فقد تبين لي أن الغرب الظالم يترصد بنا، فهذا الغرب يفتح لنا أبوابه للهجرة، ويوفر المستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا. ثم يرعى هؤلاء الأبناء؛ فيعلمهم ويثقفهم، وحين يلحظ موهبة بعضهم الأدبية، يشجعهم بجائزة خاصة بهم كعرب مهاجرين لا يتكلمون العربية، ولكن ثقافة أهلهم الموروثة لا تزال تكتنفهم. ثم يتظاهر هذا الغرب اللئيم يأنه يتفهم موقف هؤلاء الأصاغر الذين لا نعلم عنهم شيئًا، لأنهم لا يكتبون بلغتنا، فيمنحهم جائزة الأدب العربي المكتوب بلغة الغرب. بل ويدعوها الجائزة الأدبية العربية كنوع من التمويه.
أما نحن فنثور طبعًا ضد هذه المؤامرة التي يحيكها الغرب الملعون في حق لغتنا العربية.
هل يظن الغرب الساذج أن حيلته تنطلي علينا؟
يبتغي الغرب، دون أدنى شك، أن ينتزع عن العرب عروبتهم، وعن ثقافتهم لغتها.
إنه يريد أن يلهينا بمنح جائزة عربية لمثل هؤلاء المهمَّشين فنظنه يوليهم اهتمامه، في حين أن هدفه المستتر يكمن في تقويض دعامة ثقافتنا الأولى؛ اللغة العربية.
فهل ينقص ثقافتنا العربية، وجوائزنا الأدبية الشامخة مثل هذه الجائزة، وهل هي بحاجة إلى أفكار مثل هؤلاء المُدّعين الذين لم يسمع بهم أحدٌ من نقادنا العظام؟
ويستطرد مليكة قائلًا: ومن قال إنه يمكن لأي إنسان لا يكتب بالعربية أن يعَبِّر عن ثقافة العرب؟
فحتى جبران خليل جبران حينما كتب رائعته "النبي" خطها بالإنجليزية، لا بد لنا أن نعتبرها أدبًا أميركيًّا، ولا ننزلق إلى تلك السقطة التي كان الغرب قد أعددها لنا.
كلا.. لن تنطلي علينا حيلة الغرب ومكره حين قدمه إلى العالم ككاتب لبناني أميركي، صاحب أكثر كتاب توزيعًا في التاريخ بعد الإنجيل.
كلا.. وألف كلا، فالكاتب الذي لا يكتب بالعربية لا يعبِّر عن ثقافتنا، ولو كان جبران!

بل ولو كتب نجيب محفوظ روايته "أولاد حارتنا" بالإنجليزية، كما قرأتُها أنا للمرة الأولى، بسبب منع نشرها في مصر، لأعددناها أدبًا إنجليزيًّا.
وكما كتب أحد المعلِّقين: يجب ألا يُعتبر كاتبو المهجر كتّابًا عربًا، حتى وإن كتبوا بالعربية. إذ أنهم لا يعايشون الواقع، ولا يشعرون بنبض الشارع العربي. ولذلك ينبغي ألا نعتبر كتابة جبران أو مطران أو الريحاني أو الأجيال المتعاقبة بعدهم من مثل هؤلاء المهجريين، كتابة عربية بعد اليوم!
انتهى تعليق الدكتور شريف مليكة على من انتقدوا هذه الجائزة، لكن باقي التعليقات لا تزال تواصل موقف الرفض.
فيؤكد الباحث محمد عبدالرحيم الخطيب أن هذا تحقيق مهم جدًا يفتح الباب على مصراعيه أمام أسئلة كثيرة متعلقة بالحاجة إلى انضباط وانحكام شروط المسابقات المتعلقة بالأدب العربي، ولعله يكون لبنة للاحتكاك بقضايا مماثلة تعج بها الساحات الثقافية.
ويعلق المثقف العراقي صباح محسن كاظم بأن ما نشرته ميدل إيست أونلاين استطلاع مهم جدًا، فلكل جائزة إشتراطات، ودوافع تقف خلفها، أما تنحية اللغة العربية عن جائزة تنسب أن كاتبها أصله عربي، فلا يمكن القبول بها، وهناك مئات الروايات كتبت بلغة عربية وتستحق الفوز بجدارة.
ويكشف الباحث التونسي أصيل الشابي بأنه يصعب إيجاد رابط بين اسم الجائزة وما قدّم في قائمة الترشيح. وأتصوّر أنّ الأمر يعود إلى سياسة معهد العالم العربي، وإلى تدابير الجائزة في حدّ ذاتها، لأنّني لمّا عدت إلى قائمة الترشّحات وجدت عناوين روايات مكتوبة أصلًا باللّغة الفرنسيّة، ومنها على سبيل المثال الكاتبة الجزائريّة كوثر عظيمي التي تقدّمت لنيل الجائزة بروايتها الصادرة باللّغة الفرنسيّة بعنولن "ثراؤنا" أوNos richesse" " الصادرة عام 2018 في فرنسا عن دار “Seuil”وفي الجزائر عن دار "البرزخ".
وقد نالت كاتبتها جائزة "رونودو" عن أسلوبها.

وفي القائمة نرصد أيضًا: رواية الكاتب الكويتي طالب الرفاعي الصادرة ترجمتها الفرنسية عن دار النشر الشهيرة "أكتسود" ورواية الكاتب الجزائري سليم باشي الصادرة عن الدار الشهيرة "جاليمار"، ورواية رشيد الضعيف الصادرة عن دار "أكتسود" أيضًا، ورواية جاد هلال.
ويؤكد الباحث التونسي أصيل الشابي على أن اللّغة محدّد أساسي لانتماء الأدب، ويذكر أن مثاله البارز على هذا: جوزيف كونراد البولوني، وقد كتب أيضًا بالفرنسيّة، ولكنّ إبداعه تحدّد في إطار الإنجليزيّة.
ويعلن الكاتب المصري عمارة إبراهيم كفره بالجوائز بوجه عام، لأن منحها ليس لفرادة إبداعية تفوقت عن كتابات مثلها، بل ربما كان للسياسة دور في المنح، أو المجاملات، أو الذائقة، أو الفساد. والكتابة الإبداعية العربية التي تسعي للتفوق التقني والجمالي بشكل حاسم، لا يرغب أصحابها أن يغرقوا في مستنقع جوائز تحكمها معايير عجائبية.
والبقاء سيظل للإبداع المتفوق، وليس للجوائز.
ومن جنيف تشير الدكتورة فوزية العشماوي إلى القضية من زاوية أخرى، عندما تكشف لنا عن أن معظم الأساتذة ورؤساء اقسام الدراسات العربية في الجامعات الاوروبية لا يكتبون بالعربية! وحاليًا رئيس قسم اللغة العربية بجامعة جنيف لا يجيد اللغة العربية كتابة، أو فهمًا! ولكن الغرب يعتبره، هو وأمثاله، "خبراء" في الدراسات العربية الأدبية، والإسلامية أيضًا.
وتقول الشاعرة الدكتورة عزة بدر: بالفعل هو أمر محير أن يعيش الأديب العربي مغتربًا، فربما لا بد له من أن يكتب معبرًا عن نفسه العربية بلغة يتقنها، وغالبًا ما يكون ذلك بلغة المهجر الذى سافر إليه، وليس بلغته الأم التى حرم من أن يعبر عن نفسه من خلالها لغلبة لغة مهجره على لغة موطنه، فكل من حوله يتحدث لغة أجنبية، وتباعدت وشائج الكلام، والسلام، والحوار، والتهنئة، والعزاء، والصبح، والمساء، وعذب الأغانى، وقصائد العربية بصوت أم كلثوم وعبدالوهاب وسيد درويش، وثنائى صوت قيس ليلى، وكثير عزة، وعمر بن أبي ربيعة، وبشار بن برد، والمعلقات السبع، ولغة التهجد، والسجود، وتلاوة القرآن الكريم، للغة العربية كل هذا البهاء لكن ماذا عن الأديب العربي الذي يعيش في المهجر؟

إن مشكلة إبداعه وتعبيره عن الذات ستكون مزدوجة لأنه يريد أن ينقل قضيته وأخيلته العربية من خلال وسيط هو اللغة الأجنبية، ولا بأس فى هذا لأن لذلك أسبابه، فهو يعيش بلغة أخرى، ويكتب بها ويأكل ويشرب بها، ويدفع بها إلى أسماع آخرين هم أقرب إليها وإلى فهمها. ولكي لنعرف إذا كان الأديب المغترب المستخدم للغة أخرى قد عبَّر عن مواطنيه أو عن نفس عربية وآمال عربية وآلام عربية، فلا بد أن نقرأ العمل نفسه، ويكون ذلك هو المعيار الحقيقي لنعرف: هل عبَّر بالفعل عن أدبه العربى وعن أمته حتى لو اختلفت اللغة؟ وهذا معيار موضوعي مهم.
بعد ذلك يأتي دور الدارسين وأساتذة الأدب العربي والأدب المقارن وآداب اللغة لينقلوا إلينا حجم التوفيق في التعبير عن أدب عربي مكتوب بلغة أخرى، وكذلك جمهور القراء الذين لا بد لهم من قراءة العمل الأدبي نفسه. ولذا لا يمكن استباق الحكم على أديب حصل على جائزة إلا وفق شروطها، ووفق قراءة العمل، وما أسفرت عنه من اكتشاف لغة أخرى بين السطور، لا تحملها الكلمات وإنما تحملها الجوانح، لا تضمها الحروف وإنما تتجلى في البياض الشاسع الذي ربما يحمل غربة الإنسان العربي وشوقه لبلاده ولمواطنيه.
لذا أفضل أن يقرأ القارئون، ويترجم المترجمون، ويقدموا للناس وللساحة الأدبية ما أسفر عنه البحث والتدقيق والقراءة والتمحيص، ثم يخرجوا علينا بنتائج قد استخرجت بعد بحث ودرس، لا أحكام شفاهية لم تسبر غور العمل، بل لم تقرأه من الأصل
وتوضح عزة بدر أنه هكذا لا بد أن تمضي شؤون الأدب وشؤون البحث القائم على المعرفة الذي يرتبط بالأسباب والنتائج، فهكذا تعلمنا من الإمام محمد عبده، كما تعلمنا من سلامة موسى، كما علمنا طه حسين بمنهجه في التفكير.
المسألة ليست الجائزة، وإنما ان نقرأ عملًا جديدًا تسبب في إثارة كل هذه الأسئلة، وفى كل بحث غنى، وفي كل قراءة ثراء.
ونختتم جولتنا مع الروائي اليمني محمد الغربي عمران بتعليق في كلمتين فقط: "طرح في الصميم".