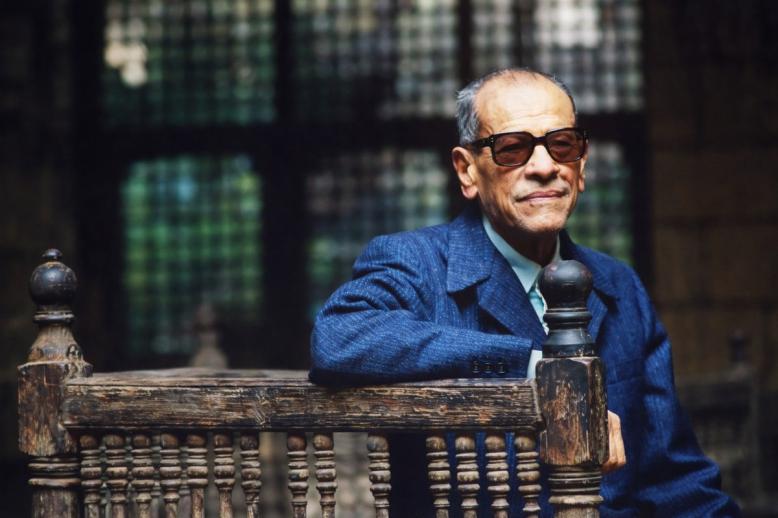الرواية وهوية الفرد
تجاهلت المدونة الثقافية والمنظومة الإجتماعية في الكيانات التي تلاشت فيها قيم الحرية ومفهوم الخصوصية الفرد بإعتباره كائناً مُستقلاً عن الجماعة، فبالتالي سُحقت الذات ولم يعد هناك وعيُ بما يُشَكِلُ مكونات هويتها إلى أنْ هيمنت تلك الصيغ والأعراف التي تكرسُ سلطة الجماعة، ولا يصحُ وجود أصوات خارج الأطر الداعمة لتشكيلاتٍ قائمة على الأسس الآيدولوجية أو الدينية أو السياسية بقطع النظر عن تنوع الخلفيات فإنَّ ما تهدفُ إليه الفئوية ُهو إلغاء الفرد من خلال عملية دمجهِ في ماكينة مُركبة بشعارات وأمثال ومقولات تعبرُ عن نزعةٍ إقصائية للآخر المُختلف فكان الوصمُ بالعار والزندقة نصيبَ من يُخالفُ السرديات السائدة، ما يعني تقديسُ الموروث ونبذ الجديد وذلك أدى إلى تفاقم ظاهرة الكسل العقلي وأصبحَ العطبُ ملازماً للتفكير.
وفي ظلِ هذا الواقع المُلغم بالمَحظورات فمن الطبيعي إستمرار ملاحقة المُفكرين ودعاة الحرية وتصفية هؤلاء جسدياً ومعنوياً كما لم يكن المبدعون أوفر حظاً بل طالتهم أيضاً لعنات حُماة الأخلاق وسجلتْ أعمالهم في القائمة السوداء غير أنَّ السياسات الرامية لتضييق مساحة الإبداع وتهميش النتاجات الفكرية والأدبية المُغذية للحس المُتمرد على التدجين بأشكاله المتعددة ناهيك عن إطلاق الحملات الترويجية المُبرمجة من على المنصات الإعلامية لبثِ مُضادات المشروع التنويري؛ كل ذلك لم يمنع ظهور العوامل التي تعززُ رغبة الخروج من الوصاية والحفر في تربة جديدة والتحليق خارج السرب لَعل العزوف عن المشاركة في العمليات السياسية المُبهرجة بشكليات الحداثة والمثقلة في حقيقتها بأوبئة التخلف يكونُ مؤشراً لمرحلة يتبلور فيها وعي الفرد الذي يرفضُ الإنضواء تحت مظلة الأجهزة المؤسسة للقمع والتعذيب.
عودة الوعي
إذا كان تزييف الوعي وتوقف المبادرات الفردية نتيجة عقودٍ من الإستبداد والمشاريع التعبوية وإنسداد الأفق من بداهاتنا التاريخية هنا يجوزُ أن نتساءَل عن رهانات الإبداع في مقاومة الواقع المزري، وما هي أوجه مشاركة العمل الإبداعي في تنمية الوعي لدى الفرد وتمكينه لإستعادة هويته؟ وكيف السبيلُ لتحديد تمظهرات العلاقة بين أنماط الوعي والفعل الإبداعي؟ فالمُتابعُ لا يخطيءُ ملاحظة ما رافق الحراكات الجماهيرية منذ إنطلاقتها في تونس وجود الأشكال الفنية الجديدة من الجداريات والأغاني والمنشورات الفيسبوكية بوصفها آليةً للتعبير عن الذوات الغائبة والتطلعات المُستقبلية.
ومن المعلوم أن الرواية من أكثر الأجناس الأدبية حضوراً في الوقت الراهن كما أنَّ مساحة تداولها في البيئات المُختلفة آخذة في إزدياد بحيثُ تُغطي الرواية التطورات الُمتلاحقة مُتفاعلةً في هذا السياق مع الصحافة والروابط الإلكترونية وشبكات الإعلام الرقمي. وليس من الصواب تفسير ظاهرة التضخم الروائي بناءً على عاملٍ بعينه ونقولُ بأنَّ الرواية تُلبي الرغبات الإستهلاكية والمعنى أن قراءة الرواية لا تختلفُ عن إستهلاك الأطعمة الجاهزة، ويُقدمُ كل من القاريء والمُستهلك في المُحصلة الأخيرة خدمة لحركة السوق الرأسمالية قد يكونُ هذا التحليلُ صحيحاً بالنسبة لبعض الروايات التي تكتسحُ السوق لمدة، ومن ثُمَّ تستنفدُ صلاحيتها.
دور الرواية يتعاظمُ في تعميق مفهوم الذاتية وصوغ هوية الفرد في واقعٍ مُتشبعٍ بإرغامات سياسية ودينية وإجتماعية
لاشك أن أفق فن الرواية أوسع من أن يُختزلَ في شكل مُعين. والحال هذه لا بُدَّ من مُقاربة الموضوع من زاوية أوسع. ولا يُنكر بأنَّ عنصر المُتعة دافع أساسي لقراءة الرواية كما يذهب إلى ذلك الكاتب البريطاني سومرت موم لكن لماذا لا يعوضُ القاريءُ متعة الرواية بمشاهدة الأفلام السينمائية مع أنَّ المؤثرات الفنية في الفنون المرئية تُضيف مزيداً من التشويق إلى المادة؟
وعلى الرغم من توفير الروايات المسموعة على القنوات الإلكترونية ظلت الأسبقية للقراءة، ولا يمكنُ التنازلُ عن متابعة مُباشرة دون وسيط سواء أكان صوتياً أو مرئياً. ويكمنُ السرد وراء أفضلية القراءة دون بدائلها أنَّ القاريء ما يشرعَ بمتابعة محتويات الرواية حتى يتحول إلى مُشاهد خلاق على حد قول ماريو بارغاس يوسا، ولن يكونَ محكوماً برؤية خارجية ويُطلق العنان لخياله حراً. وبذلك يستعيدُ القاريءُ وعياً بذاته ويتخففُ من مُهيمنات الحشود والجماعة التي يقوضُ الخيالُ مسوغاتها. ومن المعلوم أنَّ السلطة توظفُ تقانات متنوعة لتجفيف الخيال ولا تقبلُ بالأعمال الإبداعية إلا في الحدود التي تخدم مَصالحها.
رواية بديلة
سبق للمفكرة المغربية الراحلة فاطمة المرنيسي أنْ تناولت الخصومة القائمة بين الخيال والسلطة إذ تعتبرُ صاحبة "شهرزاد ترحل إلى الغرب" الخيالَ ملجأ الفردية الأصعب ترويضاً وتصفه بالحديقة السرية للمرء الذي ينجو من المراقبة وكيل التُهم ولا يتقيدُ بالإكراهات الخارجية، وتعزو المرنيسي في كتابها "الخوف من الحداثة" محاربة السلطة لصاحب المشروع التنويري إلى أنَّ الأخيرَ يحاول إدخال المفاهيم الجديدة إلى الفضاءات الخانقة وينفتحُ على الرؤى الفلسفية الأمر الذي يهددُ الواقع القائم والأنساق السلطوية بالإستناد إلى ما ذكر آنفاً عن دور الخيال في تشكيل هوية الفرد وتمكينه للإرتياد لما بعد الخطوط المرسومة يمكنُ فهم تصاعد نسبة قُراء الرواية والأقبال عليها بأنهُ رفض للمرويات الرسمية ومسعى لإدراك خصوصيات الذات من خلال طرح الإفتراضات والسؤال عن الإمكانيات المنسية بعيداً عن المرجعيات التقليدية.
ولم تعد الرواية مجرد مصدرٍ للتسلية والإمتاع إنما قد تكونُ الغاية من قراءَتها هي التزود بمعرفةٍ لما يدور في الأوساط السياسية والإجتماعية، وذلك عن طريق تحليل الظواهر المنتشرة في الواقع على ضوء ما رصده الروائيون في مؤلفاتهم مثلما يتبعُ الكاتب والروائي التونسي كمال الرياحي هذا المنهج في سلسلة مقالاته المنشورة بعنوان "الروايات التي يحتاجُ التونسيون لقراءتها لينتخب رئيسهم" إذن فإنَّ الرواية شأن أي حقل معرفي آخر لا يجوزُ مقاربة مساراتها وفقَ منطق إختزالي.
ضف إلى ذلك فإنَّ التحولات التي يشهدها النص الروائي سواء في صيغه التعبيرية أو ثيماته الجديدة يفرضُ آلية منفتحة على شتى الحقول المعرفية لقراءة المنجز الإبداعي طالما أنَّ ثمة عدداً من الروائيين يستفيدون من خبراتهم العلمية والمهنية في مشروع الكتابة وبهذا يكونُ العمل الإبداعي أكثرَ تواصلاً مع المُستحدثات دون أن يفقد خصائصه الفنية ونحنُ بصدد الحديث عن فتوحات روائية إن جاز التعبيرُ نؤكدُ على أنَّ أيا كان موضوع النص الروائي وشكل ترتيبه البنائي يتم التعامل معه بوصفه مُنجزاً أدبياً قابلاً لمساءلة القاريء الذي يملأُ ثغراته وهكذا يتعاظمُ دور الرواية في تعميق مفهوم الذاتية وصوغ هوية الفرد في واقعٍ مُتشبعٍ بإرغامات سياسية ودينية وإجتماعية.