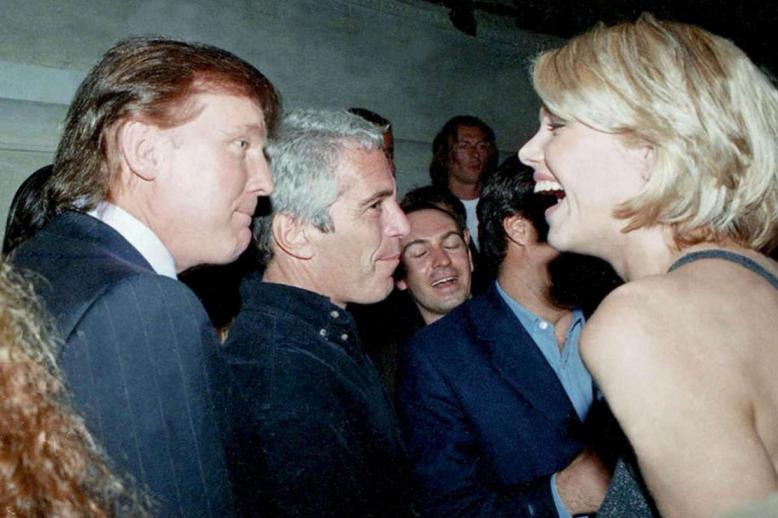الملك محمد السادس… ضمير الوطن ونبض المواطن
في زمنٍ تتسارع فيه التحوّلات وتتعاظم التحدّيات، جاء خطاب الملك محمد السادس ليؤكد أن القيادة الحقيقية تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه، وأن الوطن لا يُبنى إلا حين يكون المواطن في صُلب القرار لا على هامشه، وحين تتحوّل العدالة والكرامة من شعاراتٍ إلى ممارسةٍ يومية في حياة الناس.
إن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية البرلمانية الحادية عشرة، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، جاء في لحظةٍ رمزية ذات مغزى وطني عميق، باعتباره افتتاح السنة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب من الولاية الحالية، ومحطةً حاسمة في مسار العمل البرلماني المغربي. ومن وجهة نظري، لم يكن التوقيت محض مصادفة بروتوكولية، بل رسالة سياسية واضحة، أراد جلالته من خلالها التأكيد على أن الزمن المتبقي من الولاية التشريعية ليس هامشًا للانتظار، بل فرصة لتكثيف الجهود وتوحيد الطاقات في خدمة الشعب والوطن.
في تقديري الشخصي، جاء الخطاب محمّلًا بروحٍ وطنية وتوجّهٍ إنساني متماسك، إذ اختار الملك لغةً قريبة من نبض المواطن، وخاطب ممثلي الأمة بعباراتٍ توازن بين الاعتزاز بالمنجز والدعوة إلى مزيدٍ من الجدية والمسؤولية. ولعل ما يلفت في هذا المقطع تحديدًا هو أن جلالته شدّد منذ البداية على أن المسؤولية الوطنية لا تحتمل التأجيل، وأن مصلحة المواطن ينبغي أن تبقى المعيار الأعلى في كل البرامج والمشاريع المفتوحة، دون أن تفسدها الحسابات السياسية الضيقة.
لا شكّ أن من يتابع الخطابات الملكية المتتابعة يلحظ بوضوح أن البعد الإنساني لم يكن يومًا عنصرًا عرضيًا فيها، بل ركيزة متأصّلة في فلسفة الحكم. ومن اللافت في نظري أن جلالته يتحدث في كل مناسبةٍ بصفته جزءًا من شعبه لا سلطة فوقه، فينصت لهموم الناس ويترجمها إلى دعواتٍ للحكومة والبرلمان والمجتمع المدني من أجل حماية الحقوق وتعزيز الكرامة. أعتقد أن هذا القرب من المواطن هو ما يمنح الخطاب الملكي صدقيّته العالية، لأنه يجمع بين الوعي بالمسؤولية والشغف الحقيقي بالتغيير الإيجابي. ومن هذا المنطلق، لا يتردّد الملك في مساءلة السياسات العمومية عن أثرها الواقعي على الفئات الهشّة، مؤكّدًا أن التنمية الحقيقية لا تكون إلا حين يشعر بها ساكن الجبل كما يشعر بها ابن المدينة.
كما يبدو لي، فإن اهتمام الملك بالمواطن لم يعد مقتصرًا على التوجيه الخطابي، بل تحوّل إلى ممارسةٍ مؤسسية ومنهجية. فهو يتابع باهتمامٍ قضايا الناس في مختلف الجهات، ويحرص على أن تمتدّ عناية الدولة إلى الجميع دون تمييز بين منطقةٍ وأخرى أو طبقةٍ دون أخرى. ومن وجهة نظري كمراقب، فإن هذا التوجّه الإنساني الواضح يجعل من الإنصات قيمةً دستورية قبل أن يكون مجرّد سلوكٍ سياسي. لذلك لا غرابة أن تتصدّر قضايا التعليم والصحة وفرص العمل أولويات الخطاب الملكي، جنبًا إلى جنب مع الدعوة لتقريب الخدمات من المواطنين وتكييف البرامج الوطنية مع واقعهم العملي. ومما ألاحظه هنا أن الملك لا يكتفي بالشعارات، بل يتحدث عن آلياتٍ تنفيذيةٍ ملموسة تؤسّس لعدالةٍ اجتماعيةٍ حقيقية تُشعر كل مواطن بأنه جزءٌ من مشروعٍ وطنيٍّ جامع.
ولا شكّ أن الخطاب قد تجاوز النظرة الكلاسيكية التي تجعل من التنمية مشروعًا إداريًا منفصلًا عن الإنسان، فربطها بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، وجعلها التزامًا استراتيجيًا مستدامًا لا يخضع لتقلّبات السياسة أو لحسابات المرحلة. في رأيي، هذا التوجّه يعكس رؤيةً إصلاحيةً ناضجة تنطلق من الواقع وتستند إلى ثقافة النتائج لا النوايا، ولهذا دعا جلالته بوضوح إلى تحديث طرق العمل ومواكبة التطور التقني في مراقبة وتقييم السياسات العمومية.
أما في خاتمة الخطاب، فقد برزت القيم الوطنية في أسمى صورها، حين شدّد الملك على التعبئة الوطنية والتعاون بين جميع المكوّنات، ودعا الجميع ليكونوا في مستوى الثقة والأمانة، وأن يجعلوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. ومن وجهة نظري، فإن هذا الختام يجسّد فلسفة القيادة في صورتها الناضجة، قيادة تجمع بين الحزم والإنسانية، بين حضور الدولة وهيبة المسؤولية، دون أن تفقد دفء القرب من الشعب.
وفي رأيي، إن هذا الخطاب أعاد التأكيد على جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن في المغرب الحديث، وهي علاقة تقوم على المشاركة لا التبعية، وعلى المسؤولية المتبادلة لا المنّة. ومما أراه أن هذا التوجّه يعيد السياسة إلى معناها الأصلي، خدمة الإنسان لا استغلاله. وبلا شكّ، فإن هذا النص الملكي يجسّد استمرار المدرسة المغربية في القيادة، التي تمزج بين الرؤية الواقعية والبعد الأخلاقي، لتجعل من التنمية مسارًا إنسانيًا قبل أن تكون خطةً اقتصادية، ومن هنا تتبدّى روح الخطاب كوثيقةٍ جامعة بين القيم الوطنية والإرادة الإصلاحية، بين لغة الواقع وطموح المستقبل، في آنٍ معًا.