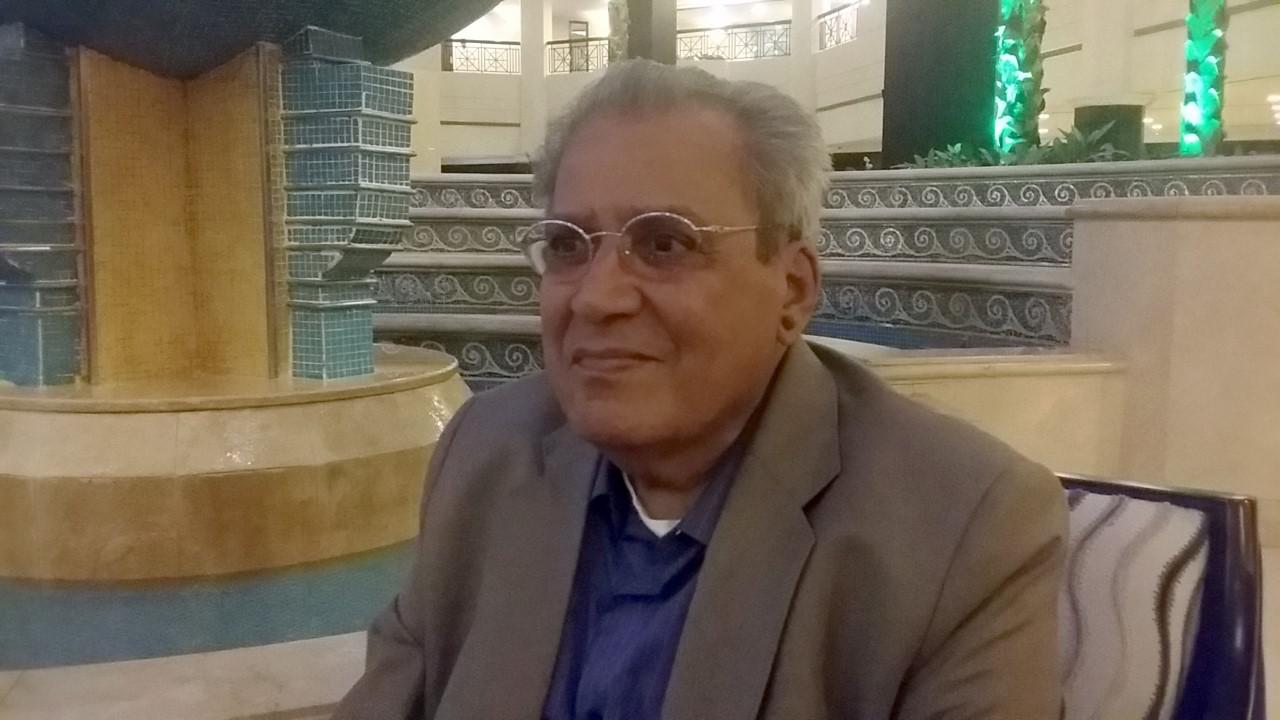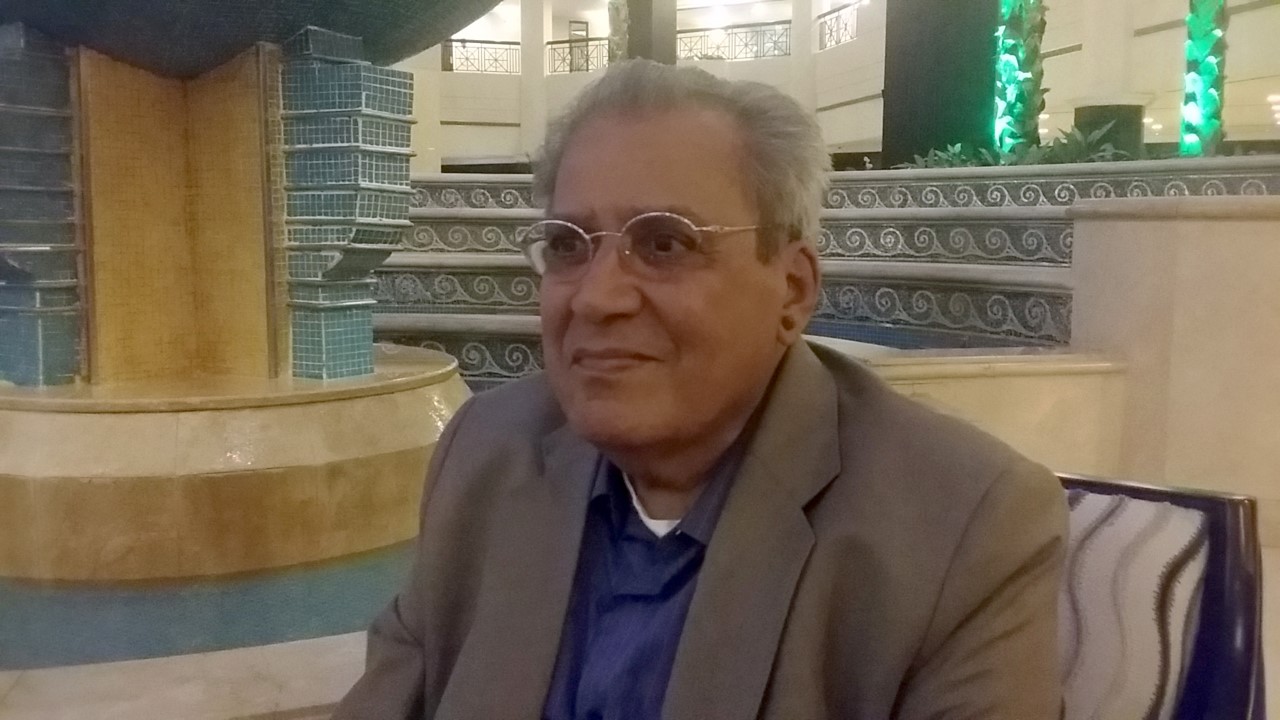جابر عصفور مسيرة حافلة بالعطاء الفكري والثقافي
تفقد الحركة الثقافية العربية والمصرية برحيل المفكر والناقد والمثقف د.جابر عصفور واحدا من أكثر المثقفين عطاء للثقافة فكرا ونقدا وحضورا على مدار ما يزيد عن نصف قرن.
ويشكل إنتاجه مدرسة فكرية ونقدية ثرية بأطروحاتها في الشعر والرواية والمسرح والنقد، هذا فضلا عن حضور قوي ساهم في رسم خارطة الثقافة المصرية وترسيخ حضورها عربيا وعالميا، وساعد في مواجهة الكثير من تحدياتها خاصة مواجهة موجة الأفكار المضللة لجماعات التطرف والإرهاب سواء كانوا من جماعة الإخوان أو السلفيين، وعلى الرغم من الانتقادات التي كانت توجه له بين الحين والآخر أثناء توليه الكثير من المسئوليات داخل وزارة الثقافة المصرية وآخرها توليه منصب وزير الثقافة، إلا أنه ظل محل تقدير المثقفين والمبدعين.
إن المتأمل في الكثير من كتبه "محنة التنوير" و"أنوار العقل" و"زمن الرواية" و"غواية التراث" و"النقد الأدبي والهوية الثقافية" و"نقد ثقافة التخلف" و"تحديات الناقد المعاصر" و"زمن جميل مضى" و"في محبة الشعر" و"هوامش على دفتر التنوير" و"متعة القص"، يرى إلى أي مدى كان مهموما بإشكاليات ورؤى الثقافة والإبداع، وأنه لم يركن يوما إلى الدعة والاستسهال ولكن كان متابعا وقارئا متفردا لتجليات الواقعين الإجتماعي والإبداعي، وأنه ظل حتى لحظاته الأخيرة غير بعيدا عن المشهد الذي أفنى حياته باحثا عن ملامحه وأبعاده والقيم الجمالية والفنية والفكرية المضافة له.
في كتابيه "بعيدا عن مصر" و"زمن جميل مضي" ألقى عصفور الضوء على جوانب مهمة من حياته ومسيرته، كاشفا عن الكثير من التفاصيل عن أسرته ورحلته إلى الجامعة وتخرجه بتقدير ممتاز، ثم عمله بالتدريس بإحدى قرى محافظ الفيوم، ثم كتابته لخطاب للرئيس جمال عبدالناصر الذي كان وراء عودته لجامعة القاهرة وتعيينه معيدا بالقسم الذي تخرج منه، وغير ذلك.
في الكتاب الأول الذي سرد فيه لرحلاته للدراسة والتدريس في أوروبا وأمريكا، قال "كنت أحلم ـ وأنا طالب جامعي ـ أن أمضي في طريق طه حسين، فأستكمل تعليمي العالي بعيدا عن مصر. ومرت الأعوام الدراسية، وتفوقت وأصبحت معيدا في الجامعة سنة 1965 وفي قسم طه حسين، واقترب تحقيق الحلم، ولكن جاءت كارثة 1967 لتجهض الحلم، فحصلت على الماجستير سنة 1969، ولم يكن هناك مفر من استكمال الدكتوراه في جامعة القاهرة، ووعدتني أستاذتي سهير القلماوي بأن أذهب في منحة دراسية إلى الولايات المتحدة لاستكمال أدواتي في النقد الأدبي، ودراسة تيارات النقد الجديدة التي أخذنا نسمع عنها، ولذلك ذهبت إلى الجامعة الأميركية، ودرست فيها ما يؤهلني لفهم اللغة الإنكليزية والكتابة بها. ولكن المنحة التي وعدت بها طارت، وبقي حلم السفر لا يضيع، وبالمصادفة التي حكيت تفاصيلها فيما كتبت، حصلت على فرصة للسفر إلى جامعة وسكنسون- ماديسون، أستاذا زائرا، ولست دارسا. وسافرت بالفعل سنة 1977".
وأضاف "منذ أن وضعت قدمي في هذه الجامعة العزيزة على قلبي، عاهدت نفسي أن أحقق في اثني عشر شهرا ما يحققه غيري في أعوام. وبالفعل، واصلت العمل ليلا ونهارا، فكنت طالبا مجتهدا وأستاذا ملتزما، ولم أترك شيئا ينبغي أن أتعلمه إلا تعلمته، ولا كتابا يستحق أن أقرأه إلا قرأته. وكان عاما كاملا مرهقا، امتد من العام الدراسي إلى أشهر الدراسة الصيفية. كما سافرت في أول أغسطس 1977.. عدت في أواخر أغسطس 1978. وأشهد أن هذه الأشهر هي من أجمل أشهر العمر، لا لأنني عرفت فيها الجامعات الأمريكية للمرة الأولى التي تشبه في بهجتها الحب الأول، ولكن لأنها وضعت قدمي على الطريق المنهجي الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة في النقد الأدبي، وأسهمت في إحداث قطيعة معرفية مع كثير مما كنت أعتقده صوابا من قبل، وما عرفته بعد أن اتسعت حدقتا الوعي المعرفية على كل المستويات".
وسرد عصفور في كتابه الثاني "زمن جميل مضى" ذكريات تخرجه في جامعة القاهرة وبدايات انضمامه معيدا بقسم اللغة العربية بعد أن عمل بالتدريس بإحدى مدارس قرى محافظة الفيوم،قال "ولا أنسى مشهدا دراميا جمعنا، وكان أبي حاضرا، وذلك بعد أن سافرت إلى القاهرة لمعرفة نتيجة الليسانس، وأخبرتها ـ أمه ـ أنني لن أتغيب سوى أيام معدودة. وعرفت النتيجة، وكنت الأول على دفعتي، وتخرجت بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى التي لم يحصل عليها أحد قبلي على امتداد ما يزيد على عشر سنوات، فكان لابد من البقاء، والتأكد من أمر التعيين في الجامعة، ومضت الأيام ولم أجد ما يريحني من وعود الأساتذة الذين كانوا في حالة صراع، أوقف تكليفي، فعدت إلى المحلة، على أن أعود إلى القاهرة لمتابعة الموقف، أو البحث عن عمل إلى أن ييسر الله الأمور وما إن رأتني حتى نظرت إليَّ غاضبة، قائلة: ألم تقل إنك لن تطيل البقاء في القاهرة؟ فقلت لها: إنني نجحت وكنت الأول على كل زملائي، فتهلل وجه أبي، وأخذني بالأحضان، ولم يخف دموع الفرح التي غمرت خديه، وكان أكثر سعادة عندما أخبرته أنه يمكن تعييني معيدا في الجامعة، فصاحت غاضبة: وهل تريد أن تعيد الدراسة بعد كل هذه السنوات؟!. فضحك أبي، وقال لها: يا جاهلة، معيد يعني أستاذ صغير في الجامعة، وهذا تكريم كبير لابنك، وكعادتها، أخفت فرحتها، وقالت: المهم أنه نجح، وأراحنا من نفقاته، فضحك أبي منها، وقبَّلتها رغم ممانعتها الظاهرية، وسمعت وأبي همسها لنفسها: الحمدلله، ربنا يحميه. وظلت على ما تعودت عليه إلى أن استلمت الوظيفة الأولى لي. فقالت لي، مخفية مشاعر الفرحة داخلها وراء قناع الصرامة الذي كانت تجيد اصطناعه، جملتها التي لا أنساها: لقد أدينا ما علينا، فقم أنت بما عليك. فقبَّلتها، ورأيت طيف ابتسامة قاومتها، ودمعة حبستها، لكي لا تظهر ضعفها وحبها الغامر لي، فقد كانت، رحمها الله، تكره الهشاشة العاطفية والبكاء وإظهار المشاعر الفياضة، وتؤثر أن يكون فعلها وسلوكها العملي معبرا عن حبها العميق لكل الذين تراهم الأقرب إلى قلبها.
وأشار "وما كدت أستقر في منزلي بالقاهرة في المساء حتى أخبرني زميلي في السكن بأن د.سهير القلماوي رئيسة قسم اللغة العربية أرسلت من يستدعيني لمقابلتها في مكتبها بمجرد عودتي، وذلك لأمر بالغ الأهمية. ويبدو أن متاعب اليوم وإحباطاته دفعت بي إلى النوم سريعا، فظللت نائما إلى الصباح. وكان أول ما فعلته بعد استيقاظي ارتداء ملابسي والخروج لمقابلة د.سهير القلماوي التي لم أكن أعرفها معرفة حميمة بعد. وكانت المفاجأة السارة الأولى في اللقاء ترحيبها الحار بي، وعتابها لأنني لم أحاول التعرف إليها والاقتراب منها خلال سنوات الدراسة. أما المفاجأة السارة الثانية فكانت إبلاغي أن موضوع تعييني معيدا في القسم قد انتهى إلى ما يسعدني، وأن عليَّ الذهاب لمقابلة رئيس الجامعة لتحيته والتعرف به.
وتابع عصفور "خرجت من عند أستاذتي إلى مكتب رئيس الجامعة وأنا أكاد أطير من الفرح، غير بعض التردد الذي عاودني عندما دخلت غرفة مدير مكتب رئيس الجامعة الذي صدّني أكثر من مرة، ولم يسمح لي بمقابلته لأشكو له الظلم الذي حال دون تكليفي معيدا. ولكن التردد اختفى عندما رأيت علامات الترحيب على وجه مدير المكتبالذي طلب مني الانتظار، وغاب قليلا ليعود طالبا مني الدخول إلى مكتب رئيس الجامعة الذي ما إن رآني حتى نهض من كرسيه وأقبل عليَّ متهللا مرحبا. وكانت دهشتي كبيرة عندما احتضنني الرجل، وظل يربت على كتفي في حنو أبوي قائلا : لماذا لم تأت إليَّ من قبل وتحدثني عن عدم تعيينك؟! ولم أستطع الإجابة، فقد جئت إلى مكتبه أكثر من مرة، وفي كل مرة كنت أعود مدحورا. ويبدو أن الرجل استشعر شيئا من صمتي فقطعه بقوله: على كل حال، لقد أصدرت قرار تعيينك معيدا، فاذهب إلى أمين الجامعة لاستكمال أوراق التعيين، ولا تنس أن بابي مفتوح لك دائما إذا احتجت إلى أي شيء.
وأضاف "خرجت من مكتب رئيس الجامعة قاصدا مكتب أمين الجامعة، وأنا أدعو للدكتورة سهير القلماوي في أعماقي، متصورا أنها هي التي كانت وراء هذا التحول في الموقف. ووصلت إلى مكتب أمين الجامعة الذي بادرني بقوله : أأنت الذي فعلت بنا كل ذلك؟! فقلت له: أنا لم أفعل شيئا، وبارك الله في أستاذتي التي ساندتني ودافعت عني. فنظر الرجل إليَّ نظرة تعجب، وقال: أستاذتك؟! هل تهزأ مني يا ابني؟ألم ترسل شكوى إلى رئيس الجمهورية؟ وأخرج الرجل من أحد أدراج مكتبه الخطاب الذي كنت قد أرسلته إلى جمال عبدالناصر ونسيته مع الوقت، وأعطاني الرجل الخطاب لأرى ما فيه، فوجدت تذييلا على الخطاب بقلم عبدالناصر، وجهه إلى وزير التعليم العالي، آمرا بالتحقيق، وتحته تعقيب من وزير التعليم العالي إلى رئيس جامعة القاهرة آمرا بالتعيين والتحقيق، وتحته خط رئيس جامعة القاهرة الذي أصدر قرار التعيين الفوري.
وبعد أن قرأت هذا كله، أعدت لأمين الجامعة الخطاب دون أن أنطق حرفا، فقد ضاعت مني كل الكلمات، وظللت صامتا، متوترا، مرتعشا، تناوشني شتى الانفعالات التي لم تفارقني طوال الجلسة، وفي أثناء توقيعي على الأوراق التي طلب مني أمين الجامعة توقيعها. وخرجت من عند الرجل لأعود إلى كلية الآداب لأكمل إجراءات تعييني في القسم الذي لا أزال أعمل به منذ التاسع عشر من مارس سنة 1966، بسبب ذلك الخطاب الذي أرسلته من قرية نائية إلى جمال عبدالناصر طالبا العدل الذي تحقق على يديه".