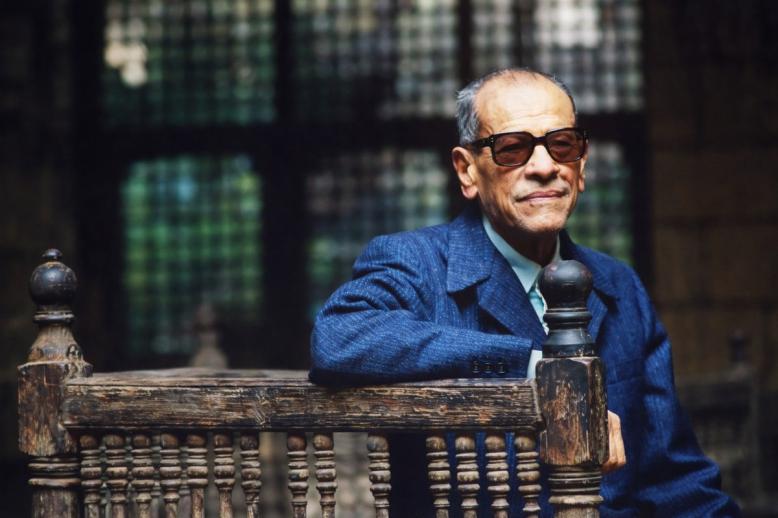حين يقتل الابن الصالح أمه!
"جريمة الابن الصالح" رواية جونج يو جونج أشهر كاتبة لروايات الإثارة النفسية في كوريا الجنوبية هي رؤية نفسية لعلاقة معقدة بين ابن وأمه في إطار من التشويق، ومن خلال راوي "يو جين" غير موثوق به. ففي وقت مبكر من صباح أحد الأيام يستيقظ "يوجين" على رائحة دم غريبة. يدرك أنه مغطى بالدماء، من رأسه حتى أخمص قدميه،وسرعان ما يكتشف جثة أمه المقتولة وسط بركة من الدماء داخل شقتهم الأنيقة. وبسبب نوبات الصرع المتكررة التي عانى منها طوال حياته، يجد "يو جين" صعوبة دائمًا في التذكر. كل ما يتذكره من ليلة الأمس هو صوت أمه ينادي باسمه.
يحتاج "يوجين"إلى بعض الوقت لإعادة توازنه النفسي، يتساءل من أين يأتي كل هذا الدم؟ من الواضح أنه لم يصب بأذى، لكن ماذا حدث في الليلة السابقة؟ عندما يستكشف المنزل، ويجد والدته مطعونة. هل كانت هناك عملية سطو لا يتذكرها؟ ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على أي اقتحام. هل هو نفسه فعل ذلك؟ إنه مرتبك ولا يذكر أي شيء عن الساعات التي سبقت نومه، ويحاول يائسًا سد الثغرات بينما يحاول أيضًا معرفة ما يجب فعله لأن كل شيء يشير إليه باعتباره القاتل. هل يجب أنتختفي جثة أمه، وإلا فمن الواضح أنه سيكون المشتبه به الرئيسي؟ ومع ذلك، يحاول الاستفسار عن جريمة القتل، وبالتالي يبحث في غرفة والدته حيث يجد يومياتها - الملاحظات التي ستكشف له الكثير عن عائلته، وشقيقه، وقبل كل شيء، عن نفسه.
لسنوات يتم علاج يو جين البالغ من العمر ستة وعشرين عامًا من علاج الصرع، للسطرة على النوبات التي بدأت معه منذ الصغر، الأمر الذي أثر بشكل واضح على ذاكرته. على الرغم من معرفته أنه يحتاج إلى دوائه للبقاء على قيد الحياة، يتوقفبشكل دوري عن تناوله. تعرف والدته هذا، وكلما اكتشفت أنه توقف عن تناول حبوبه، تعيده إلى المسار الصحيح وتجبره على تناولها. الآن مع اكتشاف جثتها يعمليو جين على لم شتات ذاكرته حول ما حدث الليلة الماضية. الجواب المنطقي هو أنه فعل هذا، هو قاتل أمه، لكن لماذا يقتلها والدته؟ ما الذي جعلهيفقد عقله؟ هل الأمر نوبة صرع أم أن الأمر أبعد من ذلك؟.
يستخرج يو جين ذكريات من حياته كلها، يقرأ يوميات أمه، يجدها مفتاحًا لمساعدته في كشف الحقيقة، إنه يظهر ظلام العقل البشري وكيف يمكن أن يكون الحب العائلي خطأكارثيا في بعض الأحيان. ومن هنا يركز جزء كبير من الرواية على علاقة يو جين بوالدته. حيث نعرف إن والدته عاملته كوسادة، منعته من الاستمرار في السباحة التنافسية التي أحبها؛ حيث كان يشعر براحة أكبر في المسبح أكثر من أي مكان آخر لأنه "كان المكان الوحيد الذي لا تستطيع الأم الدخول إليه؛ كان عالمي حصريًا". لقد أزعجته، واستجوبته باستمرار حول مكان وجوده، وفرضت عليه حظر تجول بدءا من الساعة 9 مساء، وتناول قرص من الأقراص المنومة التي وصفتها لها خالته مديرة إحدى المصحات النفسية،وسيطرت بشكل صارم على مصروفه، "تضخ أمي خوفًا لا متناهٍ في مجرى دمي".
وأخيرا يبقى أن نشير إلى تطور حبكة الرواية التي ترجمها محمد نجيب وصدرت عن دار العربي تحمل قسوة رائعة كونها كاشفة لاضطرابات وتناقضات النفس الإنسانية. تحليل نفسي لرجل شاب واعد لا يعرف نفسه جيدًا كما كان يعتقد، المشاعر المتناقضة للغاية، والتي تجعل القارئ يتأرجح عاطفيا بين الشفقة والاشمئزاز، بين الأمل في أن يفلت من العقاب وبين ضرورة معاقبته حتى لو كان تصرفه مفهوم ومنطقي تمامًا.
مقتطف من الرواية
أتذكر أنني خلعت ثيابي بمجرد أن وصلت إلى حجرتي ثم استلقيت على الفراش دون أن أغتسل. أتذكر سماع أمي وهي تدلف إلى حجرتها وتغلق الباب. بمجرد أن سمعت تلك التكة، بدأت أستعيد وعيي. بعد ذلك، ربما نظرت إلى أعلى نحو السقف لأربعين دقيقة تقريبًا حتى انتابني الضجر وتسللت عبر الباب المعدني فوق السطح.
"استيقظت للتو، ورأيت أن أمي اتصلت بي في منتصف الليل. اعتقدت أن الأمر غريب قليلًا. يُفترض أن تكون نائمة".ذلك ما قاله "هاي-جين" عبر التليفون. لم أفكر فيما قاله على الإطلاق لكن الآن أتساءل.. لماذا اتصلت به؟ هل لأنني كنت أتصرف بغرابة؟ هل علمت أنني غادرت البيت مجددًا؟ متى اتصلت به؟ في الحادية عشرة؟ منتصف الليل؟ إذا كانت مستيقظة بعد ذلك ببرهة، فهل سمعتني عند عودتي؟ لو كانت قد سمعتني، لم تكن لتتركني وشأني. كانت لتجلسني وتستجوبني بالطريقة ذاتها التي جعلتني أعترف بها بآثامي عندما كنت صغيرًا. لم تكن لتتركني أخلد إلى الفراش حتى أخبرها بكل شيء. "من أين أتيت في هذه الساعة؟ ومتى غادرت البيت؟ منذ متى وأنت تتسلل خارج البيت؟" رغم أنني قد كبرت على العقاب منذ مدة طويلة، لكن لم يكن من المستبعد أن تعاقبني، كانت لتجعلني أركع أمام تمثال مريم العذراء طوال الليل وأتلو صلاة "السلام لكِ يا مريم". لو رأتني الآن، والدم يلطخني هكذا، لم يكن العقاب ليقتصر على الصلوات. لا، حقيقة أنني استيقظت في حجرتي كان دليلًا دامغًا أنها لم تشاهدني بهذه الصورة.
نهضت من الفراش. أحتاج إلى اكتشاف ما حدث. سرت بخطوات قصيرة نحو الباب محترسًا ألا أخطو فوق آثار الأقدام الدموية. وقفت ساكنًا أمام مكتبي. فوق زجاج الأبواب المنزلقة للسطح على مسافة من المكتب، رأيت رجلًا. شعره منتصب كالقرون، ووجهه أحمر ومتيبس، وبياض عينيه يلمع في توتر. كنت شاحبًا. ذلك الوحش الأحمر الوجه هو أنا!
لم أستطع أن أرى أي شيء في الخارج بسبب الضباب الزاحف من المحيط. ومض ضوء أصفر بخفوت من العريشة (الباغودا) التي نصبتها أمي عندما قررت تشييد حديقتها فوق السطح. كنتُ قد أضأت نورها عند مغادرتي ليلة أمس. كان يُفترض أن أطفئه في الطريق إلى الداخل فلماذا لم أفعل؟ لاحظت أيضًا أن الباب المنزلق موارب. من المفترض أن يُقفل آليًّا عند فتحه لذا كلما خرجت إلى السطح، أبقيه مواربًا. كان عليَّ أن أغلق الباب ورائي عندما عدت إلى الداخل. ولم أكن لأفتحه مجددًا مهما كانت حالتي الذهنية: نحن في ديسمبر وحجرتي في الطابق الثاني من شقة ذات طابقين (دوبلكس)، في الدور العاشر من بناية قرب البحر. لم أكن لأرغب في تدفق الهواء البارد إلى الداخل هكذا إلا لو كنت أمي التي كانت تمر بأعراض سن اليأس.
يعني ذلك أنني لم أعد ليلة البارحة عبر هذا الباب، بل عبر الباب الأمامي للشقة. يؤكد ذلك أيضًا وجهة آثار الأقدام، والباب المنزلق المفتوح، وضوء العريشة. لكن لماذا دخلت عبر الباب الأمامي؟ ولماذا أبدو هكذا؟ ماذا حل بحجرتي؟
نظرت ثانية إلى المنبه بجانب سريري. لمعت ثلاثة أرقام حمراء في مقابل الخلفية السوداء: 5:54. لم أسمع صوت جريان المياه لكن أمي ربما لا تزال في الحمام. في غضون عشر دقائق سوف تخرج من الحمام وتدخل المطبخ. يجب أن أتفقد وضع الأشياء قبل أن تذهب أمي إلى هناك.
فتحت بابي، وخرجت إلى الرواق. أضأت النور. امتدت آثار أقدام دامية من عتبة باب حجرتي بطول الرواق حتى السلالم. اتكأت على الباب. الجزء المتفائل في عقلي همس إليَّ: "إنه حلم. إنك لم تستيقظ بعد. من المستحيل أن يحدث شيء كهذا في الواقع".
حملت نفسي على التحرك بعيدًا عن الباب وتتبعت آثار الأقدام مُكرهًا. خطوت نحو أعلى السلالم المعتمة، فبدأ مُشغِل الضوء الآلي العمل. أُضيئت الأنوار فوق السلالم. لطخت آثار أصابع يد دامية الدرابزين، وانطبعت آثار أقدام فوق كل درجة من درجات السلم. نظرت وقد أصابني الدوار إلى الجدار الملاصقة للسلم المبقع بالدم وبرك الدم الصغيرة المتجمعة على أرضية مهبط الدرج. نظرت إلى يدَي وسترتي وبنطلوني وقدمَي المبللة بالدم. هل الدماء التي تغطيني مصدرها الدماء فوق مهبط الدرج؟ من فعل بي هذا؟ داهمني الرعب؛ عجزت عن التفكير أو الاستماع أو الشعور.
مشيت إلى الأسفل ببطء. مررت ببركة الدماء فوق مهبط الدرج ثم استدرت وواصلت هبوط مجموعة السلالم التالية. شهقت؛ ارتد رأسي إلى الوراء وتراجعت. أغمضت عينَي. اقترح ذهني خيارًا مقبولًا: "لا شيء خاطئ. هذا ليس حقيقيًّا. عُد إلى حجرتك قبل أن تخرج أمك. نل قسطًا من النوم. ما إن تستيقظ مجددًا، حتى يكون هذا مثل أي صباح آخر".
لكن الجزء الواقعي في رأسي اعترض. "لا، لا يمكنك تجاهل الأمر. يجب أن تكتشف إذا كان حلمًا أم لا. لو لم يكن كذلك، فيجب أن تكتشف ما حدث بالأسفل ولماذا استيقظت وأنت تبدو هكذا. وإنْ اتضح أنه مجرد حلم، فسيكون أمامك متسع من الوقت لتخلد إلى النوم ثانية".
فتحت عينَي. الأضواء في الأسفل تلمع. تجمعت الدماء بطول الجدار الفاصل. من صاحب هاتين القدمين؟ دمية؟ شبح؟ النظر إليهما من أعلى لم يعطِني أي أجوبة. عليَّ أن أكتشف ما يجري.
ضغطت على أسناني وواصلت التقدم. ثمة دم وآثار أقدام على كل درجة من درجات السلالم؛ نهر الدماء الصغير امتد بطول السلالم حتى حجرة المعيشة. عندما بلغت آخر درجة، كل ما أمكنني رؤيته هو قدمان بشريتان حقيقيتان؛ أصابع أقدام منتفخة، وتقوس كل قدم، وخلخال فيه تميمة في الكاحل الأيسر. بدت القدم مألوفة. انقلبت معدتي، وأصابتني الحازوقة. أردت أن أستدير وأعود إلى حجرتي.
أجبرت نفسي على المتابعة. التفتُّ إلى اليمين في تردد متجهًا إلى الباب الأمامي. كونت الدماء مستنقعًا مستطيل الشكل بداية من المساحة تحت السلالم حتى مدخل المطبخ. تستلقي امرأة بعناية في منتصفه، وقدماها أقرب إلى السلالم بينما رأسها يواجه المطبخ. كانت ترتدي رداء نوم أبيض فضفاضًا. ساقاها مستقيمتان، ويداها متشابكتان فوق صدرها وشعرها الطويل يغطي وجهها. بد المنظر أشبه بهلوسة ذهن مُصاب بالذهان.
خطوت خطوة تجاهها فأخرى. وتوقفت قرب مرفقها. كان رأسها مسحوبًا إلى الوراء وعنقها مذبوح. لا بد أن شخصًا قويًّا قد فعل ذلك بحركة واحدة سريعة مستخدمًا سكينًا حادًّا. كان اللحم حول الجرح أحمر مثل خياشيم سمكة. للحظة ظننت أنه ينبض. التقت عيناي مقلتَين داكنتين من أسفل الشعر المشتبك. أسرتاني وأمرتاني بالاقتراب. أطعتهما. ثنيت ساقيّ المتصلبتين لأجثو بجانبها. مددت يدي ودفعت شعرها بعيدًا عن وجهها. يداي ترتجفان. شعرت كأنني أرتكب جريمة.
- " يو-جين!"
صوت أمي مُجددًا، الصوت نفسه الذي سمعته في حلمي. هذه المرة بدا خافتًا. عجزت عن التنفس. كل شيء في ذهني يتداعى؛ سبح كل شيء أمام عينيّ. لم يقوَ عمودي الفقري على حملي وانزلقت فوق الدم. جلست بتثاقل، واتكأت على يديّ لأمنع نفسي من السقوط.
جحظت عينا المرأة الأشبه بعيني قطة مصدومة. تدلت قطرات دم من رموشها الداكنة الطويلة. خداها نحيلان وفكها بارز وقد فغرت فاهها. أمي. المرأة التي فقدت زوجها وابنها الأكبر قبل ستة عشر عامًا، والتي تعلقت بي، وبي فقط منذ ذلك الوقت، المرأة التي أعطتني حمضها النووي.
أظلم كل شيء. شعرت بالإعياء. لم أستطع الحركة. لم أستطع التنفس كأنَّ رملًا ساخنًا يملأ رئتيّ. كل ما بوسعي فعله هو انتظار أن يُضاء النور في دماغي المعتم. أردت أن يكون كل هذا حلمًا؛ أردت أن تدق ساعتي الداخلية حتى توقظني، وتشدني خارج عالم هذا الكابوس. زحف الزمن. كل شيء هادئ على نحو بارد. بدأت ساعة الجد البندولية في الرنين؛ الساعة السادسة. مضت ثلاثون دقيقة منذ استيقاظي. هذا هو التوقيت الذي تتوقف فيه عادة الجلبة التي تحدثها أمي في المطبخ، وتتجه صاعدة إلى حجرتي وهي تحمل مشروبًا من الحليب والموز والصنوبر والجوز.
توقفت الساعة عن الرنين لكن أمي لا تزال ترقد بجواري. أكان حلمًا في نهاية المطاف؟ هل نادت أمي عليّ ليلة الأمس؟ أكانت تنادي طلبًا للمساعدة؟ أم كانت تتوسل من أجل حياتها؟