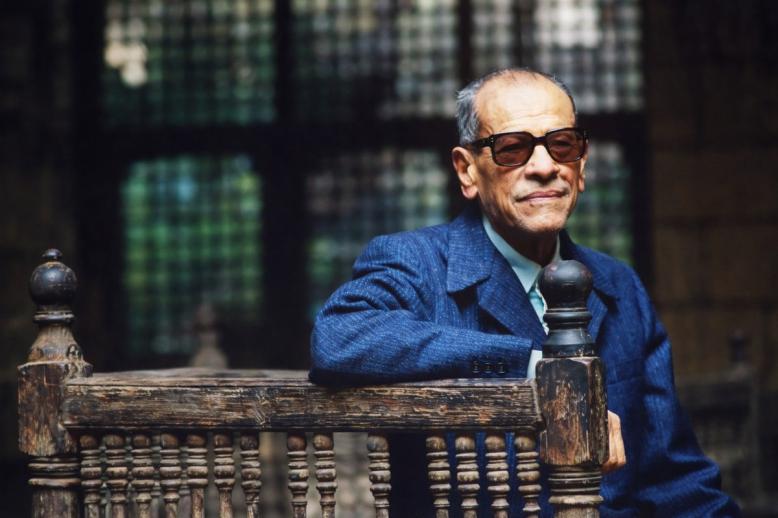محمّد عبده من الثّورة إلى الإصلاح
ممّا لا شكّ فيه أن الشيخ محمد عبده حسن خير الله، المولود بقرية محلة نصر بمركز شبراخيت من أعمال مديرية محافظة البحيرة عام 1849 والمتوفّى عام 1905، أحد أهم زعماء الإصلاح الديني في العصر الحديث، فقد أثار في حياته من القضايا وطرح من الإشكالات ما جعله يتبوّأ صدارة الفكر الإسلامي الحديث، على الرغم من أن شيوخ الأزهر التقليديين هاجموه وحاربوا دعوته، في وجود فئة أخرى ممّن يُسمَّون بالتنويريّين ناصروه وقاسموه الأفكار والرّؤى والغايات.
تلقّى الشيخ تعليمه الأوّل بالقرية فحفظ القرآن، وذهب إلى الجامع الأحمدي بطنطا ليحضر دروس تجويد القرآن، غير أنّ أساليب التدريس التقليدية والعقيمة في الجامع الأحمدي صدّته عن متابعة الدرس، فقفل راجعًا إلى بلدته ليتزوج، وقد عقد العزم على العمل في الزراعة مع والده وإخوته، غير أنّ الوالد رفض ذلك وألحّ عليه في العودة إلى الجامع الأحمدي عام 1865، ثم التحق بالأزهر عام 1868، وكان في الأزهر يومها حزبان: حزب محافظ تقليدي وحزب صوفي أقل محافظة، فانضمّ الشيخ إلى الحزب الصوفي.
ثم حدث الأهم في حياته بلقائه بالسيد جمال الدين الأفغاني الذي كان يزور مصر للمرة الثانية عام 1871، فودّع الشيخ محمد عبده دروس الأزهر العقيمة ولازم أستاذه الذي كان حربًا على الاستبداد والاستعمار والتقليد، وسبّب له هذا المضايقة والمطاردة من قبل جواسيس الشرق والغرب حيثما حلّ وارتحل. وقد انتقل الأفغاني بتلميذه من الزهد والتنسك إلى الفلسفة الصوفية. وبسبب حربه على الشيوخ التقليديين ونقده لأساليب التدريس العقيمة ودعوته إلى التجديد والاقتباس من العلوم الغربية الحديثة، كاد أن يسقط في امتحان العالمية عام 1877 التي نالها من الدرجة الثانية بإصرار من رئيس اللجنة، ولولاه لسقط.
وواضح مدى الخصومة والبغض الذي كان يكنّه شيوخ الأزهر التقليديون للشيخ، فقد رموه بالمروق وربما العمالة. ومن جهة أخرى، لم يكن الشيخ محمد عبده في نقده لعقم التعليم الأزهري وطرائقه التقليدية التي عفا عليها الزمن يدّخر جهدًا، فتارة يهاجمهم بالمقالات النارية، وتارة أخرى بالشعر الممعن في السخط والمرارة على شاكلة قوله:
لو كان هذا وصفهم ما شنّعوا
بل وقتهم في جاء زيد ضيّعوا
لقد كان لقاء الشيخ محمد عبده بالأفغاني فاتحة خير عليه، فالأفغاني الفيلسوف الذي جاب الشرق والغرب واتصل بالفلسفة والفكر الغربيين، ورأى ما وصل إليه الغرب من نهضة وما يقبع فيه الشرق من تخلّف واستبداد، حمل على المستبدين والمستعمرين الذين أدرك مطامعهم في اقتسام خيرات العالم العربي والسيطرة عليه. وفي الوقت نفسه، لم يرفض الغرب جملة وتفصيلًا، فقد دعا إلى الأخذ بالعلوم وإصلاح الفكر الديني بجعله مواكبًا لقضايا العصر، ولا فائدة من الاجترار من القديم الموروث. وهذا ما جعل الشيخ محمد عبده يقول عن أستاذه: "إن والدي أعطاني حياة يشاركني فيها أخواي علي ومحروس، والسيد جمال الدين أعطاني حياة أشارك بها محمدا وإبراهيم وموسى وعيسى والأولياء والقدّيسين".
انخرط الشيخ محمد عبده في بعض التنظيمات السياسية، فدخل الماسونية كما فعل أستاذه، ولم تكن الماسونية يومها سُبّة ولا مما يُؤاخذ به المرء، فقد حملت لواء الدعوة إلى فكر الأنوار والمناداة بالمساواة ونبذ الفرقة الدينية والاحتراب لصالح التعاون المثمر بين البشر. ولم تكن الصهيونية يومها قد ظهرت للعيان، غير أن الأفغاني ومحمد عبده تخليا عن الماسونية وأعلنا خروجهما منها لما علما بصلتها بالاستعمار ومهادنتها للإنجليز وللاستبداد، ودخل مع الأفغاني في الحزب الوطني الحر الذي كان شعاره "مصر للمصريّين".
انضمّ الشيخ محمد عبده إلى العرابيّين، وبعد فشل الثورة سُجن ثلاثة أشهر ثم نُفي إلى بيروت ليستمرّ النفي ست سنوات. ومن هناك واصل دعوته إلى الإصلاح وتجديد الفكر الديني عبر المقالات التي كان ينشرها في الوقائع المصرية، ثم دعاه الأفغاني إلى باريس حيث تعاونا على إصدار "العروة الوثقى" وأصدرا منها 18 عددًا.
لقد راجع نفسه في باريس، فهو من جهة يؤمن بضرورة التجديد والإصلاح وتحمّل الكثير من نقد الشيوخ، ثم انضم إلى الثورة العرابية، فلما فشلت تحمّل النفي، مما جعله يُعرض عن العمل السياسي ويتوجّه إلى الإصلاح بتبنّي نشر العلم والدعوة إلى الفضيلة والتحلّي بالأخلاق، لينشأ جيل متمسك بدينه، يتحلّى بالأخلاق، مطّلع ومستفيد مما في الغرب من علم وفكر. بينما كان الأفغاني ثائرًا جريئًا يدعو إلى حرب الاستبداد والاستعمار معًا، وهذا الخلاف بين منهج محمد عبده وأستاذه الأفغاني دفع الشيخ إلى ترك أستاذه والعودة إلى بيروت مدرّسًا بالمدرسة السلطانية، وليبدأ في تفسير القرآن بأسلوب عصري، ويتزوج ثانية بعد وفاة زوجته الأولى، ثم يعود إلى مصر ليُعيّن قاضيًا ببنها، ثم بمحكمة الزقازيق، ثم بمحكمة عابدين، كما بدأ يُلقي دروس التفسير بالأزهر بأسلوب عصري لمدة ست سنوات.
وفي هذه الفترة شهدت قريحته خصبًا وقلمه عطاءً من خلال الفتاوى التي كان يصدرها، والأحاديث التي كان يدلي بها للصحف والمجلات، والكتب التراثية التي حققها أو شرحها كـ"دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" و"شرح مقامات الهمذاني" و"الرد على هانوتو المتعصّب". وفي عام 1899 عُيّن مفتيًا للديار المصرية ليتوفّى بعدها بالإسكندرية عام 1905.
إنّ السياق التاريخي والثقافي الذي تأثّر به الشيخ محمد عبده وأثّر فيه كان يتميّز بتيارين كبيرين: أولهما تيار التقليد والجمود والاجترار من الماضي وإدارة الظهر لمستجدات العصر وغلبة الفكر الفقهي على الفكر العلمي والفلسفي، والتيار الثاني التغريبي الذي يحمل على الثوابت والأصول ويدعو إلى الاقتداء بالغرب. فوقف الإمام موقف الوسط، منكرًا على الأولين جمودهم وعلى الآخرين تطرّفهم، فهو يدعو إلى تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، مع إصلاح أساليب اللغة العربية بطرح الأسجاع والأساليب الجامدة، ثم التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب، وما للشعب من حق العدالة على الحكومة، فقال: "ولقد خالفت في ذلك رأي الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسد الأمة: طلاب علوم الدين ومن على شاكتهم، وطلاب فنون العصر ومن هو في ناحيتهم".
وقد شجّع محمد عبده على المضيّ قدمًا في دعوته ما عُرف عنه من إخلاص وزهد في حطام الدنيا، وعلم غزير، ثم رباطة الجأش والاعتزاز بالذات والإيمان بالحرية، حتى إن السيد جمال الدين كان يقول له: "قل لي بالله، أيّ أبناء الملوك أنت؟"، كما أُثر عن الخديوي عباس قوله عنه: "ألا إنه يدخل عليّ كأنه فرعون".
كان الشيخ لا يفتأ يردّد: "يجب تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، والنظر إلى العقل باعتباره قوة من أفضل القوى الإنسانية، بل هي أفضلها على الحقيقة". وهذا معناه تقدير الذات وعدم إضفاء القداسة على آراء الأقدمين والاحتفاء بمنجزات العصر دون التنكّر للأصول والثوابت، فليس للشراح سطوة، ولا يوجد في الإسلام رئاسات دينية. وهو يرفض الإيغال في تحميل القرآن فوق ما يحتمل في كونه ديوانًا للعلوم، وهو في هذا قريب من المعتزلة، إذ يقول: "ليس في الإسلام سلطة دينية، وأصل من أصوله قلبها والإتيان عليها من أساسها، والخليفة حاكم مدني من جميع الوجوه، لكن الإسلام دين وشريعة، ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وُجدت قوة لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وصون نظام الجماعة".
كان الشيخ الإمام من أنصار الجامعة الإسلامية أسوة بأستاذه الأفغاني، ولم يكن من دعاة إنهاء الخلافة لأنه يدرك مطامع الاستعمار، وبدلًا من ذلك دعا إلى إصلاحها، فالجمود التركي انعكس سلبًا على العالم العربي. وفي الإضراب الشهير الذي امتد من 1899 إلى 1900، والذي خاضه عمال لفّ السجائر، وقف ضد أطماع الرأسماليين ودعا إلى تدخل الدولة حمايةً للعمال وإنصافًا لهم من الظلم الاقتصادي.
وربما كان قاسيًا في نقده لشيوخ الأزهر إلى درجة استخدام ألفاظ قاسية، كقوله: "إن كان لي حظ من العلم الصحيح الذي يُذكر، فإني لم أحطّه إلا بعد أن مكثت عشر سنين أكنس من دماغي ما علق فيه من وساخة الأزهر، وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريد له من النظافة".
إن الرسالة التي اضطلع بها تتلخّص في الإصلاح الديني والإصلاح اللغوي بجعل اللغة خادمًا للفكر، متحرّرة من التكلف والأسجاع، متوجّهة إلى المضمون والمعنى مع احترام قواعدها وأصولها، وقد كتب: "إن الأسلوب المليء بالمحسنات اللفظية يُعدّ – في اللسان العربي – أدنى طبقات القول، وليس في حُلاه المنوطة بأواخر ألفاظه ما يرفعه إلى درجة الوسط". وقد دفع ذلك الشيخ إلى القيام بتحقيق كتب أدبية ولغوية مساهمةً منه في الإصلاح اللغوي.
أما الإصلاح السياسي، فقبل أن يهجر السياسة ويقصر نشاطه على التجديد الديني واللغوي، جعله البعض يتّهم بمهادنة الاستعمار بدليل صداقته مع كرومر، لكن الشيخ كان قد استقرّ رأيه على أن سبيل الإصلاح هو نشر التعليم والأخلاق لينشأ جيل جديد تختفي معه تلقائيًا علل التخلّف والانحطاط والرجعية والفساد الخلقي. غير أن هذا الرأي يصطدم بمعارضة الراديكاليين الذين يرون في النضال السياسي ضرورة ضد الاستبداد والاستعمار، لأن هدف التغيير لا يتحقق لمجرد نشر العلم والفضيلة، ولمجرد قول الشيخ الإمام: "من يريد خير البلاد فلا يسعى إلا في إتقان التربية، وبعد ذلك يأتيه جميع ما يطلبه بدون تعب فكر ولا إجهاد نفس".
كما ركّز الشيخ الإمام على قضية الأسرة، فالأمة كما يقول: "تتكوّن من البيوت (العائلات)، فصلاحها صلاحها، ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة. الرجل والمرأة متماثلان في الحقوق والأعمال والذات والشعور والعقل، أما الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة في بيوتهم، فإنهم إنما يلدون عبيدًا لغيرهم".
وفي قضية المرأة، ناصر الشيخ الإمام دعوة قاسم أمين، وأصدر فتاوى أثارت جدلًا وربما اعتراضًا من قبل الكثيرين، فهو أفتى بحق المرأة في التعلّم، كما أفتى بتقييد طلاقها، وأفتى بمنع تعدّد الزوجات إلا في حال كون الزوجة عقيما. وهذه الفتوى الأخيرة لم تُعجب الكثيرين ممّن يرون أنه من حق الذكورة الاستمتاع بالأنوثة بلا قيد أو شرط مثنى وثلاث ورباع، مع ما يلحق المجتمع من ضرر نتيجة سعي الرجل وراء نزواته.
وعلى الرغم من الرحيل الباكر، فقد ملأ الشيخ الأستاذ الدنيا علمًا وجدالًا بالحسنى، ودينًا وأخلاقًا وجهادًا بالكلمة والموقف. وقد كان العالم العربي في حاجة ماسة إلى فكر تنويري وثورة على التقليد والاجترار والإمعيّة، وعلى الظلم واضطهاد الإنسان للإنسان. والعالم الغربي قد قطع أشواطًا في تمدّنه وفي فتوحه العلمية ومخترعاته الكثيرة، فهل يبقى العالم العربي فريسة للتقليد ودفن الرأس في الرمل، مؤثرًا ترديد الآية: "كنتم خير أمة أخرجت للناس"، والتمادي في إطلاق صفة الكافر على الغرب؟ وهذا "الكافر" هو الذي جاب أقطار السماوات وحقق المنجزات العلمية والفتوح المعرفية والمخترعات التي يسّرت الحياة وجعلتها سهلة وبديعة.
إنّ دراسة فكر الشيخ محمد عبده وعطائه اليوم ضرورة ملحّة، فما زال فكره قادرًا على الإجابة عن أسئلة العصر وإشكالات الراهن دون تقديس أو تمجيد، وهو ذاته كان ضد التقديس، محررًا الذات من قصورها وعجزها وإحساسها بالدونية، لتتمكّن من الإسهام في حضارة العصر والمشاركة الإيجابية فيها.