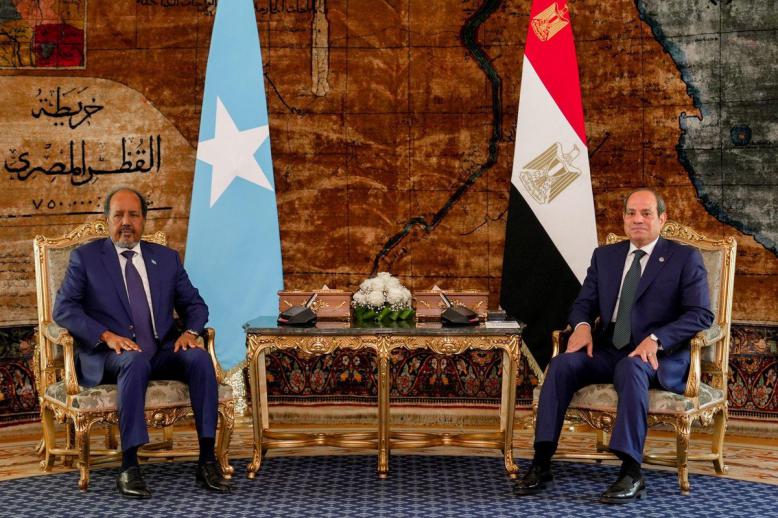حين تسقط الأقنعة… أزمة الثقة بعد فضيحة إبستين
في البداية لم أُصدّق ما كُشف في فضيحة جيفري إبستين، لا لأن الوقائع مستحيلة، بل لأن العقل أحياناً يعجز عن استيعاب الحقيقة حين تكون صادمة بهذا الحجم. غير أن ما تلا الفضيحة كان أخطر من تفاصيلها نفسها، إذ فتح باب الشك في منظومات كاملة طالما قُدِّمت بوصفها حامية للقيم والحقائق.
لم تكن فضيحة جيفري إبستين حدثاً أخلاقياً عابراً، بل لحظة كاشفة لانهيار صورةٍ طالما قُدِّمت عن عالم تحكمه القيم والقوانين. فالصدمة لم تكن في الجريمة وحدها، بل في شبكة الصمت التي أحاطت بها، وفي الأسماء النافذة التي مرّت دون مساءلة. هنا، لم تهتزّ حادثة بعينها، بل اهتزّت الثقة كنظام.
الرفض الأولي لتصديق ما كُشف لم يكن إنكاراً، بل عجزاً ذهنياً عن استيعاب حجم التواطؤ، فالعقل يميل إلى حماية قناعاته حين تتعلق بمفاهيم كبرى مثل العدالة وحقوق الإنسان. غير أن قبول الحقيقة في هذه الحالة يعني الاعتراف بأن من يرفعون شعارات القيم قد يكونون أول من ينتهكها.
من هذه اللحظة، لم يعد الشك موجهاً إلى الأفراد، بل امتدّ إلى المؤسسات والسرديات الكبرى: حقوق الإنسان، المنظمات الدولية، الخطاب الطبي، وحتى التكنولوجيا. فإذا أمكن التلاعب بالحقيقة في ملف واحد، فما الذي يضمن سلامة بقية "الحقائق" التي اعتُبرت طويلاً من المسلّمات؟
غير أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الشك ذاته، بل في تحوّله إلى حالة شاملة تُسقط كل المرجعيات. ففساد الممارسة لا يعني بطلان المبدأ، وتسييس القيم لا يلغي ضرورتها. المشكلة ليست في حقوق الإنسان، بل في انتقائيتها، وليست في العلم، بل في إخضاعه للمال والسياسة.
أزمة الثقة هذه ليست بريئة دائماً. إنسان فاقد الثقة بكل شيء هو إنسان أقل ميلاً للمساءلة، وأكثر قابلية للإنهاك أو الانسحاب. وهنا يتحوّل الشك غير المنضبط من أداة وعي إلى أداة شلل.
ما نحتاجه اليوم ليس العودة إلى السذاجة، ولا الارتماء في الارتياب، بل وعي نقدي هادئ يميّز بين الحقيقة واستغلالها، وبين القيم ومن يتاجر بها. فبعد سقوط الأقنعة، لا يبقى أمامنا إلا إعادة بناء الثقة على أساس المعرفة لا التقديس، وعلى النقد لا الإنكار.