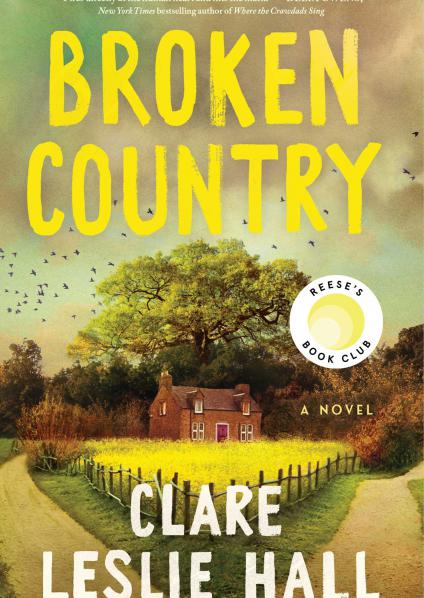بذور الماضي وحصاد الندم في خريف 'بلاد مكسورة'
تنتمي بعض الروايات إلى ذلك الصنف الذي لا يُقرأ بوصفه حكاية فحسب، إذ يُختبر بوصفه تجربة داخلية تعيد تشكيل علاقة القارئ بذاكرته ووعيه؛ كأن النص لا يكتفي بأن يمر عبر السطح الإدراكي، وإنما ينفذ إلى طبقاته السفلى، إلى تلك المساحات التي وصفها مارسيل بروست بالذاكرة غير الإرادية، حيث يقيم الماضي لا باعتباره ما انقضى، بل بوصفه ما ظلّ عالقا، غير مُحلّ، وقابلا للانبعاث في أي لحظة.
من هذا المنظور، لا يعود النص مجرد ناقل للأحداث، ليغدو مرآة للذاكرة الحية، وفأسا صامتة تشق الأرض الداخلية ببطء، تعيد ترتيب طبقات الشعور، وتضع القارئ في مواجهة مباشرة مع وعيه، في تجربة لا تقوم على استهلاك المعلومة بقدر ما تقوم على اختبار الزمن بطريقة غير خطية، حيث تستعاد لحظات الحياة الماضية لا كما كانت، وإنما كما تركت أثرها العميق.
ضمن هذا الأفق تحديدا تندرج رواية "بلاد مكسورة" (Broken Country) لكلير ليزلي هول، بوصفها نصا لا يشرح العالم بقدر ما يُربكه، ولا يطمئن القارئ إلى مسلّماته، قدر ما يزجّ به في نسيج الذاكرة غير الإرادية، ويجعله جزءا من خيوطها، واضعا تلك المسلّمات موضع مساءلة هادئة ومستمرة.
منذ العنوان، تتكشّف الرواية بوصفها استعارة كبرى. "بلاد مكسورة": ليست مجرد فضاء زراعي أنهكته الظروف؛ إنها صورة كثيفة للذات البشرية حين تتعرّض للصدع. يستدعي هذا العنوان، من حيث لا يدري القارئ، تقاليد أدبية طويلة جعلت من الأرض مرآة للروح: من حقول توماس هاردي في "تِس سليلة دربرفيل"، حيث الطبيعة شاهدة صامتة على القسوة الأخلاقية للمجتمع، إلى أراضي فوكنر الجنوبية التي تخزّن الذنب جيلا بعد جيل.
الأرض هنا لا تُزرع فقط؛ إنها تتحمل الذاكرة. هل يمكن أن نفهم الأرض بوصفها كيانا أخلاقيا، يختزن الضمير كما يختزن الماء؟ هل تحمل التربة الصمت والجريمة والندم، كما تحمل البذور؟ تدفعنا الرواية إلى التساؤل عن العلاقة بين الإنسان والأرض، وعن حدود المسؤولية الأخلاقية في مواجهة ما هو أكبر منا وأكثر رسوخا من إرادتنا.
تنطلق الرواية من حادثة موت، ومن محاكمة، ومن سؤال يبدو قانونيا في ظاهره: جريمة أم حادث؟ غير أن هذا السؤال، كما في الكثير من الروايات الكبرى، ليس سوى قشرة خارجية. فكما في "الغريب" لكامو، لا تكمن المأساة في الموت نفسه؛ المأساة فيما يكشفه من هشاشة المعنى ومن تصدّع اليقين الأخلاقي. يعمل الحدث الجنائي في "بلاد مكسورة" كمكشاف يسلّط الضوء على ما كان مطمورا تحت طبقات الصمت والاختيارات المؤجَّلة.
في هذه اللحظة، يبرز سؤال فلسفي عميق: إلى أي حدّ يصبح الصمت شكلا من أشكال المشاركة، لا مجرد غياب للفعل؟ وهل يمكن تبرئة الضمير من مسؤولية ما كان يمكن منعه ولم يُمنع؟ لا تقدّم الرواية إجابات جاهزة؛ إنها تضع القارئ أمام مسؤولية التأمل في هذه المسائل.
في دورسِت (إنكلترا)، تتشكّل حياة بيث بوصفها حياة مفروضة أكثر منها حياة مختارة بالكامل. يبدو زواجها من فرانك، من الخارج، شبيها بتلك الزيجات التي وصفها فلوبير في "مدام بوفاري": زواج الاستقرار، لا زواج التوق. غير أن بيث ليست إيما بوفاري؛ فهي لا تهرب عبر الوهم، إذ تواجه واقعها بوعي موجع. حبّها القديم لغابرييل وولف، الذي عاد بعد سنوات وقد صار كاتبا مشهورا، يذكّرنا بتلك العودات القدرية التي تملأ الأدب: عودة الماضي لا بوصفه ذكرى، ولكن كسؤال أخلاقي حيّ، كما في "الحب في زمن الكوليرا"، حين يثبت الحب أنه لا يشيخ، لكنه يغيّر شكله ويضاعف ثمنه.
هنا يظهر سؤال الوجودية: هل يحدد الماضي الحاضر، أم أن الحاضر قادر على إعادة تشكيل الماضي؟ وكيف يمكن للإنسان أن يعيش بين الذكريات التي تعيش فيه وبين القرارات التي يصنعها يوميا؟ تجعل الرواية القارئ يختبر التوتر بين الحرية والمسؤولية، بين ما يمكن فعله وما لا يمكن تغييره.
تخلق البنية المتعدّدة الأصوات في الرواية ما يشبه البوليفونية التي تحدّث عنها باختين عند تحليله لروايات دوستويفسكي. لا صوت يمتلك الحقيقة كاملة، ولا ذاكرة تخلو من الشقوق. ليس القارئ هنا متلقيا؛ إنه قاض متردّد، يعيد جمع الشهادات، ويكتشف أن العدالة السردية أكثر تعقيدا من العدالة القانونية. في هذا، تذكّرنا الرواية برواية "أن تقتل طائرا بريئا" لهاربر لي، حيث لا تكون المحكمة دائما المكان الذي تُستعاد فيه الحقيقة؛ إنها المكان الذي تنكشف فيه حدودها.
هل يمكن أن نثق بالعدالة حين تكون الحقائق متعددة، والمتناقضات جزءا من الواقع نفسه؟ تضع الرواية هذا السؤال أمامنا بلا إجابة، وكأنها تقول: "ليس العدل نتيجة؛ إنه عملية مستمرة من البحث والتساؤل".
ليس الزمن في "بلاد مكسورة" خطّا مستقيما؛ إنه تربة طبقية. لا يُفهم الحاضر إلا عبر العودة إلى خمسينيات القرن الماضي، إلى زمن البراءة المشروخة. يعيد هذا البناء الزمني إلى الذهن روايات الذاكرة الكبرى، من "مئة عام من العزلة" حيث الماضي لا يمضي أبدا، إلى "البحث عن الزمن المفقود" حيث لا تكون استعادة الماضي فعلا إراديا؛ إنها صدمة حسّية. هنا، كما هناك، ليست الذاكرة سردا؛ إنها تجربة جسدية تقريبا.
ليست الطبيعة في الرواية خلفية؛ إنها فاعل أخلاقي. العمل الزراعي، وتكرار الفصول، ومنطق الزرع والحصاد، كلّها تضع الشخصيات داخل إيقاع يتجاوزها. ذكّرني هذا البعد بأعمال ويندل بيري أو حتى جون شتاينبك في عناقيد الغضب، حيث الأرض ليست ملكا للإنسان؛ الإنسان هو مِلْكها، يخضع لقوانينها القاسية والعادلة في آن واحد. يكاد يكون السؤال الذي تطرحه الرواية هنا فلسفيا: إذا كنّا نحصد ما نزرع، فكيف نحاسب أنفسنا على ما نما فينا دون قصد؟
يقف فرانك، المزارع، في تقاطع مأساوي بين الواجب والرغبة، بين ما يجب فعله وما لا يقال. في صمته وثقله الداخلي، ثمة صدى لشخصيات ذكورية تراجيدية عرفناها في الأدب، من رجال كازو إيشيغورو الذين يكتشفون متأخرين أن حياتهم كانت سلسلة من التنازلات الصامتة -تنازلات لم تُفرض بالقوة، بل قُدِّمت طوعا تحت ستار الأدب والواجب- إلى أبطال إبسن الذين يثقل العبء الأخلاقي حياتهم. تعرف الأرض التي يديرها فرانك أكثر مما يعرف؛ إنها تحتفظ بأسرار لم تُمنح اللغة بعد.
أما بيث، فهي القلب النابض للنص. لا يفرض صوتها نفسه؛ إنه يتشكّل عبر التفاصيل الصغيرة، عبر المراقبة، وعبر العلاقة الحميمة مع المكان. هي قريبة، في هذا، من شخصيات آن كارسون أو فيرجينيا وولف، نساء يفكّرن أكثر مما يصرخن، ويقاومن لا بالفعل الصاخب، وإنما بالوعي. حضورها في المحكمة، وهي تراقب محاكمة الرجل الذي أحبّته، يعيد إلى الأذهان سؤال حنة آرنت عن الفرق بين الحقيقة القانونية والحقيقة الوجودية: أيّهما أصدق؟ وأيّهما أعدل؟
تتشابك الثيمات الكبرى للرواية -الذاكرة، الذنب، النسب- من دون أن تتحوّل إلى شعارات. الذاكرة هنا مكان مسكون، كما في روايات باتريك موديانو؛ لا يمكن الوثوق به تماما، ومع ذلك لا غنى عنه. ينتشر الذنب في الفضاء كهواء ثقيل، يذكّرنا بذنب العائلات في روايات الجنوب الأميركي أو في التراجيديات الإغريقية، حيث لا ينتمي الخطأ لفرد واحد؛ إنه يتوزّع. أما النسب، فيُعاد تعريفه خارج البيولوجيا، كما فعلت توني موريسون مرارا: من نحبّهم هم من يصنعون سلالتنا الحقيقية.
بين 1955 و1968، تُقرأ الرواية قراءة جيولوجية للزمن، كأنها تنبش طبقاته المتراكمة لا لتكشفها دفعة واحدة، ولكن لتبيّن كيف تترسّب الحياة: طفولة، نضج، قرارات متجذّرة لا يمكن اقتلاعها دون ألم. يتجنّب أسلوب كلير ليزلي هول الافتعال، ويقترب من ذلك "الاقتصاد العاطفي" الذي تحدّث عنه تشيخوف: لا شيء يقال أكثر مما ينبغي، ولا شيء يُشرح أكثر مما يجب. ليس الصمت هنا فراغا؛ إنه معنى مؤجّل.
هنا يظهر السؤال الفلسفي المركزي: هل يمكن للإنسان أن يعيش في وعي مستمر بالماضي دون أن يفقد نفسه في الحاضر؟ وهل يمكن للذاكرة أن تكون مرشدا من غير أن تتحول إلى عبء لا يطاق؟ تجعل الرواية القارئ يقف عند حافة هذه التأملات، وكأنها تقول إن فهم الذات مرتبط بفهم الأرض والزمن معا، وأن كل تجربة إنسانية تنبني على ترسّبات لا يمكن تجاهلها.
تتركنا رواية "بلاد مكسورة" أمام فكرة شديدة القسوة وشديدة الجمال في آن واحد: أحيانا، لا تنبت الحياة الجديدة إلا بعد أن تُكسَر التربة القديمة. كما كتب ريلكه: "العيش بالأسئلة هو الطريق الوحيد إلى الحقيقة".
لا تمنح هذه الرواية أجوبة؛ إنها تهبنا أرضا أُعيد شقّها، وتدعونا إلى أن نجرؤ على الزرع من جديد، ونحن نعرف مسبقا أن الحصاد لن يكون كاملا، غير أنه سيكون -على الأقل- صادقا.
إنها دعوة للتفكير في الأخطاء، في الفقد، في القرارات المؤجلة، وفي الجروح القديمة، مع إدراك أن إعادة البناء لا تصبح ممكنة إلا بعد مواجهة كل هذه الطبقات، وفهم أن السلامة النفسية تأتي عبر الاعتراف بالأرض التي نحيا عليها، سواء كانت رمزية أم حقيقية. الرواية، بهذا المعنى، ليست مجرد نص روائي؛ إنها تجربة وجودية كاملة: تجربة في الزمن، في الوعي، في الأخلاق، وفي العلاقة مع كل ما نحب وما نخاف أن نفقده.