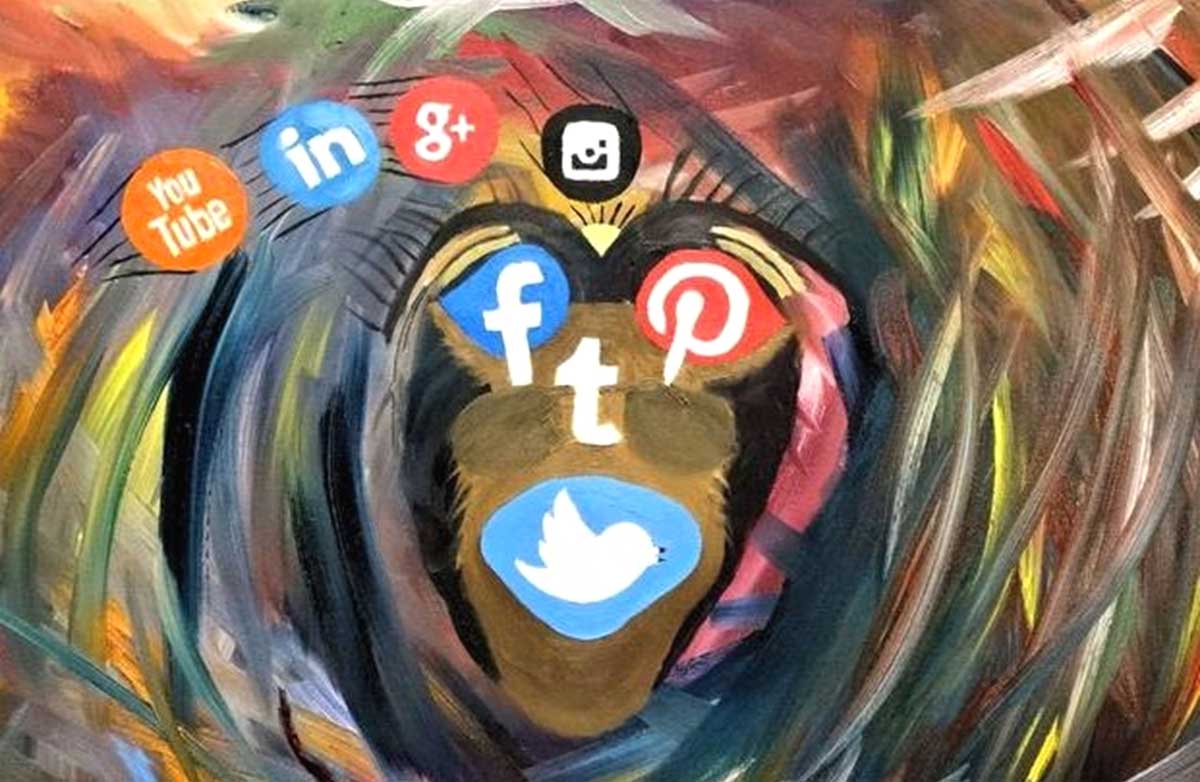تدوينات ثقافية
مفهوم "المثقف"
ظل مفهوم المثقف مفهوماً إشكالياً ومتقلباً حيث يتحدد وفق زاوية النظر إليه والحقل المعرفي الذي ينطلق البحث منه وكذلك عبر الزمن والحقبة المعرفية التي تزدهر وقت وضعه في دائرة الضوء، وهكذا تفاوتت التعريفات وتباينت بين المفكر أو الأديب أو الأكاديمي أو المهموم بالفعل الثقافي بشكل واسع وكذلك كل من اكتسب مهارات معينة تساعده على التكيف مع محيطه والتأثير في الآخرين من حوله بشكل غير محدد ومنفتح ومرن أو ذلك الذي يبذل جهدًا فكريًّا لفهم الذات والآخر والأحوال ينتج عنه تحليلات تخلف طرقاً ومناهج تقرأ الظواهر وتفككها وتقترح مسارات للتعاطي الخ الخ.
كان ذلك المثقف يحاول النظر المتعمق لاكتشاف هويته الثقافية ومن ثَمَّ إظهارها للآخرين والترويج لها متلبساً دور البوصلة والضمير والحافظ للقيم منطلقاً من نظرة تميل إلى الحِكَمية ربما، لكن الأمور ظلت تختلف يوماً عن يوم من المفهوم العضوي المشتبك الذي تراه في أول الصفوف بالقول والفعل إلى ذلك الذي يشبه الكثيرين ويمتح من مصادر تشبه مصادرهم، وهي التي أتاحتها ثورة الاتصالات ومجتمع المعرفة وقيم التجاور التي ترسخها ما بعد الحداثة لا ميزة ضخمة ولا فارقة يملكها أحد عن الآخر ولو كان باحثاً أو مفكراً لكن حتى وإن خفتت نبوية المثقف وبريقه ونزل من برجه العاجي يظل إنساناً مميزاً ومهموماً بالآخرين ولا يخايله إلا سؤال المستقبل.
شعراء الفيسبوك
كان لإنسان الكهوف تصاوير وتهويمات شعرية ثم تَمَشَّى الشعر مع الإنسان عبر سنواته الطويلة ملازماً ومصاحباً فريداً، ولأن الشعر كائنٌ يدرك حتمية مرونته كان لا بد أن يبدل مراياه كل فترة، الشعر الذي يتوق للحرية بعد حبسه طويلاً في الذاكرة أو على الأحجار أو على الورق ارتاح للواقع الافتراضي الذي يتماهى معه من زاوية مخاتلته ومروره الضوئي بين الأنواع والأشكال والمشاعر، وبهذا أتاح الفيسبوك لشعراء كبار أن يصلوا لأجيال وجغرافيا كانت بعيدة مثل نصيف الناصري وصلاح فائق وأتاح لشعراء غائبين أن تحفزهم فكرة التدوينات اليومية فعادوا إلى تجاربهم أو طوروها كما أدخل شعراء صغاراً مضمار التجربة بلعبة التفاعل، وفي المجمل أعاد ترتيب وتصنيف الأجيال وكَشَفَ وأضاف ونَقَضَ وأعاد هيكلة مشهد الشعر العربي ونَكَزَ أسئلة الشعر الدائمة بشكل أكثر حيوية، وبشكل طبيعي هناك خواطر وكتابات لا تصمد أمام الفرز الدائم والمستمر كما أن هناك غثا يَثْبُتْ كعظيم ولكن وسط أشباهه. هذا عكاظٌ عصريٌّ لا تغيب عنه القصة لكنها تظهر كَظِلٍ للشعر الأسرع في التلقي والولوج إلى الروح والذي سيحكي دائماً عن رسوخ موقعه في الثقافة والوعي والذاكرة.
نجيب محفوظ
هو منذ البداية لم يكن بعيداً ففي مرحلة القراءة الوحشية التي كان عليها الفتى الذي كنتهُ لا أظن أنني بذلت جهداً لأصطفيه رغم أني أكملت قراءة مجايليه بالكامل كالتزام وضعته لنفسي ربما للهروب من إحساس بالذنب بعدما وضعته في عقلي إلى جوار الرعشة ومشاعر اللذة المرتبطة بالقراءة وهُمْ لا، ثم حاولت مع أسرتي المتدينة أن ألتحق بكلية الآداب قسم الفلسفة مثله لكني فشلت – فلسفة؟ والعياذ بالله يا كلب! – وهكذا انضاف سبب جديد في صنع علاقة خاصة لم تنقطع أبداً بهذا الكاتب الكاتب، وعندما حصل على نوبل كنت أخوض في غمار النار المستعرة حوله لكني منذ البداية لم أندهش للخبر لأني كنت مبكراً أوقن بأنه يضاهي كبار الإنسانية وواحدٌ منهم.
نجيب صديق أسئلتي الوجودية الخالدة وإن كان بمكره قد أفلت من وحشيتها لما فرشها على المائدة وحولها إلى فن بينما ظللت أنا أتعذب بها وأمرض. أحب له كثيراً من الأعمال وأُعيد اكتشافه كل فترة لكن الشحاذ والحرافيش وقلب الليل وليالي ألف ليلة وأصداء السيرة الذاتية هم الأقرب لروحي، أما الجيل الأحدث في الكتابة فأظنه أقرب لأعماله الأخيرة: أصداء السيرة وأحلام فترة النقاهة. قديماً ساهمت السينما بالذات في نقل أسطورته إلى العامة لكن الزمن ساهم في تثبيته وحفره للأبد فصار الجميع يدخلون مراياه ورقياً وإلكترونياً ليروا أنفسهم وأرواحهم بشكل أفضل.
أساطير ثقافية
لأسبابٍ تخصُّ فتراتٍ بعينها وتوجهاتٍ كانت تتبنى ترويج أفكارٍ وأشكالٍ وصورٍ وأكليشيهات لأغراض صحفية وإعلامية كانت للأسف تهتم باستثمار أي شيء وكل شيء، سادت قديما عدة اعتقادات تنتمي للثقافة أو بالأحرى لدوائر النميمة التي تحيط بالثقافة، منها أن الشتاء هو موسم إنجاز المشاريع الإبداعية المؤجلة (فلا تحادثوني من فضلكم إلا بعد ثلاثة شهور على الأقل!) وأن الصيف هو موسم التخفف من كل شيء، من أي التزام بإنجازٍ، ما ومن أي وعد (فلا يليق أن تطالبني بشيء وأنا مختنقٌ هكذا يا أخي!) ومن القراءات الجادة التي تفيد بشكل واسع ثقافة الكاتب ومشروعه الإبداعي، لصالح الكتب الخفيفة التي تكون مضيعة للوقت والعمر السريع اللهاث .. وأن من لا يستمع إلى فيروز والشيخ إمام ليس مثقفاً طليعياً.. وأن يدور شكل وهندام المبدع حول فكرة أنه الداعية الدائم للتحرر، والمفكر بالتالي تحاصره على الدوام الأفكار الكبيرة التي تذهله أن يتذكر أن فوق رأسه شَعرا مشرعا على العالم، وأن للقميص أزرار من الأوفق ألا تكون منزوعة.. الخ الخ.
ثم مرت الأوقات وأصبحت نزعة تفكيك الظواهر الكبير منها والضئيل والبسيط منها والمؤثر، هي النزعة العالمية فانكشفت الروابط التي كان يظن أنها صلبة وكانت تربط بين أواصر قيم ثقافية واجتماعية عديدة ومن ثَمَّ ظهرت هشاشتها وتمت إعادة النظر، ومن ثم إعادة الصياغة، واستبعاد كل ما لم ينجح في اختبار الزمن بانتمائه للإنسانية والإنسان.
وهكذا صارت القراءة لا ترتبط بموسم معين بل هي رهن بتوفر الكتاب الجيد والوقت المناسب (المستقطع من هموم ومتطلبات الحياة اليومية) وباتساع المناخ النفسي والروحي للقراءة. ونفس الأمور تصلح على الكتابة فحينما تلح الفكرة وتكون القابلية لاقتناصها في مرحلة الجهوزية، فهذا هو الوقت المناسب سواء كان المطر يدك عظام الشوارع أو كانت الحرارة تشوي النظرات والأحلام. كما لم يعد شكل الكُتَّاب يُعيِّنهم بالذات وسط الآخرين الذين صارت ملابسهم جزءاً من شخصياتهم وليس باعتبارهم (أعضاء نقابة ما) مثلا! وهكذا لم تعد اختيارات المبدع الشخصية في الموسيقى والسينما والفنون الشكلية الخ مرهونة بعناوين وأقواس من المحتم ألا يسبح خارجها فالحياة صارت مفتوحة في كل شيء: في الأفكار والتوجهات بل والعادات والتقاليد. كل الأمور قابلة لإعادة التدقيق وطرح أسئلة ونوافذ لا تتوقف وغالباً لن تتوقف أبداً مادام الإنسان حياً.
سليمان العطار
هو واحد من الذين تجلس في حضرة إنتاجهم باطمئنان الواثق، بدأتُ معه في "مائة عام من العزلة" التي كانت تميمة التكوين في وعينا وسبباً في هوسنا بالواقعية السحرية زمناً ليس بالقليل بعدها كانت "طرق ضالة" لـ كاميلو خوسيه ثيلا ثم أقمت شهوراً في ضيافة "دون كيخوته" التي خلصتني من معاناة "الأمانة لحد الثقل والمعاظلة" في ترجمة عبدالرحمن بدوي الرائدة. وإذا كنتُ في هذه الأعمال أبحث عنها هي فأنا بعدها صرت أبحث عن المترجم، عن سليمان العطار بالذات.
ثم مرت عليَّ الأيام وأنا ألتقط طرفاً مطمئناً من حديث بساطته وتواضعه وأستاذيته الحقة على مدى جلسات عفوية يتصادف وجود واحد من تلاميذه فيها حتى جاءت فرصة اللقاء المباشر ودعيت لمناقشة رسالة ماجستير فإذا بي في حضرة كل هذه المعاني متجسدة: العلم الذي يبرق في إضاءات موسوعية لنقاط مغمورة في قلب البحث ثم التجرد التام للمعرفة والبساطة حيث أصرَّ على شكر الباحث الشاب على نقاط لم يكن يدركها عن ما بعد الحداثة، وأفاض في ذكر ما كان يفهمه خطأً أو ما غاب عنه، كان فرحاً وهو يتحدث عن إفادته الشخصية بشكل خشيَ منه الأساتذة على مقام الأستذة لكنه أعطى الجميع درساً في قيمة رد الفضل لأهله وقيمة أن تظل مندهشاً وباحثاً عن متعة المعرفة حتى الرمق الأخير.
لا يحتاج الكبار إلى مناسبة لاستعادة ما يمثلونه من قيم، إنهم وقود الروح التي ما تفتأ تنطفئ كل ثانية في أيامنا الشحيحة هذه.
عن سرقة الكتب
في مطلع تسعينيات القرن الماضي كان الحصول على الكتب بشكل دوري بالنسبة لسكان البلدان الصغيرة أمراً في غاية الصعوبة، لذلك كان انتظار معرض الكتاب السنوي أمراً حتمياً نظل نحلم به ونحن نحرم أنفسنا من كل شيء لندخر مبلغاً يضمن شراء ذلك الورق السحري الذي نعيش عليه لكن هيهات أن يهدأ نهمنا، فكان لا بد من الاعتماد على المحترفين في سرقة الكتب وشراءها منهم بسعر ميسر أو مبادلتها، وبالطبع كنت أهز رأسي باشمئزاز كلما تحدث أحدهم في الأمر لكن إذا أخرج أحدهم من أسفل البالطو السميك كتاباً، تلمع عيني فوراً ويدق قلبي كأنه في حضرة المحبوب. لكن ألم تسرق بنفسك أبداً؟ الذي يخاف حتى من ظله،لا يخاطر أبداً.
لماذا يظن الكاتب أن القارئ سيكون متساهلاً؟
كانت أعمال أدونيس المنقحة، التي قال عنها ما يعني أنه ما دام على قيد الحياة فليس هناك ما يمنع من إعادة تشذيب القصائد أو إعادة ترتيبها: القصائد الطوال معاً والقصار معاً.. إلخ، إذ أنها فرصة لن تعود للشاعر بعد أن يموت - كانت هذه الأعمال ومقارناتنا بين الطبعات المختلفة متعة نمسك بها في فترة الجامعة إذ يستتبع المقارنة اختلاف ونقاش حيوي حول مدى توفيق الشاعر أو إذا كان من الأجدى تركه النص أو ترتيب الأعمال الكاملة على ما كانت عليه.
كنا ننظر للأمر بغير قليل من الحسد لأنها بالفعل فرصة لن تتأتى بعد فناء الكاتب وانتهاء نصه الكبير، وسرح كل منا ورأى نفسه يفعل ذلك، لكن الواقعي فينا قال فجأة: ولماذا يظن الكاتب أن القارئ سيكون متساهلاً ويعطي وقته لنفس المؤلف ويسعى إلى اقتناء تجليات كل مرحلة من مراحله الإبداعية وينفق الساعات في المقارنة، اللهم إلا إذا كان متخصصاً في نصوصه بشكل أكاديمي أو غيره؟
ومرت الأيام وأصدرت كتباً وفوجئت بأن الرعب يتملكني من العودة لقراءتها كي لا أفتح على نفسي طاقة توتر لا تنتهي حيث إني بالتأكيد ودون ريب سأندم على صياغة ما كتبته في موضع ما وأفكر في صياغة أخرى أرى ساعتها أنها الأوفق أو حتى سأندم على جملة أو فقرة أو حتى نصٍّ كامل أرى أنه يبتعد بمسافة عن تناغم أجزاء الكتاب معاً. هذه النتوءات ستكون سبباً في نزول قطرات عَرَقٍ واضطرابٍ في ضغط الدم سيستمر حتماً كلما هلت ذكراه، لهذا أعدو بعيداً عن كل كتاب صدر وتغير انتماؤه من الخفاء للعلن.. لكن الأمر لا يخلو من الكارثة إذا طلب منك مثلاً أن تجهز مختارات من كتبك السابقة، ستكون المأساة ساعتها واضحة وجلية ولها وقع الفضيحة.. انقسم المبدعون حول هذا الأمر، فالبعض رأى أن الإبقاء على النصوص كما كانت وفق مرحلة الوعي والفنية التي أُنتجت فيها أقرب إلى الصدق الفني وإلى ملاحظة تطور واختلاف توجهات ومفردات وصياغات وأولويات كل مرحلة مقارنة بالمرحلة التالية، بينما البعض يتعامل مع الأمر ببساطة فيرى أن الفرصة إذا كانت متاحة اليوم - خاصةً أن توفّر فرصة للنشر في بلادنا تعني غالباً نشر كتاب جديد وليس إعادة النظر في كتاب فات - فالأولى أن نتمسك بها في محاولة منا لتقديم وعينا اليوم لقارئ ماكر ومتسع ويجيد المقارنة بين الكُتَّاب كما يجيد التعالي والتجاهل ببساطة وإعلان الملل بإزاء مشاريع كان يظن أصحابها أنها أقرب للاكتمال.