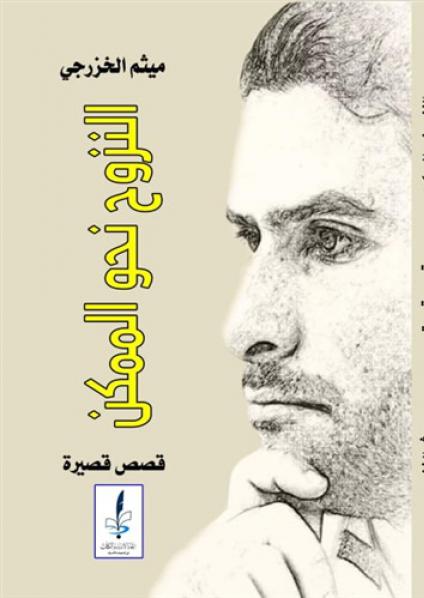حدود الممكن عند مِيثم الخزرجي في 'النزوح نحو الممكن'
في مجموعته القصصية "النزوح نحو الممكن"؛ نجد عشر قصص قصيرة، للكاتب العراقي ميثم الخزرجي، اختار عنوان إحداها علَمًا على المجموعة، في إحالة فنِّيَّة إلى معرفة ذلك الممكن الذي يقصده، من خلال مطالعة هذه المجموعة، مع الربط بين دلالاتها ورموزها وبين هذا العنوان.
وقد صدرت هذه المجموعة القصصية سنة ألفين وعشرين، وتقع في مئةٍ وثمانٍ وعشرين صفحة، ويضع الكاتب على أُولى قصصها عنوان "جمال مضمر"؛ ليتحدث من خلاله عن جمال الطبيعة الذي شاهده حال وصوله إلى "دار المعلمين"، التي استقلَّ إليها عربةً تَتَناقض حالها مع حال ذلك المكان؛ حيث قال عن تلك العربة: "فلا تسمع ممن ارتضى لنفسه أن يكون أحد راكبي العربة، سوى كلمات غير متزنة، مبعثرة، بل بالكاد تنطلق الكلمات لتصل إلى مسامع الحوذي"، ثم قال عنها مرة أخرى على لسان أحد سكان القرية؛ وهو مدير القسم، الذي استقبله بمدرسة "المعرفة": "وسائل النقل داخل القرية بدائية جدًّا؛ مجاراة لحال الطرق".
أما المكان فتختلف حاله عن ذلك تمامًا؛ وقد وصفه بقوله "ترجلتُ مستفهمًا عن بهجة المكان، مستشفًّا بأنظاري المتوهجة التي أخذت تسرف بالتحديق لما رمقت من بساطة وروعة المكان..."، حتى تلك العقبات التي تتعمد حكومات بعض بلادنا العربية والإسلامية عرقلة مواطنيها بها؛ لم يجدها "عليٌّ" بطل هذه القصة عند الكاتب؛ بل يقول الكاتب على لسانه: "فقد كنت متصورًا بأن هنالك بعضًا من المعوقات التي قد تفاجئنا جرَّاء الروتين السائد في الدوائر الحكومية، ولكن كل شيء سار على أتم وجه، وبِوَقتٍ قياسيٍّ والحمد لله"؛ فهذا أمرٌ غير معتادٍ في كثير من بلادنا العربية، التي دأبت على عرقلة أمور مواطنيها؛ من أجل شغلهم بها حتى لا يتاح لهم الوقت للنظر في شيء أبعد من ذلك.
ثم يصف الكاتب موقف أحد زملائه في الغرفة التي سيسكنها، وهي التي وفَّرتها له إدارة المدرسة: "وكأنه أفرغ ما بحوزته من الصبر؛ لينال الرجاء بوصولي"، وهو وصفٌ يدل على الارتياح ويبشِّر بالسلام؛ فزميله هذا (كوركيس) شغوف بتبادل المعلومات والخبرات، ولذلك وجد عليٌّ أن غرفته التي سيسكنها معه مليئة بالكتب، وهنا يعود الكاتب إلى (الجمال المضمر) مرة أخرى حين رأى: "هذه الرفوف المتهالكة تحتوي على كنوز من المعرفة، تزخر بها غرفة الاستراحة"، هذه الكتب التي كوَّن منها كوركيس ثروته المعلوماتية، التي أشار إليها الكاتب بقوله "تواصلتْ غزارة المواضيع من قِبَل الأستاذ كوركيس".
وفي هذا الجو المجتمعي الصغير داخل الغرفة؛ يتذكر الكاتب هموم وطنه، فيقول: "سحبتني مخيلتي إلى هناك، محاولًا أن أقارن مساحة بلدي المكدَّر، بمساحة غرفة الاستراحة، التي ارتقت أن تكون وطنًا يزخر بالأمل"؛ ذلك الأمل الذي يدفعه إلى البحث عن (الجمال المضمر) داخل تلاميذ يتعلمون في مدرسةٍ كئيبة الحال كما يبدو من وصفِه إيَّاها، فيقول: "ثمة ما أسعى جاهدًا وراءه هو التنقيب عن مكامن الأمل"، ثم يقول كالعائد في كلامه: "وكيف يكون الأمل بِبُيوت الصرائف ومدارس الطين؟!!".. ثم يسترسل في وصفِ ما بهم من سوء حال، لكنه يجد لديهم أحلامًا وآمالًا؛ فمنهم من يريد أن يصبح طبيبًا ليعالج فقراء القرية، ومنهم من يريد أن يصبح مهندسًا زراعيًّا، ومنهم الرسَّام الذي "بادر باللحاق بالأمل؛ بِرسمِ مدينته الوادعة، واستحضار معالمها من البنايات الفقيرة والشوارع المهملة، ولكن بصورة ترتقي بالبشر".
والجمال المضمر في هذه المواقف والأحداث التي ذكرها الكاتب؛ هو جمال واقعي موجود في بلادنا العربية والإسلامية، لكن التعامل معه يختلف باختلاف الأنظمة الحاكمة وقدراتها وطموحاتها؛ فالأنظمة القوية تسعى إلى إظهار ذلك "الجمال"، من خلال توفير البيئة المناسبة له، بينما تسعى الأنظمة الضعيفة الفاشلة إلى دفنه حيًّا؛ لأنها لا ترضى بغير "القُبح".
وفي بداية قصَّته "النزوح نحو الممكن" -وهي القصة التي اتخذ الكاتب عنوانها علَمًا على مجموعة قصصه في هذا الكتاب- يقول ميثم الخزرجي: "فما زلت أنحدر من أهازيج الغبار التي شكلت الوخزة الأولى لطفلٍ يروم الوصول إلى يقظة كونية تزفر ما بدا لها من حقيقة، وإن كانت مختلفة بعض الشيء"، وقد وُفِّق الكاتب في التعبير بجملة "تزفر ما بدا لها من حقيقة"؛ فالحقيقة في هذا العصر تصاحبها معاناة كبيرة، وعذاب مختلف الألوان بين مجتمعات لا تريد أن ترى شيئًا من الحقيقة، فكانت النتيجة وجود أجيالٍ أصبحت حالهم كما يتحدث الكاتب على لسانهم: "لم نتمكن من معرفة الأشياء بمسمَّياتها، أو المسمَّيات بحقيقتها؛ لتَماهِينا مع الوهم، وانجذابنا إلى الفراغ لنصبح أسئلة بلهاء ينتصفها التِّيه، أو يسورها السكوت.. أعمارنا حبلى بأيام باهتةٍ مغمضةِ الرجاء.. الهواء الذي أدمنَّاه قد استُعمِل في وقت فائت؛ ليصلنا بلا فائدة".
فهو يرى أن "الجميع في تلك الأمكنة قد شرَّدهم الهمُّ بعيدًا؛ لينحتهم أقبية تشرب من وعي التكوين حكايات ثكلى تنمو بانتكاستنا"، وهذا هو الواقع العربي، الذي يرويه الكاتب من خلال تجربته في بلده العراق، وفي هذا الصدد لا يفوت الكاتب أن يتحدث عن الحرب وويلاتها، وما رآه هو وصديقه "حسَّان" في أثناء تجنيدهما.. يقول متحدثًا عن صديقه: "عندما سألتُه عما يكتبه بشغف مهول؛ أجابني وبنفس طريقته المعهودة؛ أن الحرب لا ظل إلا الموت" وقد كان مصير صديقه الاعتقال بسبب ما يكتبه عن ويلات الحرب وآثارها المدمرة، وقد شهد الكاتب عملية اعتقاله؛ إذْ يقول: "احتفظتُ بورقة سقطت من أحدهم أثناء الاعتقال، مكتوب عليها (صناعة الحياة هاجسنا الذي نسعى إليه، ما دمنا نستقي من أوجاعنا طرقًا نعبر من خلالها إلى ضفة الطمأنينة)".
وبعد أن يفكر في كلمات صاحبه التي قرأها بعد اعتقاله، ويتأمل معانيها؛ يصف حال نفسه فيقول: "أما أنا فقُدِّرَ لي أنْ ركلني القدر بعيدًا جدًّا، عابرًا جُزُرًا من التخويف؛ لأمارس التحرر بحواسي الخمس، على الرغم من أنني انسللت من الباب الخلفي للوطن، مودِّعًا صيحات عامل المقهى، التي لم يبقَ منها سوى الرمق"؛ والباب الخلفي للوطن، الذي يذكره الكاتب هو الباب الوحيد الذي أصبح ملاذًا لكثيرٍ ممن تبطش بهم أنظمة غاشمة جاءت إلى سدَّة الحكم في غفلة من الشعوب.
وفي قصة أخرى عنوانها "إعلان سر" يعرض الكاتب قصة "ليلى"، التي أصيبت في طفولتها بمرضٍ نفسيٍّ، لكن والدها لم يخبر "خالدًا" قبل أن يتزوجها؛ ظنًّا منه أنه لا أثر لذلك المرض على نفسها أو علاقتها بالآخرين، ولا سيما بعد أن أخبره الأطباء بتمام شفائها؛ إلى أن وقعت الكارثة وقامت ليلى بإغراق طفليها الصغيرين، وسط ذهولٍ من أسرتها، أفاض الكاتب في تصويره؛ وليس بعجيبٍ أن تتعامل ليلى مع الموقف بهذه اللامبالاة التي صوَّرها الكاتب، وكأنها لم ترتكب جريمة، فضلًا عن أنها ارتكبتها في حق طفليها الصغيرين؛ فهذه هي النتيجة الحتمية لعدم الاهتمام بالصحة النفسية، أو الاكتراث بالآثار المدمرة الناتجة عن الأمراض النفسية، وما فعلته بطلة القصة عند الكاتب شبيهٌ إلى حدٍّ كبيرٍ بتلك الكوارث التي يتسبَّب فيها بعض المسؤولين في بلادنا؛ الذين يأتون إلى مناصبهم بالمجاملات، دون النظر في مدى أهليَّتهم، ثم نفاجأ منهم بقرارات وخطط وبرامج لا تدل إلا على مرضهم النفسي، الذي يدفعهم إلى تدمير البلاد والعباد.
وفي قصة أخرى عنوانها (أنثى مدمرة) يصف الكاتب تلك الأنثى، فيقول على لسان الشيخ بطل قصته: "لقد أخذتْ منِّي الكثير، ولم تمهلني القليل يا ولدي؛ فقتلتْ واستباحت، وتكالبت علينا من كل حدب وصوب، وألجمتنا بجراح لم تندمل"، ثم يذكر ردَّ الولد على كلامه: «ولماذا لم تنتقل إلى مكان آخر؛ ليتسنَّى لك الخلاص من براثنها؟، فيرد الشيخ: "لَمْ تعطني الفرصة يا ولدي"؛ ثم يكشف الكاتب عن تلك الأنثى التي يقصدها، فيقول على لسان شيخِهِ: "إنَّ للحرب أوزارها"، وتشبيه الحرب بالأنثى المدمرة معروف منذ العصر الجاهلي؛ قال امرؤ القيس [80ق.هـ] (البيتان من الكامل، في ديوانه ص149):
الحرب أوَّل ما تكون، فتيَّة *** تبدو بزِينتها لكل جهولِ
حتى إذا حميتْ وشَبَّ ضرامها *** عادت عجوزًا غير ذات خليلِ
وقد أراد الكاتب أن يوضح قِدَم الحروب المدمرة في بلده العراق، فجعل كلامه على لسان شيخٍ يحاور شابًّا صغيرًا، كأنه ينقل إليه خبراته، ويعرِّفه أن الحرب طالت أجيالًا في بلدهم، فلم تدَع فرصة لأحد في النجاة أو الحصول على حقه من الأمن والاستقرار.
وفي قصة أخرى عنوانها "تنقيب" ينصحه صديقُه النصيحة الأمنيَّة التي تعرفها جميع الشعوب العربية والإسلامية الذين ابتُلوا بحكامٍ لا وازع لهم من دِين أو خُلُق، يقول صديقه: «ما يختلجك من سوادٍ؛ حاوِلْ أن تودعه بمفكرتك الشخصية، وتُلقِيَ به طي الحرمان عن أي شخصٍ غيرك؛ وإلَّا تُودَع في إحدى أركان الأمن العامة؛ إن لم تروِّض لسانك على عدم الإدلاء بما تضمر».
وليس بعجيبٍ أنَّ صديقه هذا الذي يُدعَى "غافلًا"، الذي يصفه الكاتب بأنه "لم يغفل عن الحقيقة أبدًا، بل لم تغفله هي"؛ قد تمَّ اعتقاله أيضًا؛ لأنه كان يدوِّن ما يراه من ظلمٍ وقمعٍ، كان يدوِّن فقط ولا يتكلم به، وبالرغم من ذلك أصبح مصيره كما يقول الكاتب: "لم نعرف أي شيءٍ لحدِّ هذه اللحظة".
وهذه الأحداث الجسام التي تناولتْها قصص هذه المجموعة؛ هي التي جعلت الكاتب يفكر في "النُّزوح نحو الممكن"، الذي رسم ملامحه وتخيَّله في ذلك "الجمال المضمر" الذي يبحث عنه في قصصه؛ ذلك الجمال الذي يمثِّل بارقة أمل في النجاة من تلك الكوارث، غير أن هذا "النزوح" يحتاج إلى التَّكاتف في مواجهة من يحاولون عرقلته.