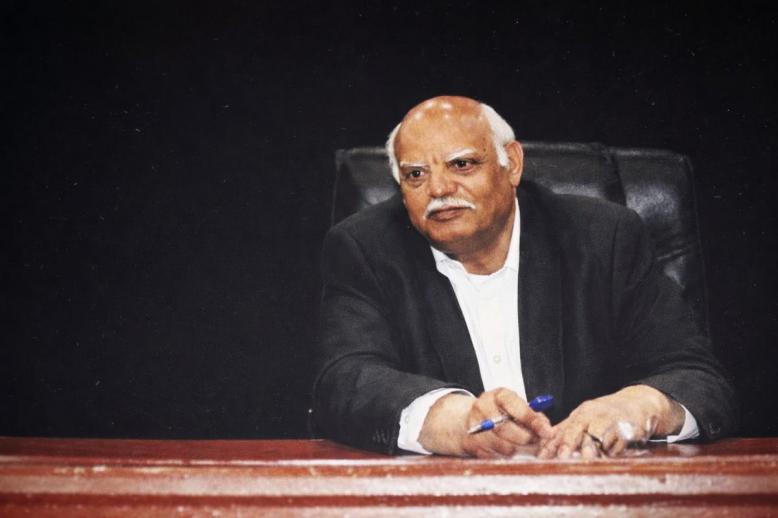صابر سويسي: "الفناء" الصوفي لحظة صفاء تنتفي فيه ذات المحب
يرى الباحث التونسي المتخصص د. صابر سويسي في التصوف أن الإنسان عبر بصيغ مختلفة عن رغبته في الانعتاق من حدود الأطر الزمانية والمكانية، وتوقه إلى التحرّر من رقّ الجسد والنفس، وأعلن تطلّعه إلى التحليق في عوالم أرحب، عادة ما كانت غيبية متعالية بنى عبرها مثله ونماذجه التي سعى إلى تجسيدها وتحقيقها، ورنا إلى الاكتمال بها، وتجلّى ذلك في أشكال متنوّعة وصور شتى ضَمَّنَها مختلف أصناف الفكر والثقافة البشريّين، ولا سيّما الفكر الديني منها؛ لذا من الطبيعي أن نجد مثل هذا الشعور "رغبة، توق، تطلع" ومثل هذه النزعة إلى الكمال مبثوثين في الفكر الإسلامي ومتمكّنين خاصة في واحد من أبرز تفريعاته، ونعني تحديداً الفكر الصوفي أو التجربة الصوفية، باعتبارها توجّهاً سلوكياً عمليّاً نحو حياة مثالية وسمها أصحابها بـ "الروحية"، يقوم على جملة من المقامات والأحوال يفضي بعضها إلى بعض، وتتوّج بالوصول إلى الحضرة الإلهيّة، حيث تمّحي "الآثار" و"الأغيار" ويكتمل "الفناء" مشكّلاً بذلك واحدة من أرقى درجات السلوك الصوفي.
"الفناء" في التجربة الصوفيّة إلى نهاية القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلاد كان موضوع وعنوان كتاب د. سويسي الصادر أخيرا عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود متخذا من هذا المصطلح الصوفي "الفناء" مدخلاً لفهم الخطاب والتجربة الصوفيّين، وكان اختياره "الفناء" نظراً لما يثيره من جدل بين مشكك ورافض وبين متبنّ ومدافع. فضلاً عن موقعه من هذه التجربة الروحيّة بوصفه بحثاً عن سبل خلاص الصوفيّ من وضعيته الحاضرة المقيدة بنواميس الزمان والمكان والمجتمع والطبيعة ليرتقي حيث مكانته الأصلية المنشودة التي يكون فيها مرآة للألوهية وعلامة عليها، وهو خلاص جسره وعنوانه المحبة، فهي سبب خلقه، وهي أداة معراجه وترقيه في الطريق إلى ربّه، وقوّة حضورها فيه تدرك غايتها لحظة "الفناء"، فهي لحظة الصفاء المطلق الذي تنتفي فيه ذات المحب الصوفي لتتلاشى في حضور المحبوب.
وسعى د. سويسي إلى تتبّع نشأة القول بـ "الفناء" وعوامل تشكّله لتبيّن آليّات اشتغال الفكر الصّوفي وطرائق تفاعله مع لغته ونصوصه التّأسيسيّة ومع روح عصره، ولهذا اعتمد مصادر تمسح القرون الهجريّة الخمسة الأولى لكونها شهدت ولادة هذا المصطلح وتركيز دلالاته وتجلياته، ولاحظ أنّ طغيان النّزعة الفرديّة في التّجربة الصّوفيّة لم يكن ليخفي نقاطاً مشتركة تجمع أصحابها وخطوطاً كبرى تنحت معالمها مهما حاولت التّستّر على معارفها وأدبيّاتها.
وفي الوقت الذي تعدّدت فيه مقالات أوائل الصوفيّة حول "الفناء" واختلفت فوسمته بالتنوع والثراء في دلالاته ومكوناته لكونها انطلقت من تجربة ذوقيّة معيشة، انصرف المجهود في القرنين الرابع والخامس الهجريين أكثر نحو التخفيف من حدّة الاختلاف بل نفيه من أجل توحيد دلالته وأبعاده ونحت صورة متناغمة لاصطلاحات الصوفيّة ترقى بها إلى مصاف العلميّة والثبات وتتصدّى للخصوم والمعترضين، باستدعاء القرآن والحديث النبوي وإيجاد تأويلات تتناسب مع فكرة "الفناء" وتشرعها وتسندها.
معظم مصادر التصوّف المتأخرة تحديداً في القرنين الرابع والخامس للهجرة سعت إلى تدارك الارتباك عبر جمع مقالات الصوفية وغربلتها ضمن تصور عام موحّد للتصوف.
وتساءل عن المقصود بالفناء الصوفي؟ وما هي أهمّ العوامل التي أسهمت في تكوينه وتشكيله ومن ثمّ تثبيته في التجربة الصوفية؟ وهل من صلة بينه وبين الجوانب الاجتماعيّة والعقائديّة والسياسيّة؟ وما هي انعكاساته على التجربة الصوفية؟ وما منزلته من الفكر الإسلامي؟ واستقصى أكبر عدد ممكن من مصادر التصوّف في القرون الهجريّة الخمسة الأولى للعثور على خيوط تقود إلى معرفة كيفية تنامي فكرة الفناء لا في التجربة الصوفية فحسب، وإنّما أيضاً في بعض المحاولات الفردية لعدد من المتصوّفة قصد تبيّن طرافتها أو دورها في تطوير هذه الفكرة وتحديد عناصرها، وهو ما أهّلها لتكون مصطلحاً من أبرز مصطلحات التصوف وأساساً من أسسه التي لا غنى له عنها.
وحول ما استقرّ للفناء من معان أو دلالات، وما اكتنفه من سياقات، أوضح د. سويسي أنها تمثّلت في:
أولا: الانقطاع باعتبار "الفناء" قطع صلة مع جملة من الصفات والحركات أو الأفعال والأحوال تختصره عبارة "الفناء عن..."، فضلاً عن أنّه انفصال عن الخلق بما فيه الذات البشرية نفسها يفقد فيه "الفاني" شعوره بنفسه وبمن حوله.
ثانيا: الاستبدال أو الوسيلة، ونستفيده من عبارة "الفناء بــــ..." وتكون عادة قرينة استبدال صفات العبد بالصفات الإلهية أو دالة على أنّ هذه العملية إنّما تستوجب تدخّل الذات الإلهية، وتوجيهها للتجربة الصوفية نحو الغاية الحقيقية المفترض وصولها إليها.
ثالثا: الاستغراق والاستقصاء، وتدلّ عليهما عبارة "الفناء في.." حيث يقترب الصوفي من إدراك مرحلة السكون المطلق فلا يعي نفسه، ويرى ما حوله واحداً فترتد الكثرة وحدة ويغلب عليه الوجود الإلهي فيغيّب وجوده الذاتي أو الفردي بوصله بعد أن كان مستقلاً أو منفصلاً، ويعيده إلى معين الوجود الأزلي "الإلهي"، وفيه أقصى ما يمكن للعابد أن يبلغه، لأنّ وصوله إلى هذه الدرجة عنوان اكتمال فعل التوحيد المقدور للعبد إنجازه وإدراكه، وبه نلج سياقات "الفناء".
رابعا: سياق التوحيد، وقد لاحظنا أنّه خلافاً لسائر المسلمين الذين يبنونه "أي التوحيد" على الاعتقاد والاعتراف القلبي واللساني أكّد الصوفية عنصر المحبّة، وعملوا على تقوية معناه وتعزيزه، فهو عندهم سبيل التوحيد الأمثل والأصدق؛ لذلك نجد الديلمي مثلاً يقدّمه في شكل أنوار: نور من الله ونور للعبد يبلغان في "الفناء" درجة الاتحاد حيث يذوب النور الثاني في الأوّل ويتحد به، فيكون بمثابة عودة الفرع إلى الأصل. وهذا الذوبان يعدّه الصوفية كمال التوحيد لأنّه يحقّق تلاشي العبد في الوجود الإلهي وامحاء إنّيته وذاتيته، فلا يشهد إلا الواحد الأحد، إضافة إلى أنّ هذا العنصر "المحبّة" ينسجم تمام الانسجام مع طبيعة التجربة الصوفية، فهي وجدانية روحية في المقام الأوّل قبل أن تكون معرفية.
وعقب سويسي قائلا: من هنا نفهم سر الاهتمام بتجربة رابعة العدوية في الحب الإلهي، واعتبارها مهد القول بـ "الفناء" وعلامة على انفتاح دلالاته وثرائها، فالمحبة الإلهيّة قطب الرحى في تطور مفهوم "الفناء" واختلاف تعبير الصوفية عنه وتنوع رؤاهم وتفاسيرهم له، والتوحيد غايته ومحرار توفق الصوفي فيه.

ورصد سويسي للنقلة النوعية التي عرفها التصوّف انطلاقاً من القرن الثالث للهجرة، واقترانها بنشاط عملية ترجمة الآثار الفلسفية اليونانية وحركيتها خاصة في بيت الحكمة ببغداد، وهو ما انعكس على التصوّف، ومن ثمّ "الفناء"، وحدد شكلين بارزين: الأوّل هو أنّ التصوف تمثّل مقولات خارجية بعضها فلسفي وبعضها الآخر عقائدي، بنى عليها فكرة "الفناء" دون أن يهيّئ المناخ المناسب لتركيز هذه الفكرة وترسيخها بشكل يسمح بصهر هذه المقولات ضمن رؤية موحدة واضحة المعالم؛ على الرغم من محاولته الاستفادة من النصوص القرآنية والنبوية وتأويلها. وهو ما أحدث الارتباك الذي أشرنا إليه في استخدام المصطلح، وفتح المجال رحباً للاختلاف والاعتراض خلاف توظيفه فلسفيّاً؛ إذ بدت الأرضية واضحة المعالم منسجمة معه ممهّدة له.
ولعلّ هذا ما دفع المستشرقين ودارسي التجربة الصوفية عموماً إلى تقسيم الصوفية إلى فئات ومذاهب نسبوها إمّا إلى تيّارات فلسفية أو عقائدية أو كلامية... وفق ما بدا لهم من تقارب بين مختلف الأطراف، فكان "الفناء" تارة حاملاً لبصمات الأفلاطونية المحدثة وطوراً للعقيدة البوذية، أو وليد الثقافة الفارسية، أو فلسفة الإسماعيلية. ولكنّ هذا كلّه لم يحجب وجود نقاط تقاطع بين مختلف الاستعمالات تحديداً في الغاية من «الفناء» وفي كيفية تحقيقه وطبيعته والعلاقة التي يفرزها بين الخالق والمخلوق، ويبدو أنّ دور أبي سعيد الخرّاز في هذا الجانب مركزي بإجماع مختلف مصادر التصوّف.
- الثاني هو أنّ معظم مصادر التصوّف المتأخرة تحديداً في القرنين الرابع والخامس للهجرة قد سعت إلى تدارك هذا الارتباك عبر جمع مقالات الصوفية وغربلتها ضمن تصور عام موحّد للتصوف. وهذا ما جعل عملية تبيّن الفوارق بين أقوال المتصوفة في "الفناء" غاية بعيدة المنال لما كرّسته هذه المصادر من جهد لتخفيف حدّة الاختلاف وتقريب التعابير المتباينة، بل تحويلها إلى اتفاق ظاهر مطلق نحو ترجيح معنى موحّد يحقّق ما صبا إليه الصوفية من العلمية والثبات والإطلاقية متوسلين في ذلك شتّى الطرائق والأساليب من حذف وزيادة وتوفيق وتلفيق.
وخلص سويسي قائلا "لئن حجب هذا عنّا جزءاً من الرؤية الحقيقية الموضوعية للفناء الصوفي فإنّه لم يلغ أهميته وخطورته، بل أتى حاملاً لإشكالات إضافية تعيّن بحثها وتتبّعها، بعضها ارتهن بالفترة التاريخية التي درسنا وبعضها الآخر انفتح على الفترة التي تليها منبئاً بولادة تصوّرات جديدة للموضوع تخرج بالفناء عن السياقات التي احتوته على امتداد القرون الهجرية الخمسة الأولى لتعلق بسياقات أخرى لعلّ الفلسفة تحظى فيها بالنصيب الأوفر، فتنغرس أكثر في البعد الأنطولوجي، وتبحث في جوهر الإنسان وموقعه من الوجود والكون ودوره فيهما وصلته بربّه وبالعالم حوله. ولا نستبعد أن يستهلك "الفناء" أيضاً في سياقات مغايرة تجعل من التصوف مجرد تقليد ومحاكاة يتبع فيها اللاحق السابق، ويقتدي به اقتداء أجوف شكلياً، فينأى بذلك عن معانيه التي وضعت له في عرف الصوفية الأوائل، وينخرط أكثر في باب اختراع الكرامات وصناعة أخبارها. وقد رأينا لذلك ممهّدات من قبيل تشييء عملية الفناء وانبثاق اصطلاح "الفناء" في الرسول و"الفناء" في الشيخ... وهي اصطلاحات ستجد لها مبرّراتها وغاياتها بعد القرن الخامس للهجرة.