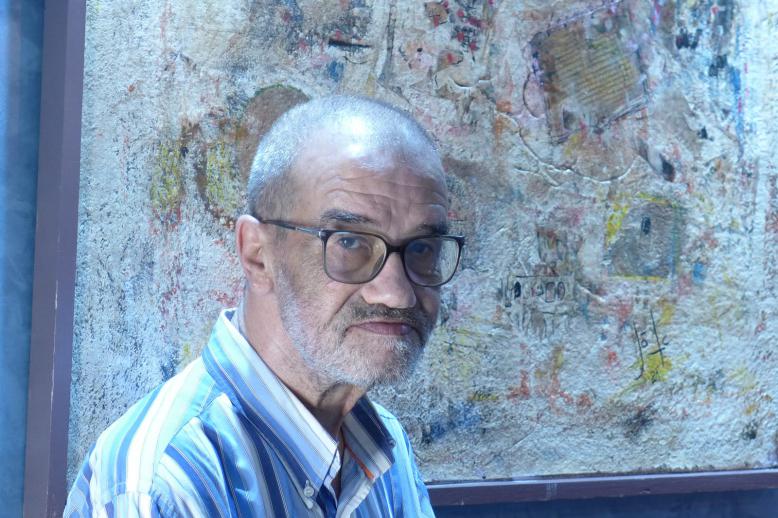مستقبل مسرح الطفل وتحدياته
ونحن نقسّم المسرح إلى فئات كما الأجناس الأدبية من: تعبيري، وتسجيلي أو وثائقي، وذهني، وعبثي أو لا معقول، وملحمي، وغيره.. نستطيع القول إن المسرح موجود في كل مكان، وزمان. ومسرح الطفولة موجود منذ وجد الأطفال على الأرض، لكن النظرة فيما مضى لم تكن لتفصل عالم الصغار عن عالم الكبار، إلا أنه مع ظهور علوم جديدة في التربية، والاجتماع، وعلم النفس، الخ…، بدأ الاهتمام بعالم الطفل، واعتباره كائناً منفصلاً عن عالم الراشدين.. له خصائصه، ومميزاته، وله مراحله العمرية.
وإذا كان كل من خيال الظل في سوريا، ومسرح عرائس (الأراجوز) في مصر، من الفن الشعبي، وقد اعتبرتهما منظمة اليونسكو جزءاً من التراث الثقافي الإنساني غير المادي صوناً للتراث الثقافي للبشرية، فالأولَى بنا ألا ننسى ما كان للطفولة من نصيب منهما قبل أن يصبح هناك مسرح خاص بالطفل.
وعندما ظهر ما أصبح يعرف بأدب الأطفال كجنس أدبي مستقل كان نقطة تحول فيما يكتب للصغار بعد تجاوز زمن "الرواية" ـ أي الأدب الشفاهي ـ إلى المدون، والمكتوب. ولما كان "أدب الأطفال" يجمع إليه كل الأجناس الأدبية من: قصة، ورواية، وشعر، ومسرح، وغيره.. فقد بدأ الاهتمام بمسرح خاص بالطفل يكون موجَهاً إليه، ولو أنه من صنع الكبار، ويشاركون فيه على خشبة المسرح.
لكن الأهم في هذه المعادلة هو: "النص الطفلي" الذي ينتمي إلى الأطفال أنفسهم فيما يتعلق بأفكارهم، ومشكلاتهم، وأحلامهم، ونظرتهم إلى الحياة. وهذا مما حرض فيما مضى بعض المؤلفين على أن يبحثوا في التراث العربي عما يناسب الطفولة، فالتقطوا قصص "علاء الدين والفانوس السحري"، و"السندباد البري والبحري"، ولم يوفروا ما يناسب الطفولة من قصص "ألف ليلة وليلة"، أو من السِيَر مثل: "سيرة عنترة"، أو "بني هلال"، أو "سيف بن ذي يزن"، وغيرها.. ولم يوفروا أيضاً "المقامات"، ومنها ما كان يعتبر نواةً لمسرح الكوميديا.
إن مسرح الطفولة هذا الذي ارتبط في بداياته بصندوق الدنيا، أو صندوق العجائب، وخيال الظل هذا الفن الشعبي الذي كان له دوره الإيجابي في وقت من الأوقات، وبمسرح الدمى، أو العرائس وهي تُطلق ضحكات الصغار، وتزرع البهجة في نفوسهم. أقول إن لهذا المسرح أهمية كبيرة من حيث التأثير في سلوك الطفل، وبناء شخصيته، فكما هو ـ أي الطفل ـ يتماهى في شخصية أبطال القصص فإنه لا يقف أمام المسرح متفرجاً فقط بل هو منفعل، ومتماهٍ مع أبطال العرض المسرحي وشخوصه، وهذا بدوره يحقق الغرض الأكبر من فكرة المسرح عند الطفل تأثراً، وتأثيراً. ولطالما أكد الدارسون، والتربويون، وعلماء نفس الطفل على الدور الإيجابي الذي يلعبه المسرح في حياة أطفالنا.
نحن مطالبون بتطوير خطاب الطفل بما يتناسب والبيئة التي أصبح يعيش فيها، وربما قصة، أو مسرحية عن رحلة فضائية تثير خيال طفل اليوم أكثر من أجواء غابة مسحورة لم يألفها الطفل في مشاهداته الحياتية
وكما يتفاعل الطفل مع عالم القصة، وهي الأقرب إلى قلبه عندما يتماهى في شخصية البطل، أو يتوحد معه، فإنه يحقق ذلك بشكل أعمق مع المسرح عندما يتفاعل مع العرض المسرحي بعفوية على أنه حياة تتحرك أمامه، فيصدقها لتصبح بالتالي مجالاً خصباً لبث القيم، والأفكار الإيجابية، والبناءة.
و مادام الطفل بما يملكه من طاقة على التخيّل يحول من خلالها المستحيل إلى واقع فهو يؤنسن العالم من حوله بموجوداته من جماد، وحيوان، وفي الوقت ذاته لا يتردد أثناء لعِبه من القيام بتمثيل أدوار في ما يسمى بالدراما (الإيهامية)، وهو يستنطق الأشياء، ويتحاور معها، ويقلد بالتالي ما يلاحظه من حركة، وسلوك في العالم من حوله، وكأنه يهدم ذلك الحد الفاصل بين الواقع والخيال، وإذا بالشجرة تنطق، وبالحيوان يرقص، وبالكرسي يتجول في أرجاء المنزل، وفي عالم من اللامعقول يغذيه الخيال، ويطوره الإبداع، ولكنه يظل في عالم الطفولة هو لعب، ومرح، وتسلية. وقد استفاد المسرح من هذه الموهبة الفطرية عند الأطفال في تجسيد أدوار لهم على خشبته.
وإذا كانت الحيوانات هي الأقرب إلى عالم الطفولة في مراحلها الأولى فكم من البهجة، والمتعة يحصل عليها الأطفال إذا ما قفزت تلك الشخصيات المحببة إليهم إلى خشبة المسرح لتغني معهم، وترقص، وقد تدخل إلى بيوتهم كما الأصدقاء.
فالمسرح تنشيط وترفيه، وتعليم أيضاً. وهو كما يصفه بعضهم: حاجة تربوية، وفرصة للإبداع والتثقيف، وهو في الوقت ذاته يتكامل مع دور المؤسسة التربوية، ويستوعب طاقات الأطفال.
وإن كنت لن أستعرض مسرح الطفل عموماً ذلك لأنني سأتوقف عند موضوعين اثنين أرى أن على مستقبل المسرح أن يتعرض إليهما، الأول: هو المعاصرة بمفرداتها المختلفة لارتباطها الذي أصبح وثيقاً، ولصيقاً بنا إذ عادت ساعاتنا الزمنية بقادرة على أن تعود بنا إلى الوراء.. بل إنه الغد هذا الذي يسبقنا، ونحن نتطلع إليه، وعلى أدب الاطفال من قصة، ومسرح، وغيرهما، أن يقف عنده. والثاني: هو استلهام التراث بهدف ترسيخه في الأذهان، ولكن بإسقاطٍ معاصرٍ يلغي الحدود بين ما كان، وما سيكون.. ما دمنا لا نريد لأبنائنا أن ينفصلوا عن جذورهم لصالح المعاصرة.
أما عن المعاصرة فأقول إنه في زمن أصبح فيه الطفل يتلقى ثقافة أدبية من مصادر مختلفة: كوسائل الإعلام من تلفزيون، وغيره، كما من شبكة المعلومات، والسينما، وغيرها، فقد أصبح لِزاماً علينا تطوير المسرح بما يُقنع، ويُؤثر، ويؤصل الهوية، والانتماء. وهذا ليس فقط عن طريق معرفة التراث، بل إن علينا مقاربة موضوعات جديدة هي من واقع الطفل العربي المعاصر سواء ما يتعرض منها لمشكلاته، أو ما يتطلع إليه في مستقبل باتت تحكمه الآلة، والتقنيات الحديثة في تفاصيل الحياة اليومية.
وحتى خشبة المسرح ذاتها باتت تحت سطوة هذه التقنيات، إذ لم يعد الجمهور يتفاعل مع الخشبة من دونها كحاله قبل ظهورها، وقد صادرت "سينوغرافيا" المسرح لصالحها من حيث المؤثرات: كالإضاءة، والصوت، والصورة وكل ما يحدد فضاء المسرح، وفن المنظر.. وبحيث تتحول خشبة المسرح إلى عالم كامل متكامل بكل عناصره، وكأنه حياة أخرى داخل الحياة التي تحتوي على المكان، والجمهور.
إن تقنيات العرض المسرحي والتي لا تبدأ بتقنيات الكتابة، ولا تنتهي بالسينوغرافيا هي على ما هي عليه من أهمية. وهنا نؤكد أننا لا نستطيع، كما أنه لا يجب أن نستهين بقدرات الطفل وذكائه، مع التركيز على العوامل المؤثرة التي تعمل على جذبه، والتأثير عليه، مع مراعاة الجانب السيكولوجي لديه.
فمسرح الطفل ما عاد كما كان عليه، كما لم يعد لدينا من حجة، أو مبررٍ حتى لا نجدد أسلوب الخطاب من خلاله، كما من خلال الأجناس الأدبية الأخرى، لطفل يتفتح في زمن الألعاب الإلكترونية، وسينما البعد الثالث، وعوالم الافتراض، أو الواقع الافتراضي.
أقول في زمن الألعاب الإلكترونية وما تفرضه من أنماط تفكير جديدة تصادر المتلقي لتحركه في فضاءاتها قبل أن يحركها هو في مسار اللعبة نفسها، كيف لنا أن نقدم المسرح ما لم يتجدد من داخله من حيث الشكل الفني، والمضمون الفكري، خاصة وأن قيماً جديدة باتت تطرح نفسها في سوق تعامل البشر بين بعضهم بعضاً. فلا ندع الطفل حائراً في فضاءات لا هي مما يشاهد على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة لا فرق، أو مما يرى فيما حوله، ولا هي تقترب من عوالمه الحقيقية. ففضاء الغابة بالنسبة للصغار رغم ما يثيره لديهم من دهشة، وحس المغامرة بات مفقوداً في عالمنا المعاصر، ووسائل التواصل، والإتصال جعلت من كل بقاع الأرض لوحةً تعرضها الشاشات.. فلا غموض إذن.. ولا عوالم مجهولة، ومنعزلة لتكون بيئة مثيرة لخيال الطفل، بل على العكس فقد أصبح هناك مما يقع تحت السمع، والبصر بما هو أكثر إثارة، ومتعة عند الطفل من قصة الغابة، والذئب، أو الوحش الذي يمكن أن يفترس طفل الحكاية. وآفاق العلم بما يفرز من إنجازات هي الأكثر إثارة في رأيي في القرن الحادي والعشرين، وهي تتجسد مسرحاً أو قصة، الخ.
ويالعودة الى مضمون النص المسرحي المعاصر فهو لا يقتصر على الفكرة فقط فيقف عندها، بل إنه يتعداها إلى جمالية الأسلوب، وفنية المعالجة. ولعلي أرى أن من جماليات النص الحديث هو انفصاله عن الخطاب التقليدي. وجماليات السرد تتشكل من خلال أساليب حديثة، ومتنوعة لهذا السرد سواء أكان ممسرحاً، أو في إطار القصة.
والجماليات هنا ما أقصد به تلك القوة، والطاقة التي يمتلكها النص المسرحي بتقنياته، وبمضمونه فيؤثر في المتلقي. ولا شك أن التقنيات، والأسلوب يؤثران كما المضمون.. فالجماليات تنبثق من الأمرين معاً. ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. والبنية الموجودة في النص تلقى استجابتها، وصداها، والوعي بها، وكذلك الاحساس الجمالي بها لدى المتلقي. والمتعة تكون بالتقنيات وبالتجارب.. ففكرة الجماليات ليست في النص فقط، بل هي الحبل السري الجميل الذي يربط بين الطاقة المشعة من النص والمتلقي. وعندما تنعكس ضوءاً في وجدان هذا المتلقي، فما بالنا إذا كان هذا المتلقي هو الطفل؟ فهل لنا أن نُغفل كل ذلك الآن في عصر التواصل والإتصال وقد أصبح لدينا عنوان جديد هو "الجماليات الإلكترونية في الخطاب المعاصر"؟ إن عصرنة الخطاب الطفلي المسرحي باتت ضرورة ولم تعد اختياراً.
وبالانتقال إلى الموضوع الثاني وهو: استلهام التراث في المسرح فقد أصبحت له شروط أخرى جديدة؛ من حيث الدقة في انتقاء الموضوعات من جهة، وإعادة صياغتها برؤية معاصرة، ومتجددة من جهة أخرى. فلا نحن هنا أسقطنا التراث، ووضعناه في الصناديق المغلقة، ولا نحن قدمناه في سياق يخرج عن عصرنا.
ولكن.. أي تراث هذا الذي أبحث عنه، وبين ثناياه لنقدمه إلى أطفالنا في قالب مسرحي حديث يحقق غايته؟ هل هو ذلك الذي يحمل منظومة القيم من: أخلاقية، وتربوية، وتعليمية، وغيرها، وما أُضيف اليها من قيم معاصرة أيضاً؟ أم هو ذاك الذي يطير على أجنحة الخيال، وما تحمله قصص التراث من إثارة، وتشويق؟
في الحقيقة نحن لا نستطيع أن نفصل منظومة القيم عما يقدم للأطفال، إلى جانب إثارة الخيال، وهو أساس الإبداع. وعلى هذا كان لزاماً علينا أن نتحرى بدقة، ومهارة ما يمكن أن نستلهمه من نصوص تراثية يمكن أن نحملّها القيم الإيجابية التي تتناسب والعصر، كما المراحل العمرية لدى الأطفال، وذلك دون إفساد للرواية التراثية، وإنما بما يضيف اليها، ويحتفظ لها بعنصري التشويق، والمفاجأة.
ونحن نستلهم من التراث نتحرى ما لا يتعارض مع نظريات التربية الحديثة، لنستبعد كل ما يقوم على إثارة الخوف، والهواجس لدى الطفل، وما يؤذي مشاعره من حيث العنف، وأنماط السلوك الشريرة.
وإذا ما اتفقنا على أننا سنستبعد من قصص التراث كل عنف، أو جرأة مما قد يخدش النفوس الغضة، فلا بد أن نتفق أيضاً على ضرورة تطوير هذا المحتوى بإسقاطات معاصرة نقرّب من خلالها هذا التراث من العالم الذي يعيش فيه أطفالنا اليوم ليتجاوبوا معه، ودون أن نفسد مسار النص الأصلي بما قد يسيء اليه، أو ينتقص من قيمته.
ونحن في الوقت ذاته نريد أن نفرّق بين أزمنة التراث، فنتساءل: أي تراث هذا الذي نقصده؟ هل هو التراث القريب، أم الآخر الأبعد، أو ذلك المغرق في القدم؟ برأيي أن ما يهمنا هو أن نبدأ بتراثنا القريب قبل الأبعد فنقدمه لأطفالنا، ونعرفهم به. وأقصد بتراثنا القريب نضالنا ضد الاستعمار مثلاً.. لأن هذا التراث يبقى أنقى من غيره لأنه قريب، بشرط أن يكون منقولاً من مصادر عربية لا أن يؤخذ مما كتبه الغرب عنا.
أما تمثل التراث فلا بد أن يشتمل على اتجاهين اثنين: الأول هو: إثارة اهتمام الطفل مع التشويق، والثاني هو: اشتماله على القيم.. ومن خلاله ـ أي التراث ـ نستطيع الوصول إلى "النموذج المثال" أو القدوة الذي يتجسد أمام الطفل ليرسم له مسار حياة فيما بعد.
وعملياً فنحن لم ننفصل عن التراث لأنه موجود في سياق حياتنا الاجتماعية، وفي الأمثال، والحكم التي تثير فضول الطفل الذي بدوره يسأل فيعطيه الكبار المعلومة الواردة في التراث. وهذا بالتالي يعني أننا لا نستطيع أن نهرب من تراثنا، لكن علينا أن نطوعه لنلتقط منه المضامين التي نريدها لنوجه أطفالنا نحوها، بمعنى: أن نحول قصة الصرصار والنملة من الكسل إلى الفن مثلاً، أي أن نلتقط القيمة التي نريدها، ومن ثم نوجه التراث باتجاهها.. والأمثلة كثيرة، وحتى لو أوردنا التراث كما ورَد، أي كما هو، فنحن نوجه الطفل لأن يلتقط منه ما هو إيجابي بعيداً عن فجائعية النص الأصلي لو وجدت.
ولكننا قد نفاجأ ونحن نبحث في التراث عن نصوص نختارها أن النص القصصي الموجه للطفل ينفتح عموماً على التراث السردي، بينما نحن نريد أن نحول هذا السرد إلى نواة لنص مسرحي يحقق غايته من التشويق، ليجذب الطفل إليه، إلى جانب بث المعارف من تجربة الحياة.
أما خرافات الخوارق في المسرح العربي الموجه للطفل فأقول من حيث المبدأ أنه: لا يجوز نقل الخوارق كما هي لأنها تثير الضحك عند أطفال اليوم المعاصرين، إذ لا يجوز أن يقتل عنترة بضربة سيف واحدة عشرة أشخاص. والخوارق هنا لو دخلت في اللعبة المسرحية فستكون من خلال الحوار، أو بالقص المسرحي عن طريق الراوية، ولو مزجت هذه الخوارق بشيء علمي معاصر لكان تقريبها لأذهان الأطفال أقرب، فلا تعود خوارق مجردة عن كل شروطها، أو مؤثراتها.
إن الكتابة المسرحية حول النصوص المُستلهمة من التراث سواء بوجود الراوية، أو بدونه يُشترط لنجاحها بالدرجة الاولى أن تتسم بالحبكة المتماسكة، والأحداث المشوقة، واللغة السليمة التي يشتمل عليها قاموس الطفل اللغوي، وجمالية النص، إلى جانب روح المرح التي تفجر ضحك الصغار، والابتعاد عن الوعظ المباشر، وخطابية الحوار، ومنطقية الأحداث في تصاعدها الدرامي، ومراعاة طول المسرحية زمنياً بما لا يتجاوز نصف الساعة، أو أكثر بقليل.
ودون أن ننسى في مسرح "أطفال المرحلة العمرية الأولى" أن الأمر يسير كما هو حال الكتاب.. حيث تكثر الحركات على حساب الكلام أو الحوار، شأنه شأن الصورة مع الكلمات. ولا بأس من أن يبدأ العرض من مشهد متأخر توفيراً لمشاهد في النص قد لا يستسيغها الطفل، إلى جانب الإيقاع السريع للعرض حتى لا يقع الطفل المشاهد في الملل.
وإذا كانت "السينوغرافيا" بمكوناتها مجتمِعةً تشكل عنصراً مهماً في العمل المسرحي فإن لسينوغرافيا مسرح الأطفال، والتراثي منه على وجه الخصوص، أهمية أكبر، فهي البوابة العريضة التي سيدخل منها الطفل إلى عالمٍ ليس فيه سوى خشبة المسرح، وما يدور فوقها. تلك الأهمية التي تقع على درجة موازية للنص، هي التي تخلق جو القصة التراثية، وبما يحقق اندماج الطفل الكامل مع المسرحية، وتَمثُله لها بالشكل الصحيح.
إذن لهذه التقنية خصوصية في التعبير عن أجواء التراث واستحضارها، وبالشكل الذي يقنع ذلك الناقد الصغير الذي هو الطفل، ونحن نأخذ بعين الاعتبار دقة ملاحظته للتفاصيل الصغيرة في المشهد المتسع، فما بالنا ونحن نتوجه بهذا المسرح إلى طفل القرن الحادي والعشرين؟ والذي انفتحت أمامه بوابات عوالم الطفولة على أرحب مساحاتها ما دام هناك التلفاز، والسينما بما تعرضه كبريات شركات الإنتاج من أفلام للأطفال تقوم على كل ما يبهر الكبير قبل الصغير، وبالأبعاد الثلاثية أيضاً، وكذلك ما تبثه شبكة المعلومات، وما تُخزنه الأقراص المدمجة، إلى جانب الألعاب الإلكترونية، ومدن الألعاب، وغيرها.
فكيف إذن سنسرق الطفل من هذه العوالم الفاتنة إلى المسرح ما لم يكن هذا الأخير موازياً في إبهار عروضه؟
السينوغرافيا ليست عناصر لونية، أو تشكيلات مادية فقط، بل هي فكر يتعامل مع منطق الأشياء في استحضارها، فإنها وحدها القادرة على جعل المستحيل ممكناً
وإذا كانت السينوغرافيا ليست عناصر لونية، أو تشكيلات مادية فقط، بل هي فكر يتعامل مع منطق الأشياء في استحضارها، فإنها وحدها القادرة على جعل المستحيل ممكناً.
إنه التراث.. وما يخفي تحت عباءته من دهشة، وإبهار، والجسور لا تنقطع، والأحلام تتسع. وتراثنا العربي يزخر بموروث غني من القصص الخيالية، والسير الشعبية، والملاحم، والبطولات، والخوارق، والخرافات إلى جانب قصص الجدات، مما يصلح ليكون مادة خصبة يمكن أن تشكل منها لوحات مسرحية تمتع الأطفال، وتغني تجربتهم بآن معاً. ولماذا لا يكون التعريف بالتراث وأمجاده، وبطولاته، وعلمائه، ومادة تراثنا ثرة غنية كالبحر الزاخر، وخاصة في تراثنا العربي والإسلامي؟
وأخيراً أقول إذا كان المسرح هو أبو الفنون لأنه يشتمل على الغناء، والموسيقى، والرسم، والتمثيل، والتأثير المباشر على المتلقي، فلا أقل في مسرح الطفل الآن من تقنيات في الإخراج، و"السينوغرافيا" من الديكور، والإضاءة، والموسيقى، والرقص، والأزياء، والمؤثرات الصوتية والبصرية، والمؤثرات التقنية الحديثة التي أصبحت متاحة وهي تغني العرض المسرحي، وتحقق فيه عنصر الدهشة التي تصل إلى حد الإبهار. وما بالنا بتلك الأقنعة الجذابة التي تحمل وجوه الحيوانات بشكل لطيف ومحبب إذ تدخل إلى عالم الصغار فتطلق ضحكاتهم مع خيالهم وهم يتماهون، ويندمجون مع أبطال المسرحية طالما أن العمل المسرحي يترجم النص الأدبي من خلال الأداء التمثيلي، والحركة الى جانب السينوغرافيا.
إذن لكل هذه العناصر، والتقنيات مجتمعة دورها الفاعل، والمؤثر مادام المسرح يمهد للطفل أمام التفاعل الاجتماعي من خلال تفاعله مع غيره من الأطفال أثناء التمثيل، وخاصة من خلال الأدوار التي يقوم بها.. كما استيعاب النص عند تمثيله، وهذا يعتبر رديفاً لدور الأسرة في التنشئة الاجتماعية، وخاصة في مراحل العمر الأولى، ووضعه ـ أي الطفل ـ من خلال المسرحية على الخط الفاصل بين الخطأ والصواب.
لكن من متابعتي لعروض مسرحية تُقدم للأطفال في بلدان مختلفة من الوطن العربي وجدت أننا لم نستطع عموماً أن نخرج عن "النمطية" فيما يُكتب للطفل، مع ملاحظة الفارق بين هذه النمطية واستلهام التراث، ولكلٍ مساره الذي ينفصل عن الآخر.
ونحن في زمن التكنولوجيا التي أصبحت كعالم اللامعقول، فأين الساحرة الآن بينما تُستخدم أدوات كالسحر مثل "الموبايل"، و"الكمبيوتر"، وغيرها؟ وأين هي الغابة المنعزلة من تلك المدن التي تشع بالأنوار فتحول الليل الى نهار؟ وأين هي وحوش تلك الغابة وقد أصبحت قريبة من الانقراض نتيجة زحف المدن، والمجتمعات العمرانية إلى أغلب مساحات البلدان؟
إذن فنحن مطالبون بتطوير خطاب الطفل بما يتناسب والبيئة التي أصبح يعيش فيها، وربما قصة، أو مسرحية عن رحلة فضائية تثير خيال طفل اليوم أكثر من أجواء غابة مسحورة لم يألفها الطفل في مشاهداته الحياتية، لأن مفهوم الغابة بما فيها من أسرار لم يعد اليوم كما كان عليه الحال بالأمس.
وما دام الربع الأخير من القرن الماضي قد شهد ثورة في عالم الاتصالات، والتكنولوجيا، وما يهمنا منها في هذا السياق الثورة في عالم الشاشات، وأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، واهتمام الشركات العالمية بأعمال الأطفال، وثبت على وجه التاريخ عالَم فريد هو عالَم "والت ديزني"، وما اخترعه من شخصيات عُممت على العالم كله، فقد أصبح للطفولة عالمها الخاص بها. هذا عدا عن كتب الأطفال، أو ما يقدم إليهم عموماً عن طريق وسائل الإعلام من أفلام، وصحف، ومجلات، وألعاب.. الخ، وكتاب إلكتروني يمكن أن نطلق عليه اسم "كتاب المستقبل" فلا أقل إذن من أن نستفيد من هذه المعطيات، والتقنيات التي هي بين أيدينا في عالم المسرح لكي ينافس غيره، ونحن نصِل جسور الحاضر بالماضي، لنرسم مستقبلاً مختلفاً لأطفالنا.
المسرح حياة.. ولا بد لهذه الحياة أن تتجدد من داخلها بما يثري المسرح والحياة معاً.