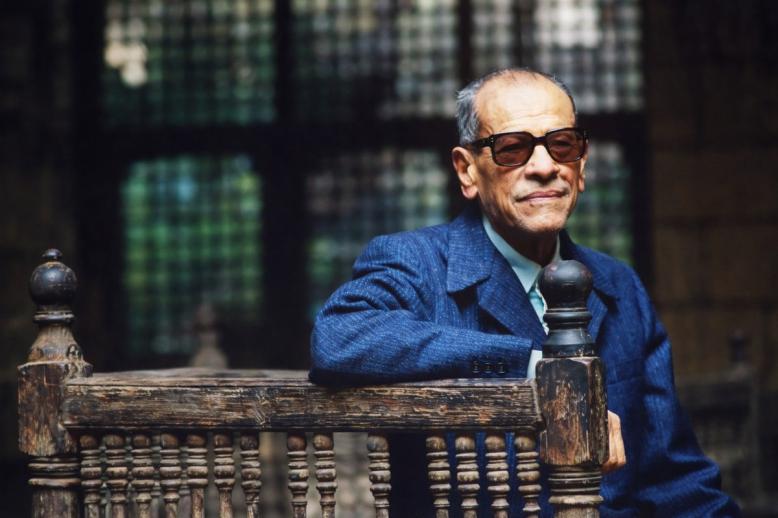نهاد خياطة ينكب على 'دراسة في التجربة الصوفية'
شكَّل شيوخ الصوفية الكبار أبو يزيد البسطامي وأبو القاسم الجنيد ومحي الدين بن عربي والحلاج وأبو حامد الغزالي، ورابعة العدوية وأبي بكر الشبلي وغيرهم، الملامحَ العامة والخاصة للتصوف الإسلامي وجوهره، وهذا الكتاب "دراسة في التجربة الصوفية" للكاتب والمترجم السوري نهاد خياطة يقف على أهم مَظاهر التصوف الإسلامي، متناولا تجارب هؤلاء الكبار، ومثيرًا من خلالها الركائزَ الرئيسة في التصوُّف الإسلامي، مثل وحدة الشهود، والفرق بينها وبين الحلول، وتقديم أمثلة على وحدة الوجود في القرآن والسُّنة والأحاديث النبوية، مع شرح مستفيض لحالتَي الفناء والبقاء، ومناقَشة بعض مظاهر الشطح على لسان بعض المتصوفين.
وحدة الشهود
يقول خياطة "وحدة الشهود نوع من التوحيد يختلف عن توحيد الإيمان الذي نصَّت عليه الشريعة، من حيث إن التوحيد الأول توحيد يقيني، تجريبي، أو ذوقي، على حدِّ المصطلح الصوفي. بينما التوحيد الشرعي إيماني، نقلي، يلتمس إليه الدليل بالنظر العقلي. وعلى هذا فإن التوحيد الشهودي، أو وحدة الشهود، حال أو تجربة، لا فكر ولا اعتقاد. يقول د.أبو العلا عفيفي: هو التوحيد الناشئ عن إدراك مباشر لما يتجلَّى في قلب الصوفي من معاني الوحدة الإلهية في حالٍ تجلُّ عن الوصف وتستعصي على العبارة، وهي الحال التي يستغرق فيها الصوفي ويفنى عن نفسه وعن كل ما سوى الحق، فلا يشاهد غيره لاستهلاكه فيه بالكلية. ويقول: هذا هو الفناء الصوفي بعينه، وهو أيضًا مقام المعرفة الصوفية التي ينكشف فيها للعارف معنى التوحيد الذي أشار إليه ذو النون المصري إذ يقول "إنه بمقدار ما يعرف العبد من ربه يكون إنكاره لنفسه، وتمام المعرفة بالله تمام إنكار الذات". فإن العبد إذا انكشف له شمول القدرة والإرادة الإلهية والفعل الإلهي، اضمحلَّت الرسوم والآثار الكونية في شهوده وتوارت إرادته وقدرته وفعله في إرادة الحق وقدرته وفعله، ووصل إلى الفناء الذي هو عين البقاء؛ لأنه يفنى عن نفسه وعن الخلق ويبقى بالله وحده. هذه أيضًا هي الحال التي يسميها الصوفية "وحدة الشهود". وينقل عفيفي عن التهانوي، في نتائج الأفكار القدسية، قوله "التوحيد عند الصوفية معرفة وحدانيته الثابتة له في الأزل والأبد، وذلك بألا يحضر في شهوده غير الواحد جلَّ جلاله"، كذلك ينقل عنه قوله: فيرى صاحب هذا التوحيد كل الذوات والصفات والأفعال متلاشية في أشعة ذاته "أي ذات الحق"، وصفاته وأفعاله، ويجد نفسه في جميع المخلوقات كأنها مدبرة لها وهي أعضاؤها. ثم يقول التهانوي: ويرشد فهم هذا المعنى إلى تنزيه عقيدة التوحيد عن الحلول والتشبيه والتعطيل، كما طعن فيهم "أي الصوفية" طائفة من الجامدين العاطلين عن المعرفة والذوق؛ لأنه إذ لم يثبتوا معه غيره فكيف يعتقدون حلوله فيه أو تشبيهه به، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا. ويعقب عفيفي على عبارة التهانوي بقوله: لكن قول التهانوي إن الصوفية لا يُثبتون مع الله غيره، ولا مع صفاته صفات أخرى، ولا مع أفعاله أفعالًا أخرى، إذا أُخذ على إطلاقه لا يجعل الصوفية من القائلين بالتوحيد، بل بوحدة الوجود، وهو معنًى للتوحيد كادت المدرسة البغدادية في القرن الثالث ـ ومن زعمائها أبو القاسم الجنيد ـ أن تقول به".
الشطح الصوفي
ويرى أن الشطح تعبير عن دهشة الصوفي؛ إذ يفاجأ بأن الألوهة أقرب إليه مما تعلمه من الفقهاء أو علماء الكلام الذين أعطوا قيمة المفارقة صفة الإطلاق استجابة لضرورة تاريخية ونفسية ناشئة عن مواجهة إسلام الصدر الأول للوثنية الجاهلية وما أعطته من إطلاق لصفة البطون. والشطح، من جهة دليل على حصول قلق في بنية الصوفي النفسية أوقعه فيها الغلو في قيمة المفارقة. وهو من جهة ثانية، إيذان بأن التوازن آخذ مجراه في هذه البنية ـ إن كُتب لصاحبها السلامة! نتيجة لتلاقي قيمة المفارقة بقيمة البطون، مما يخفف من غلوائها ويحُد من مطلقيتها، إذ يجعل منها قيمة نسبية.
وليس من الضروري أن يشترط في الشطح تجربة الاتحاد، كما ليس من الضروري أن يشترط فيه تبادل الأدوار؛ لأن هذَين الشرطَين قد يصدقان على نوع معين من الشطح، وهو الشطح الذي يتكلم فيه الحق على لسان الخلق، أو الخلق على لسان الحق، ومثاله شطحة أبي يزيد البسطامي عندما قال "سبحاني ما أعظم شأني". أما قول الحلاج "أنا الحق"؛ فمن المشكوك فيه أن يكون من الشطح؛ لأن هذا القول تضمنه كتابه "الطواسين" الذي أملاه شهيد الصوفية وهو في سجنه، ولم يرد هذا الكتاب، ولا هذه "الشطحة"، في "لائحة الاتهامات" التي جمعها ولفقها الوزير الفاسق حامد بن العباس. زد على ذلك أن الحلاج لم يقُل قولته هذه مكتفيًا بالوقوف عندها، بل مضى يعللها بقوله: "إن لم تعرفوه (الله) فاعرفوا آثاره، وأنا ذلك الأثر، وأنا الحق لأني ما زلت بالحق حقًّا، وإن قُتلتُ أو صُلبتُ أو قُطِّعت يداي ورجلاي، ما رجعتُ عن دعواي".
ويشير إلى أن الصوفيَّ الذي يشطح في مقام التوحيد ينبغي أن تأتي شطحتُه من طبيعة هذا المقام الذي ارتقى إليه، أي أن تكون متعلقة بتوحيد الحق لنفسه بنفسه. لكن د.عبد الرحمن بدوي لم يأتنا بشاهد على كلامه من شطحات الصوفية، مكتفيًا بالإشارة إلى هذا المقام إشارة عابرة ويمكننا أن نتصور الشطح في مقام التوحيد كأن يرِد على لسان الصوفي عبارة من مثل "لا إله إلا أنا!"، أو "لا أنا إلا أنا!". في هذه الحالة، يمكننا أن نقول، في تفسير هذا النوع من الشطح التوحيدي، أن الحق تعالى هو الذي نطق على لسان الصوفي، إذا نظرنا إلى الشطحة من الداخل؛ أو نقول إن الصوفيَّ هو الذي نطق على لسان الحق تعالى، إذا نظرنا إليها من الخارج. وفي الحالين يكون الصوفي محوًا في شهود العيان. بناءً على ذلك، يمكننا اعتبار قول عبد الرحمن بدوي "والصوفية الذين لا يرون هذا التوحيد لا يمكن أن تنسب إليهم ظاهرة الشطح" من قبيل عدم التدقيق؛ لأن الشطح الذي يصدر في مقام التوحيد ليس هو مطلق الشطح، أو أي شطح كان، بل لا بد أن يكون من طبيعة المقام الذي بلغه الصوفي، أي "شطح التوحيد" إن صح التعبير.
أبو حامد الغزالي
ويضيف خياطة أن أبا حامد الغزالي في المنقذ من الضلال يصف حجة الإسلام التجربة الصوفية بقوله "وبالجملة؛ فماذا يقول القائلين في طريق طهارتها ـ وهي أول شروطها ـ تطهير القلب بالكلِّية عما سوى الله تعالى ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم في الصلاة استغراق القلب بالكلية بذِكر الله وآخرها الفناء بالكلية في الله، وهذا آخرها بالإضافة إلى ما لا يكاد يدخل الاختيار والكسب من أوائله، وهي على التحقيق أول الطريق. وما قبل ذلك كالدهليز للسالك إليه، ومن أول الطريق تبتدئ المشاهدات والمكاشفات حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتًا ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقَّى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق؛ فلا يحاول معبر أن يعبر عنه إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. وعلى الجملة، ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول، وطائفة الاتحاد، وطائفة الوصول، وكل ذلك خطأ". هنا نجد الإمام يرفض حتى الوصول تعبيرًا عن التجربة الصوفية لما قد يوهم هذا اللفظ من تحيُّز الحق تعالى مكانًا بعينه يسعى الصوفي إلى دركه وبلوغه. لكنه في المقصد الأسنى يتساهل في مصطلح الوصول، ملبسًا إياه معنى غير ما يشعر به مجرد اللفظ، فيقول "وإنما الوصول أن ينكشف له (للسالك) جلية الحق ويصير مستغرقًا به؛ فإن نظر إلى معرفته فلا يعرف إلا الله تعالى، وإن نظر إلى همَّته فلا همَّة له سواه؛ فيكون كله مشغولًا بكله مشاهدة وهمًا، لا يلتفت في ذلك إلى نفسه ليعم ظاهره بالعبادة وباطنه بتهذيب الأخلاق ـ وكل ذلك طهارة وهي البداية، وإنما النهاية أن ينسلخ من نفسه بالكلية ويتجرد له، فيكون، "كأنه هو"، وذلك هو الوصول".
الحلاج بين فناءين
ويلفت خياطة إذا أوغل الصوفي علوًّا في معارج القدس، ألفى نفسَه ملتزمًا بشريعة تتناسب مع الدرجة التي بلغها من الارتقاء الروحي، فما هو حَسن عند عامة الناس ربما لا يتقبله الصوفي بقبول حسن، وقد يعرض عنه ولا يأخذ به. وهُم، على العكس منه، قد يستقبحون من أفعاله أو أقواله ما قد يرونه منافيًا للشرع الذي ينظم علاقاتهم على الصعيد الذي يقفون عليه، وليس من طبيعة هذا الخلاف أن يصل إلى حل، أو إلى كلمة سواء يجتمع عليها الطرفان ما ظل الناس متفاوتين في المدارك والمواهب، وما ظلُّوا متباينين في العقول والأمزجة. فلا العامة بقادرة على ارتقاء السلَّم، ولا الصوفي بقادر على النزول إليهم، وإن كان بعضهم يرى أن من واجبه أن يفعل ذلك، ومن هنا سوء الفهم المتبادل بين أهل الشريعة وأهل الحقيقة، أو بين فقهاء الظاهر وبين الصوفية. وقد عبَّر الحسن بن منصور الحلاج عن هذه الحقيقة، وهو على خشبة الإعدام، بكلمة بليغة فاقت كل ما قيل على لسان أبطال وقفوا مثل موقفه. وقد جاء فيها "... وهؤلاء عبادُك قد اجتمعوا لقتلي تعصبًا لدينك وتقربًا إليك، فاغفر لهم؛ فإنك لو كشفتَ لهم ما كشفتَ لي لما فعلوا ما فعلوا، ولو سترتَ عني ما سترتَ عنهم لما ابتُليتُ بما ابتُليتُ. فلك الحمد فيما تفعل ولك الحمد فيما تريد...". والحلاج، كغيره من الصوفية المتحققين، اكتشف تجريبيًّا أن في الإنسان بُعدًا مفارقًا، أو إن شئتَ، بُعدًا ميتافيزيقيًّا. لكنه لم يشأ كغيره من الصوفية أن يتكتم على هذه الحقيقة، فصرَّح بها فيما أشار إليه غيره إيماءً ورمزًا، أو غلَّفها بعبارات لا يسع "البرَّاني" أن ينفذ إليها أو يحيط بمعناها، صونًا للدُّرِّ أن تطأه أقدام الخنازير، كما حذر من ذلك السيد المسيح.
دولة الروح
ويؤكد أن الحلاج لم يكن يختلف عن غيره من الصوفية من حيث تقيده بالشريعة: فقد التزم بها كما التزموا، ولم يحد عنها قيد شَعرة كما لم يحيدوا. وكان يُكثر من أداء النوافل إلى جانب ما فرضه الكتاب والسُّنة من عبادات وطاعات كما كانوا يكثرون. ولعلَّه في هذه الناحية لم يكن يقصر عنهم، بل ربما زاد عليهم. لكنه يختلف عنهم من حيث اقتصارهم على تفسير تجربتهم من خلال فهم معمق للنصوص المقدسة ـ وهم بهذا إنما يضعون تجربتهم في منظور الشريعة ويدرجونها في إطارها؛ قد يختلفون عن العامة في استشفاف المعاني العميقة والرموز الدقيقة، لكنهم لا يكسرون الأطر ولا يخترقون الحواجز. أي إنهم كانوا يعمدون إلى قياس التجربة بمقياس الشريعة، لا العكس. وعند هذه النقطة بالذات كان اختلاف الحلاج عن صوفية عصره: لم يكتفِ الحلاج، كما فعل غيره من الصوفية، بالذهاب عمقًا بل رام الامتداد اتساعًا؛ لقد ضاق ذرعًا بالشريعة بما هي "حدود" فيما كانت تجربته تتنامى وتتعاظم، وبالعبادات بما هي من "السوى". لقد أراد تطويرًا في الشريعة بمقدار ما تسمح له تجربته الميتافيزيقية بالتطوير. وهذا ما أدى به إلى الاصطدام بالصوفية الذين نبذوه وتبرءوا منه، حتى لقد قال له الجنيد: أحدثت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك!.. ثم إن الحلاج لم يقف عند حدود اختلافه مع الصوفية بل تعداه إلى الاصطدام بالبيروقراطية العباسية في دعوته إلى تأسيس دولة الروح على أنقاض الخلافة؛ فكان له اتصالات بالقرامطة وغيرهم من الأحزاب العلوية أو الهاشمية يستعين بهم على تحقيق غرضه. فاصطدم به فقهاء السلطان الذين حكموا بقتله وتحريق جثته، ولم يسلم من فتاواهم بكفره وزندقته حتى بعد مماته.