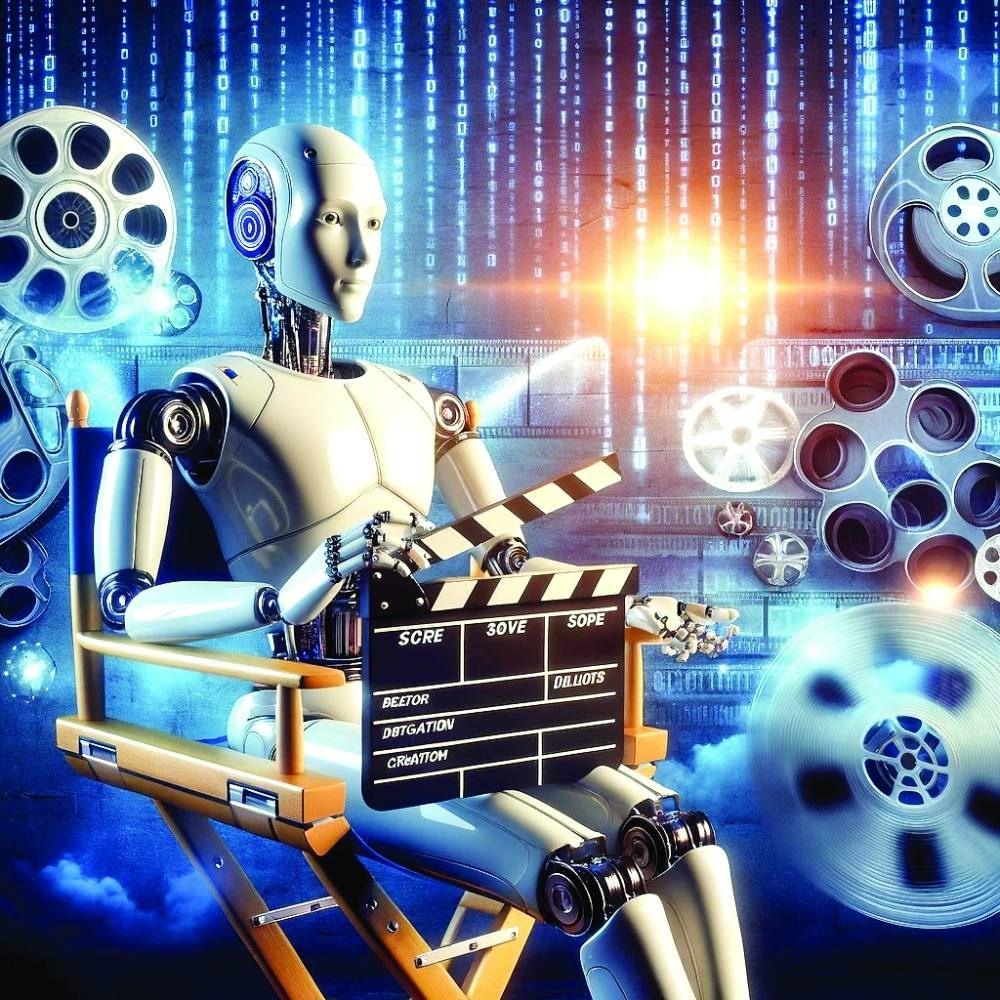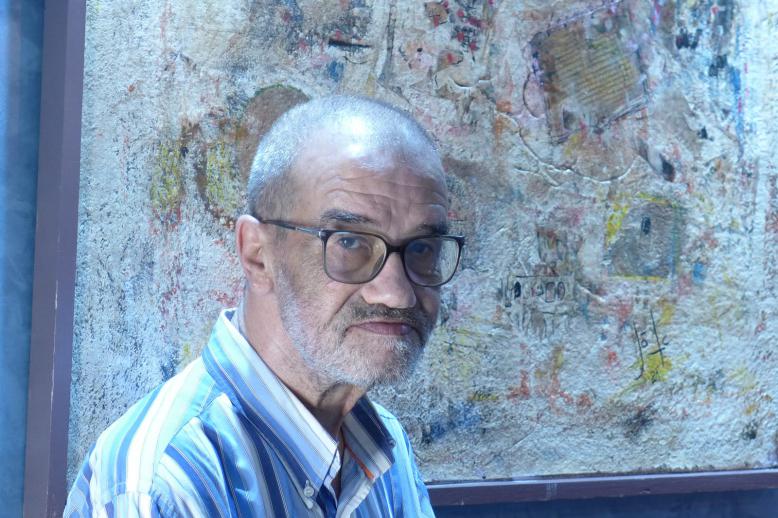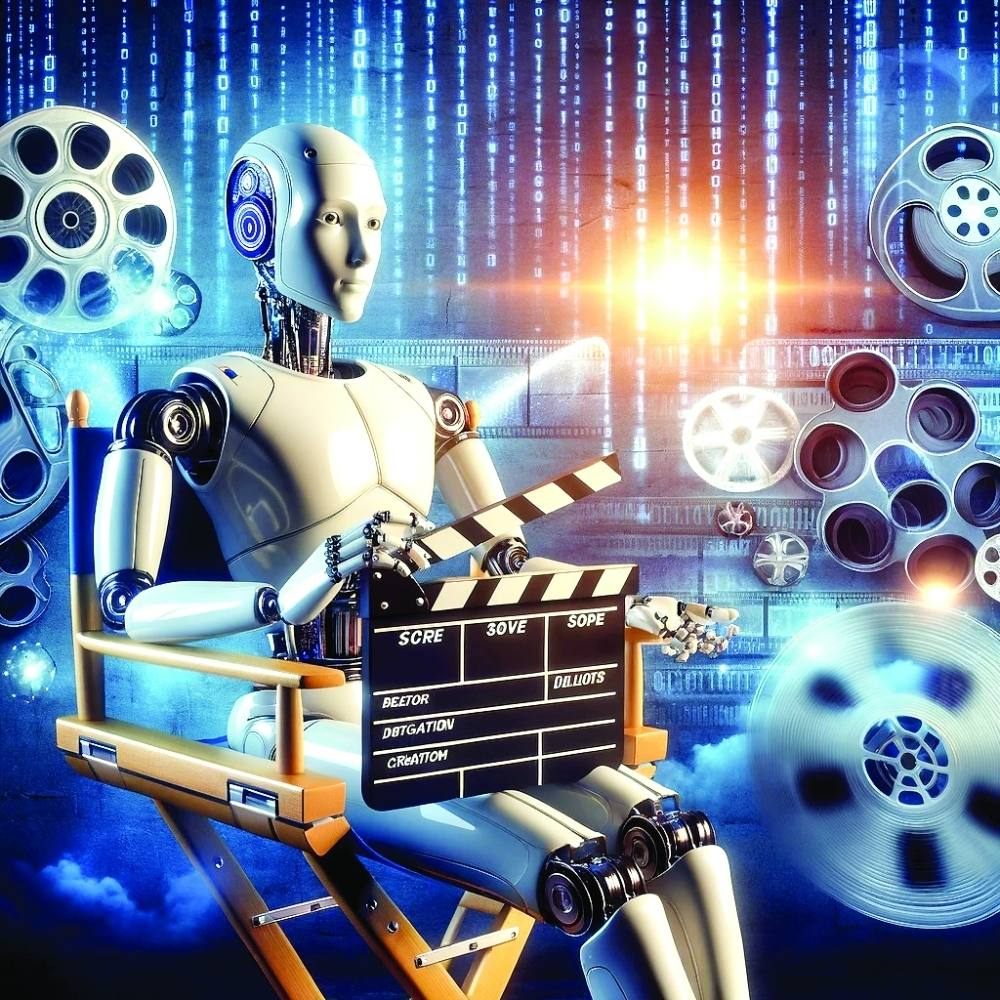الذكاء الاصطناعي يبث روحا مستعارة في أقلام نقدية دفنتها الساحة المغربية
الرباط - يمكن القول بصفة عامة إن المصير المأساوي لنقاد السينما والكتاب الذين كانوا ينتجون أفكارهم بأنفسهم يكمن في كونهم من الأوائل الذين دخلوا دوامة الذكاء الاصطناعي، ولكن هذه الصيغات فضلا عن كونها عامة أكثر مما ينبغي تتطلب بحثا وتنقيبا أكثر عيانية في المغرب، لأن سيرورات الكتابة بالذكاء الاصطناعي معقدة ومتناقضة بشكل كبير، ولا يمكن القول إن واقعة الأفكار المزيفة والمكررة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها ميزة أو ضرر، لكن فلننظر فقط إلى الكلمات المفتاحية التي يتوه في دوامتها الذكاء الاصطناعي وسنتمكن من التمييز بين المقال الأصلي والمزيف، خصوصا في بعض الجرائد المغربية سواء العربية أو الفرنسية وحتى في المواقع الإلكترونية، وحينها يمكن التفريق بين الفكرة التي أنتجها صاحبها وبين الفكرة التي نسختها التكنولوجيا، ومن جهة أخرى فإن المجتمعات السينمائية المتقدمة استفادت كثيرا من التكنولوجيا الحديثة لكنها ترفض أن تفكر هذه الأخيرة نيابة عن العقل البشري لأن هذا يتعارض مع الضمير المهني ومنطق إطلاق العنان للعقل والمخيلة بدلًا من الاكتفاء بتوجيه أوامر مثل اكتب لي كذا عن كذا، وهذه هي مفاتيح وشروط الكتابة الآلية ليستجيب لك.
وفي شروط كهذه جرب كل منا بطريقة أو بأخرى ما يمكن أن يصنعه هذا الذكاء، لكن ما يغفله الكثير من الممارسين هو أن كل ما ينتجه لا يمكن أن يسمى إبداعا ولا يمكن أن يكون أصيلا، فهو مجرد صناعة، والصناعة الخبرية التقليدية المعروفة في الصحافة والإعلام تجمع بين ما ترسله وكالات الأنباء للمحررين وما يمكن أن يضيفه المحرر للتوسع، فالعملية أشبه بإعادة تدوير المعلومات المخزنة، وهذا تماما ما يفعله الذكاء الاصطناعي، إذ يصنع الأفكار النقدية ويحلل ويعيد الصياغة ويدقق استنادا إلى الكم الهائل من المعلومات المخزنة لديه، غير أن هذه العملية تبقى مزيفة.
ويمكنك التأكد من زيفها عندما يقوم العقل البشري بقراءة العديد من الكتب والبحوث، فحينها يصبح مثل صنبور للمعلومات، لكن ليست معلومات معاد تدويرها، إنها أفكار أصلية تمتزج فيها تجربة الكاتب مع تكوينه الفكري ومع ما قرأه وشاهده، وهذه ليست كتلك.
وبدأ تطور الذكاء الاصطناعي في منتصف القرن العشرين، وكانت البداية الرسمية عام 1956، عندما تم تنظيم مؤتمر "دارتموث" في الولايات المتحدة، وفي هذا المؤتمر استخدم جون ماكارثي، وهو أحد مؤسسي الذكاء الاصطناعي مصطلح "الذكاء الاصطناعي" لأول مرة، وطرحت فيه أفكار أساسية حول كيفية محاكاة الذكاء البشري باستخدام الآلات، وهذه الأخيرة تعود دائما بالنفع على من اخترعها، لكنها لا تعود بالضرورة بالنفع على المستهلك، وإن بدا أنها كذلك في عصر السرعة، خاصة و أن المستهلك مغربي ونسخ قبل التكنولوجية من مقالات غربية.
ولا بد أن ندرك أن الشعب المغربي وخاصة النقاد وكتاب السينما المغربية، لم يستخدموا هذه التكنولوجيا بنزاهة، وذلك لسببين، فالسبب الأول أن أغلب من يكتبون تجاوزوا الخمسين وعفى عليهم الزمن حين كان الورق والقلم هما الوسيلتان الوحيدتان للكتابة، فكان رصيدهم من المقالات بمقدار عدد شعرات الأصلع إن وجدت، أما السبب الثاني فهو ظهور الكتابة بالذكاء الاصطناعي، حينها عاد هؤلاء من الظل ليساهموا مجددا في الصحف والجرائد التي تعتمد على دعم الدولة، والذي بدونه يتشرد طاقمها في الشوارع، ولكن ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن تأتي من قلم تقاعد نسبيا في عز عصر الحبر؟ فهل يمكن أن يبدع في زمن تقول فيه للذكاء الاصطناعي: كن فيكون؟
وبما أن جمعية نقاد السينما المغربية تقاعدوا قبل سن التقاعد، فلا بد أن يظهر بطل من جيلهم عائد من الظل لينتقدهم، لكن ليس بقلمه الحر، بل بالذكاء الاصطناعي، فهو يخبرهم بأنه كان عاجزا أيام الريشة والمداد عن إبداع فكرة يرد بها عليهم عندما كانوا يسخرون من أفلامه التجارية، فعاد اليوم لينتقم، ولم يعد معتذرا، لأنه امتلك سلاحا وجده ليشفي غليله، بينما الغرض الأساسي من النقد والكتابة هو إثراء المشهد السينمائي والفني المغربي بثقافة أصلية نابعة من أفكار وتجارب حقيقية، يكون مصدرها الأساسي الكتاب ثم الورقة والقلم، فهذا هو التفرد الوحيد المتبقي في مأساة الكتابة بالذكاء الاصطناعي.
لكن الأمر لا يتوقف هنا، خذ لحظة وتأمل أغلب الجرائد الإلكترونية و حتى الورقية التي تخفي الإلكتروني راقب كيف يعمل المحررون، ولن تجد من يكلف نفسه خلق تفرده في عصر الزيف، بينما الواقع نجد فيه تناقضات مشابهة في العلاقة بين النقاد والكتاب المغاربة وصنّاع الأفلام اليوم، فأغلبيتهم أصدقاء أولا، ثم يبررون مقالاتهم التطبيلية بحجة ضعف أو غياب الإنتاج، أو يبررون مواقفهم بأن السينما المغربية تحاول ولا يمكن مقارنتها بالإنتاجات الضخمة العالمية، وقد تتساءل ربما هم على حق، ثم تكتشف أن أغلب تلك المقالات والتصريحات كتبت تحت تأثير "ماء الحياة" أو تأثير العملة الصعبة. والكـارثة أن يكون أحدهم ناقدا سينمائيا ولا نجد له مراجعة فيلم واحدة في الأسبوع أو حتى عبر العصور، والأسوأ من ذلك أن يمارس النقد الفني على الآخرين وهو نفسه منتِج لأعمال صنعت في "الصين الخاصة بالعالم العربي"، أي بتخفيضات خاصة للمطبلين، عشاق المال والقنينة وعظمة قارون.
وفي خضم هذه المآسي السينمائية والفنية والثقافية، ورغم الجدل الواسع حول تفاهة الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية، لا سيما على القناة الثانية، فمن يقرأ أساسا تلك المقالات النقدية ليميز إن كانت أصلية أم مزيفة؟ هؤلاء لا يقرؤون إلا التطبيلات والتهويلات التي تكتب عنهم، مثل وصف المخرج بالعظيم والممثلة بالاستثنائية القادمة من كوكب زحل، أما حين يصادفون فجأة عنوان مقال نقدي يحمل إشارة سلبية، فإنهم يتجنبونه، لأن ما يهمهم حقيقة ليس ما يكتب عنهم، بل عدد الشيكات التي يتلقونها فور انتهاء كل فيلم سينمائي أو تلفزيوني أو مسرحي أو مسلسل درامي أو سيتكوم، أما أن يقف أحدهم عند سؤال: ما الجدوى من هذا الموضوع في هذا الفيلم؟ وما القيمة المضافة التي أضافها هذا الممثل أو ذاك؟ فلا تنتظر اهتماما، وامض كما مضى أولي العزم من قبلك.
إن العديد من نقاد وكتاب السينما الذين ألفوا كتبا قديما، كانت أعمالهم مليئة بالثغرات والمهازل، فتخيل أن تجد كتابا دون مصادر أو مراجع، ومؤلفه يحمل لقب دكتور! أو أن تجد كتابا يضم مجموعة مقالات نقدية غربية مسقطة على الأفلام المغربية بشكل فج، وهذا مكشوف علنا، حتى في تلك الخطابات التمجيدية التي نسمعها أثناء العروض الأولى للأفلام أو عند فوز أحدها في المهرجانات، بينما الحقيقة أن النقد السينمائي والكتابة في هذا المجال، إن لم تكن نابعة من تجربة شخصية وتنطلق من رؤية ذاتية تجاه الأمور التي يشاهدها الناقد، فلا داعي للكتابة أساسا، سواء عبر التكنولوجيا الحديثة المتخصصة في الكتابة أو بالقلم والورقة.