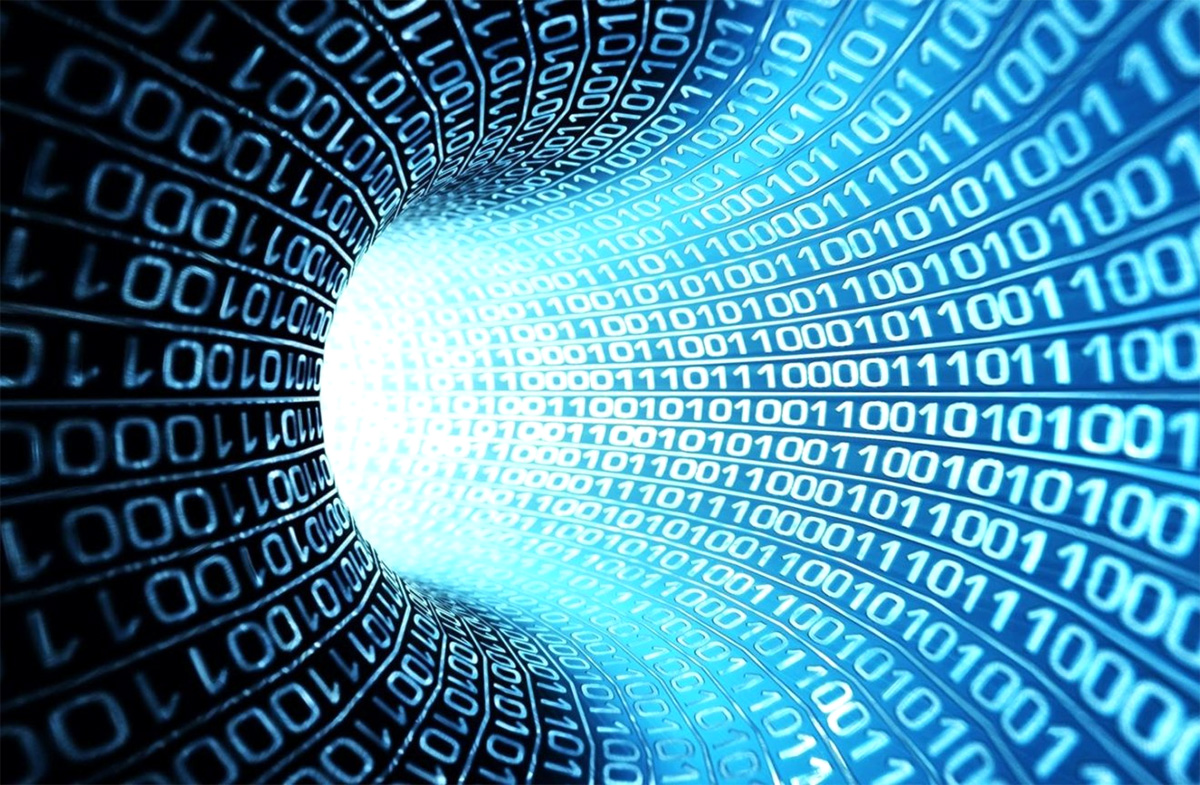الغواية في الثوب المرقمن
يتافخر الكثير عند إعطاء أنفسهم أهمية زائفة، وحينها يحاولون بشتى الطرق إقناع الآخرين أنهم أحد نجوم سماء محيطهم الاجتماعي، أو حتى قد تخطوه للمجتمع بأسره. والعاقل، بالتأكيد، يسمع أو يشاهد ويصمت، متمنياً للمتفاخر الشفاء من متلازمة جنون العظمة التي يعاني منها.
وعلى النقيض، نجد هناك فريقاً آخر من ضعاف النفوس يصدقونهم لدرجة التعايش والاحتفاء، ثم الخوض في تجسيد نفس ملامح الشخصية المريضة بكامل حذافيرها، وقد يزيدون عليها بطريقة تتناسب ومدى شعورهم بالدونية؛ فكلما زاد الشعور بالدونية، زاد جنون العظمة. وبذلك، ينتقل المرض النفسي "جنون العظمة" من شخص لآخر، وينتقل كالنار في الهشيم، ويصير جزءا من الصعاب والتحديات التي يجابهها السوي في حياته العامة، ويجب أن يتعامل معها بذكاء، وإلا دمره عقد نقص الآخرين.
وعلى الصعيد الآخر، هل تعتقد أنه سوف يأتي اليوم الذي يتمنى فيه جميع الأفراد، على حد سواء، التواري عن عيون الآخرين، لدرجة تملكهم رغبة ملحة أن يصيروا نكرة لا يهتم أحد لأمرهم بعد أن أعطاهم المجتمع أهمية حقيقية لا تنبع من الإصابة بمرض جنون العظمة؟
على ما أعتقد، أن هذا اليوم ليس بالبعيد؛ فلقد وفّر العالم المرقمن، الذي نعيش في حواشيه حالياً لكل إنسان شهرة واسعة دون أن يدري، وأعطاه كل الأهمية، لدرجة أن تلك الأهمية صارت طوقاً مسلطاً على الرقاب، ولجاماً لكبح جميع التصرفات.
ففي حياتنا العادية، من أجل أن نحيا في أمان وسلام، تم تزويد الشوارع والبنايات والمحال بكاميرات مراقبة؛ لضمان اكتشاف الجرائم والسرقات، والحد من ارتكابها. فمثلاً، لو حدث أن ركن أحد سيارته في المكان المخصص لك، لسوف تعلم ذلك بكل سهولة بمجرد إعادة شريط الكاميرا. الشيء نفسه ينطبق على من صدم سيارتك، أو اقترف جريمة سرقة. فجميع الوجوه صارت مألوفة لدى الجميع، ومن السهل تتبع الأشخاص بمجرد تغذية الكمبيوتر بالقليل من بياناته. وكما تحرسك الكاميرات وتزيد من أمنك، فإنها أيضاً تصعّب مسألة تواريك عن الأنظار والهروب من مكان لآخر دون أن يعلم طريقك أحد.
عالمنا المرقمن الجديد فتح أمامنا عالماً ساحراً لم يكن لنسمع عنه إلا في الأساطير، وروايات الخيال العلمي
أما جوجل، محرك البحث الأشهر عالمياً حتى الآن، فلقد صار يتبع جميع تحركاتك أينما ذهبت. فهو يساعدك في اختيار المواد الإعلامية التي تتوافق وذوقك الشخصي، بل ويمدك بالإعلانات التي تتوافق مع متطلبات حياتك الشخصية بمجرد انتقالك من مكان إلى آخر.
وكيف يعلم جوجل أنك انتقلت؟ الإجابة على الفور ستكون بسبب هاتفك النقال الذي يخترق جميع خصوصياتك - بما في ذلك موقعك - مهما حاولت أن تكبحه. فبمجرد أن توصله على شبكة الإنترنت، إعلم أن تحركاتك وبياناتك صارت معروفة، وأن هناك سجلاً يكتب لك، كما لو كان الملكان (عتيد ورقيب) قد كلفا أشخاصا في الأرض تنوب عن أداء مهمتهما الخاصة بمراقبة وتسجيل جميع تصرفاتك وتحركاتك.
أما معرفة ميولك الشخصية، وذوقك العام والخاص، فصار أسهل شيء يمكن اختراقه. فبمجرد ضغطك على أي اختيار، أو بحث عن أي شيء، يعمل جوجل على تخزين تلك المعلومة، ويبدأ في الإلحاح عليك أن تبحث عن المزيد عنها، بطرح العديد من الاختيارات الشبيهة. أي أن جوجل صار يقوم بدور "الغواية" التي يقوم بها الشيطان للإنسان. فلو حدث مثلاً وأن أصابك الفضول أن تبحث في موضوع ما مخالف لميولك الشخصية، لكنك لوهلة أردت معرفة المزيد عنه، لسوف تجد العديد من لموضوعات الشبيهة يتم طرحها عليك. وعندئذٍ، تجد نفسك قد وصلت لمفترق الطرق: فإما أن تواصل الانغماس في البحث في هذا الموضوع الذي قد يكون مخالفاً للأعراف أو حتى القانون، لمجرد الفضول، أو تهمل البحث في المزيد من الاختيارات التي يتم طرحها عليك.
الغريب أنه في كلتا الحالتين، قد تم تسجيل اهتمامك بهذا الموضوع حتى ولو لوهلة، والذي قد يفسر فيما بعد – حينما يحين الأوان لاكتشاف مدى أهميتك - على أنه معاناة من انحراف مزاجي مفاجئ، حين نبذك للموضوع، أو ميل للانحراف النفسي والخلقي.
أما الطامة الكبرى التي تسهل تضييق الخناق عليك من كل جانب، فهي وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق "الفيسبوك". فلقد صار "الفيسبوك" عدو الإنسان الأصيل الذي يُظهر له دوماً وجها زائفا من الصداقة والاهتمام، في حين يكرس نفسه لتدبير المكائد له. فبدون علم الأفراد، يفاجئنا تطبيق الفيسبوك من آن لآخر أنه يخترق خصوصياتنا من خلال الوسيلة الإلكترونية التي نستخدمها لفتحه، سواء أكانت الهاتف النقال أو جهاز الكمبيوتر.
وفي حال الهاتف النقال، تصير الكارثة أكبر؛ حيث يخترق الفيسبوك اختياراتك فيمن تتفاعل معهم من أفراد سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في سجل الهاتف. ويخزن كلمات سر دخول المواقع المختلفة، ومنها البريد الإلكتروني، أو الحساب البنكي، أو الصفحة الشخصية لك بالمؤسسة التي نعمل بها، وغيرها الكثير من المواقع المهمة. وبدون علمك، يفاجئك الفيسبوك من وقت لآخر باختراقه لملفات صورك الشخصية، وتهديدك بأنه لسوف يستخدمها بالطريقة التي تناسبه ما لم تفعل خطوات محددة. وبالطبع، ترضخ لهذا التهديد، وتبدأ في اتباع تلك الخطوات، التي – على النقيض – تساعد على تمكين الفيسبوك من تلك الملفات بشكل نهائي.
ثم يبدأ الفيسبوك بإغرائك في عمل اختبارات شخصية ونفسية تخبرك بأشياء محببة لقلبك وتحب أن تسمعها، من خلال لمسها لمرض جنون العظمة الكائن في كل شخص؛ فمثلاُ، تخبر شخصا قاسيا متبلد المشاعر أنه حنون؛ أو شخصا تعوزه الوسامة بأنه شبيه بأكثر نجوم الفن وسامة؛ أو شخصا مؤهلاته الشخصية متواضعة بأنه يصلح لاعتلاء وظيفة مرموقة. وبينما يستمتع الشخص باللعب وسماع ما يريد أن يسمعه، يقوم الفيسبوك باختراق جميع البيانات الشخصية المتواجدة على الجهاز الذي يعمل عليه بصورة فجة بعد أن يستأذنك بعفوية في السماح له بالوصول إليها، وبالتأكيد، توافق دون أن تعطي للأمر أهمية لتشوقك لخوض التجربة.
يعتقد الكثيرون أن حياتهم وأفعالهم ليست ذات أهمية، فيتركون العنان للفيسبوك والتطبيقات الشبيهة له في أن تفعل بهم ما تريد. المشكلة أنهم لا يعلمون أن تلك البيانات التي قد تبدو لهم تافهة، ستكون ذات أهمية على المدى البعيد. فالجميع على الفيسبوك ليسوا معصومين من الاختراق مهما كانت الاحتياطات التي يتخذونها، فلقد عزم القائمون على الفيسبوك من جعل جميع البشر عبيداً له ورهن إشارته. وعلى سبيل المثال، لم يتوقع أحد أن أقطاب التكنولوجيا الرقمية حالياً، وهما بيل جيتس Bill Gate وإيلون ماسك Elon Musk، أن يتم اختراق حسابتهما الشخصية مؤخراً على الفيسبوك، ولك أن تتخييل مدى ما يتخذونه من احتياطات.
حتى لو اخترت العيش بدون وسائل تواصل اجتماعي، وعدم امتلاك هاتف نقال، وعدم استخدام الإنترنت في حياتك الشخصية، فإنك لست معصوما من وضعك تحت طائلة المراقبة التي تزداد يوماً تلو الآخر في الشوارع، والمتاجر، ووسائل المواصلات، ودور الترفيه. ولو علمت أن حامضك النووي وخريطتك الجينية صارا مستهدفين، لأيقنت أنك في خطر داهم. فلقد بات من السهل الوصول للحامض النووي والخريطة الجينية لأي شخص ليس فقط عند إجراء التحليلات الطبية، بل من خلال شعر الرأس الذي يتساقط في الأماكن العامة. واستخدام الحامض النووي والخريطة الجينية للأفراد دون علمهم هو خطر حقيقي؛ لأنه على أقل تقدير قد يستخدم في إجراء عمليات استنساخ دون علم الأفراد. فجميع هذه البيانات، والاكتشافات يتم حالياً تكديسها ومراكمتها لاستخدامها يوماً ما في أغراض قد تقلب موازين القوى في يوم من الأيام، كما حدث في فضيحة الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة.
لقد وصل الإنسان لطريق مسدود، فهو واقع تحت خيار التفكير في كل خطوة يخطوها لدرجة قد توصله للإصابة بمرض جنون الارتياب الذي قد يتفاقم ليصير مرضا نفسيا عضالا، أعلى مرتبة من الوسواس القهري. ومن ناحية أخرى، قد يُصر الإنسان على أن يعيش حياته ليستمتع بكل ما يطرح عليه من تكنولوجيات ووسائل ترفيه لتمضية الوقت، وحينها قد يستقيظ على كارثة قد لا يستطيع الخروج منها أبداً.
عالمنا المرقمن الجديد فتح أمامنا عالماً ساحراً لم يكن لنسمع عنه إلا في الأساطير، وروايات الخيال العلمي. وكل يوم نستيقظ على اختراع يفوق السحر إتقاناً. لكن أيضاً مع كل صباح، يجب أن ننتظر كارثة في الطريق إلينا، تحاك دون علمنا. وفي خضم هذه الفوضى الكارثية من النعم المبطنة بالنقم الحتمية، تصير الحقيقة مشوشة وينمحي الخط الفاصل بين الواقع والخيال، والخطأ والصواب. وعلى الرغم من ذلك، تظل هناك حقيقة واحدة يجب الإيمان بها لدرجة اليقين، ألا وهي: "يوماً ما لسوف ينقلب السحر على الساحر."