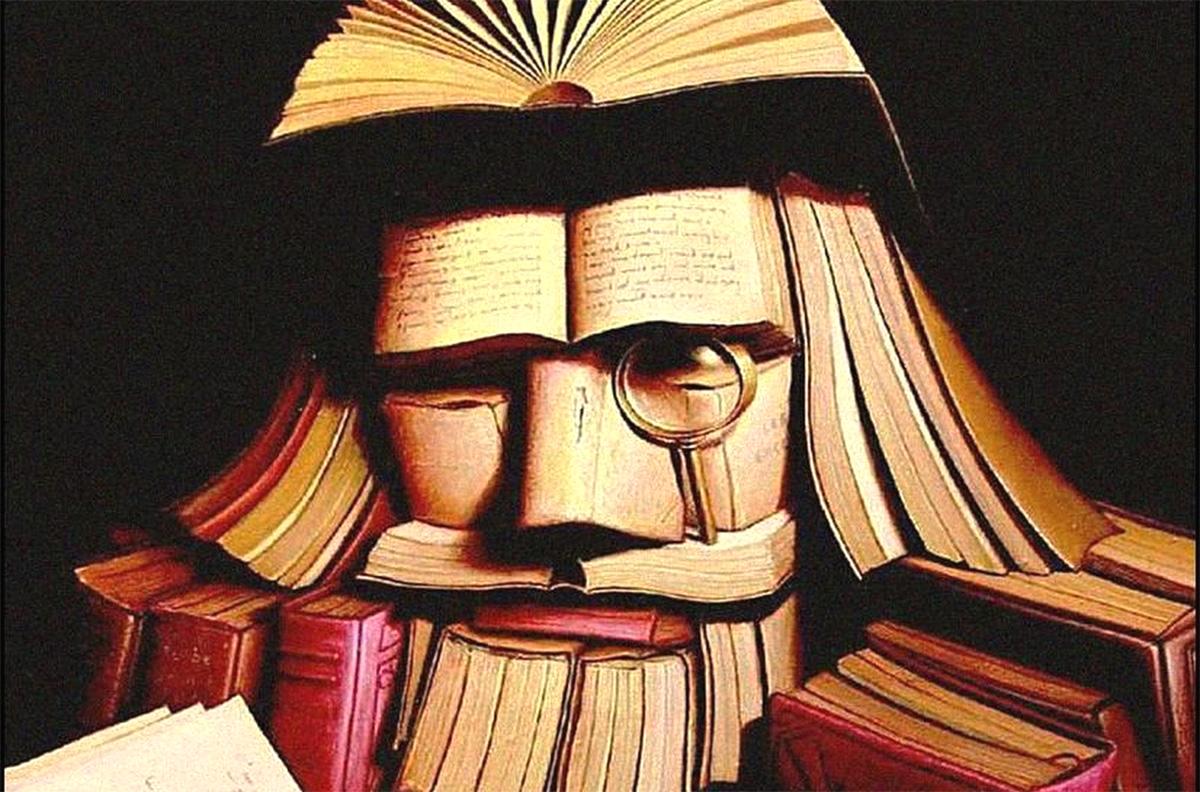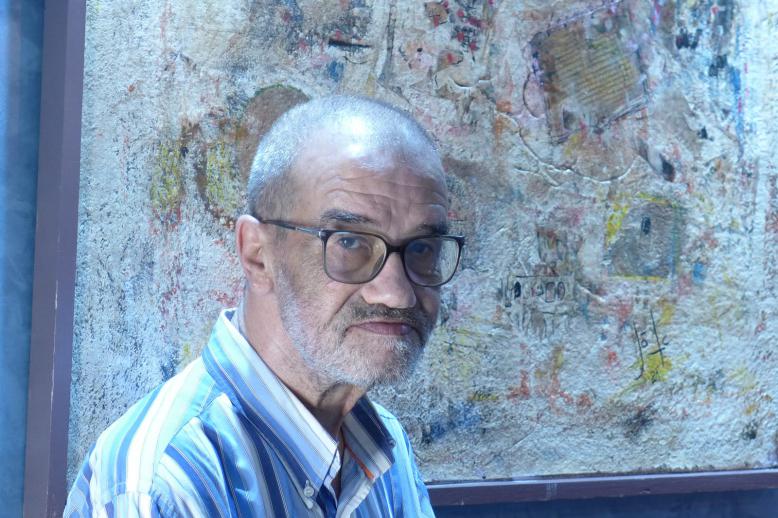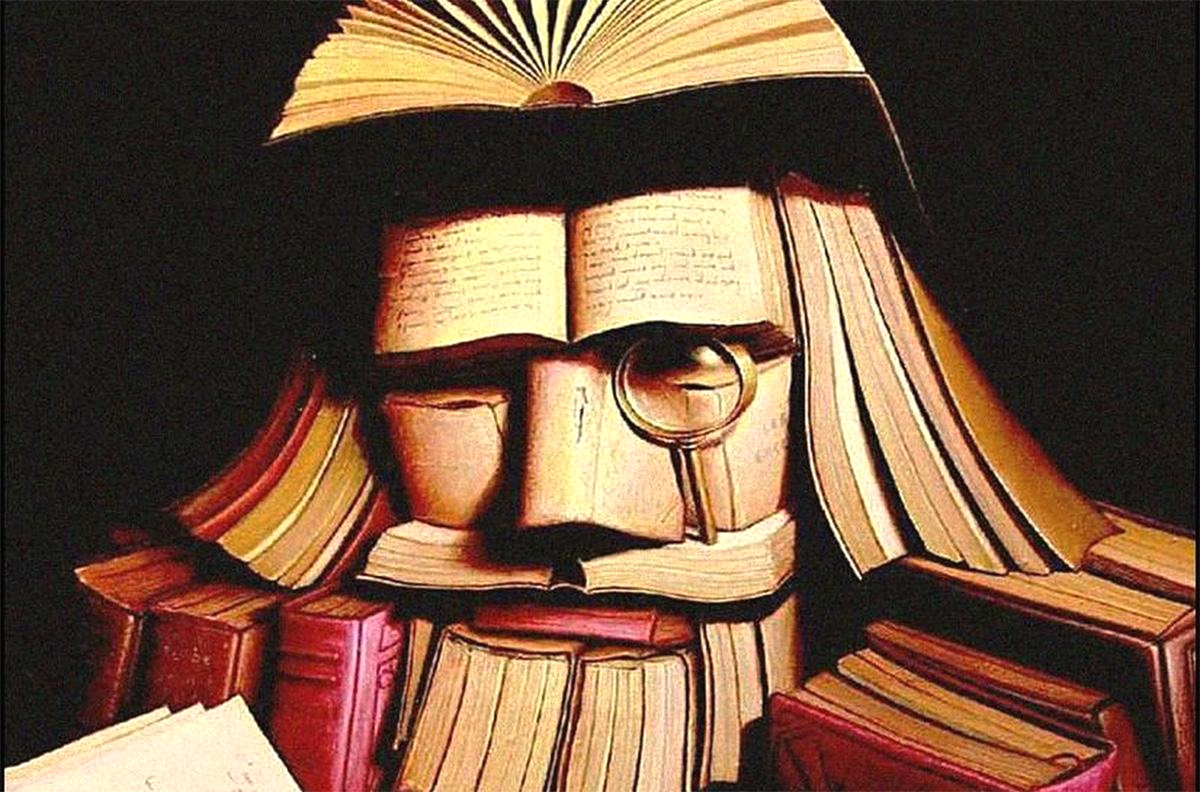المثقف وإشكالية الحضور الشكلي
مع وفرة القنوات والمنابر الإعلامية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يسمى بالإعلام البديل، أصبح الاهتمام مُنصباً على الصورة كونها معبرةً عن خصائص حركة الحضارة، وحاملة لقيم ثقافية، كما هي صانعة لرغبة المُشاهد، إذ لا تجدُ شريحة أو فئة اجتماعية تُريدُ المُحافظة على زخم حضورها وتأثيرها بديلاً لثقافة الصورة لتحقيق هذه الغاية، لذلك هناك تنوع كبير في الفضائيات التي تَبثُ برامج مُختلفة وتعتمدُ على وسائل معينة لكسب مزيد من المُشاهدين، وتنتقل الخلافات الاجتماعية والسياسية والمذهبية إلى فضاء الشاشة، لذا تُساهم القنوات الفضائية في ضخ المواد التي تقود المُشاهد إلى أفق مسدود في مدار تفكيره ما يجعله أكثر تعصباً وجمودا في نظرته إلى القضايا الخلافية ويتزودُ بِمُفردات يعيدُ توظيفها عبر خطاب شفوي ضد غريمه السياسي أو المذهبي.
وفي هذا الأمر ما يُعللُ تصاعد التشنج الطائفي وظاهرة التكفير وشيطنة الآخر، في ظل هذا المناخ المصطخب بخطابات مُتنافرة يأتي السؤال عن موقع المُثقف؟ هل هو مرغم على الاندماج في الخط السائد أو لديه اختيار ليميزَ مساره الخاص ويخرج من هذه السيولة الإعلامية؟ هل يختار الانعزال ويقتنع بحالة الاغتراب السلبي؟
قبل البحث عن الرهانات المُتاحة أمام المثقف، لا بُدَّ من فهم دور المُثقف وتحديد المعايير التي يجب أن يلتزم بها كفاعل اجتماعي، إذ ثمة من يعتقدُ أن وظيفة المثقف هي مجرد التفكير واجتراح المفاهيم التي تُعين على إعادة قراءة الواقع ومساءلة المسلمات وبالتالي الخروج من حالة الدوكسا. غير أنَّ هذا القول عن المثقف لا يستوفي كل ما يُطالب أن ينهض به.
المثقفون لهم حضور إعلامي وصوري لكن تأثيرهم الفعلي غائب، كما أن آلياتهم لقراءة الواقع تعتورها أعطاب بنيوية
لأنَّ دور المثقف في رأي سارتر يتجاوز وظيفة انتقادية ليكونَ ملتزماً بأفكار وصاحب رسالة مُعينة، كما أن المثقفين بنظر أنطونيو غرامشي لا يُشكلون طبقة مُستقلة بل كل فئة اجتماعية تعمل على خلق مُثقفيها، بمعنى أنَّ المُثقف لا يمتلك أي امتياز على غيره باشتغاله في الحقل الفكري، وهذا ما يؤكد عليه الفيلسوف اللبناني علي حرب من خلال نحته لمفهوم المثقف العامل، فالأخير لا ينفصلُ عن المجتمع ويتخلى عن وهم النخبوية، كما لا يحقُ له الادعاء بأنَّ المعرفة ملك يمينه دون غيره، لأن المعرفة - بتصور حرب - لم تعدْ من شأن القنوات التقليدية بل أن نشر المعرفة أصبح في قبضة الإعلام الذي يتكفل بشبكاته بإنتاج المعلومات وصناعتها.
هكذا يبدو أن المُثقف في عصر التكنولوجيا الرقمية واقع في المأزق ولا تصلح أدواته وعدته المعرفية والفكرية للبحث عن الموقع والدور، ربما يوجد من لا يوافق هذا الرأي ويحتجُّ بوجود المثقفين وحضورهم في منابر إعلامية، متخذين لأنفسهم ألقاباً وصفات عديدة كالمفكر والمُحلل والمُتابع، صحيح هذا حضور شكلي وصوري إن صح التعبير، وغالباً ما تكون مشاركاتهم متسقةً مع سياسة القنوات التي يظهرون عليها، وبذلك يتداعى تماسكهم الفكري، وينهار رأسمالهم الرمزي، من هنا يفقد المثقفُ رمزية يستمدها من انحيازه إلى شرائح لا تجد من يُمثلها، إذ يبحثُ عن دور على هامش القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى، عندما يفشلُ في أن يتحول إلى قوة موازية على أرض الواقع، بجانب ذلك يتخبط المثقفون في مستنقع الازدواجية، فإن ديباجاتهم عن الحداثة والتنوير لا تُخفي ما هو ثاوِ في تلافيف عقولهم من نزعات قبلية ومناطقية ومذهبية.
وهذه الظاهرة التي ينطبع المثقفُ بلونها ليست حكراً لِجغرافية معينة بل تنبه بعض فلاسفة الغرب لشيوعها، لذلك يصفُ المُفكر الفرنسي جوليان بيندا المثقفين بخونة الروح كما يُحَملهُم كارل بوبر من جانبه مسؤولية المحن والمصائب التي حلت بالبشرية، عبر إثارة الأشخاص ضد بعضهم البعض باسم المذهب والأيديولوجيا والقومية. وفي هذا التوصيف يتفقُ لينين مع بوبر إذ يعتبر الأول أن المثقف أقرب الناس إلى الخيانة، ويجندُ عدته المعرفية لتبرير مواقفه المُتقلبة.
كشف الكاتب البريطاني كريس نايت ازدواجية أبرز المثقفين المُعاصرين وهو نعوم تشومسكى الذي يُعدُ مدافعا عن الشعوب المظلومة مناهضاً للحروب التي تَشنها أميركا، وفي الوقت نفسه يعملُ في خدمة الأبحاث العسكرية للجيش الأميركي، وهذه المُهمة مناقضة تماماً لمواقفه المُعلنة ضد الهمينة العسكرية لأميركا.
هنا نطرح سؤالاً هل هناك وصفة لمعالجة هذا التناقض في المواقف كأن نقول بضرورة فصل الآراء والفكر عن المهنة والاهتمامات الأكاديمية؟ لا نعتقدُ بأنَّ مثل هذه المبررات مُقنعةُ أو تُحافظ على مصداقية الآراء، ومن يتابعُ مواقف المُثقفين أثناء التحولات التي يشهدها العالمُ والمُجتمعات يُصادفُ تراوحهم بين الاتجاهات المُتناقضة، إذ نادراً ما تَجدُ بينهم من يُفضُل التأمل في المُعطيات والمستجدات قبل أن يشرعَ في تفسيرها ويَتخذَ حولها الموقف ويقدم تحليلات مُسْتَعْجِلة إذ تبدت هذه الثغرات في أنماط التفكير والرؤية لدى المُثقفين خلال ما مرت به بعض المجتمعات من تجارب ومحاولات لإنهاء نموذج الأنظمة الاستبدادية. ما إن انتكست تلك المحاولات حتى بدأت زمرة المثقفين بإلقاء المسؤولية على عاتق الشعب لما ظهرت من عوارض التطرف وتفشي العنف، كأن الشعب محكوم بأن يختار بين طريقين لا ثالث لهما، إما أن يكون مقتنعاً بالحكم الديكتاتوري بكل ما يحمله من الموبقات والسلبيات، أو يجرفه التطرفُ إلى المجهول.
هذا النسق من التفكـــــير لدى نخبة المثقـفين هــــو ما يُضيق عليهم أفق الرؤية، وينزع منهم القدرة الاستشرافية، لذلك يَسْتمرُ دورانهم في إطار مُغلق من دون أن يعثروا على ما يُمَكنهم للخروج من الصيغ الوصفية.
على ضوء ما تقدم سلفاً يتضحُ انحسار فعالية المُثقف وعجزه عن إدراك معادلات الواقع، لذلك لا نستغربُ إقبال الجماهير على من يتبنى خطابات شعبوية وهي بدورها تؤسس لثقافة القطيع وزعامات صوتية، ونحن موضوعنا عن المُثقف وتأثيره، لا ضير بأن نذكر موقف أحد أشهر المثقفين في القرن العشرين وهو سلامة موسى الذي يصرحُ بأن خمس عشرة مجلة وجريدة كان يشرف على إصدارها قد حظرتها السلطة بتهمة انحيازها للشعب، ولك أن تقارن بين تأثير المثقف كما مثله هذا الكاتب المصري وما يُمثله المثقفون في أيامنا، إذ أن ما يشغلهم هو إطلاق التصريحات التي تخطف لهم الأضواء، من دون أن تفتح دائرة نقاش وسجالات جادة.
عوداً على البدء نقول بأن المثقفين لهم حضور إعلامي وصوري لكن تأثيرهم الفعلي غائب، كما أن آلياتهم لقراءة الواقع تعتورها أعطاب بنيوية لذلك فهم في هذه المرحلة حاضرون بالشكل ومُتغيبون بالفعل .