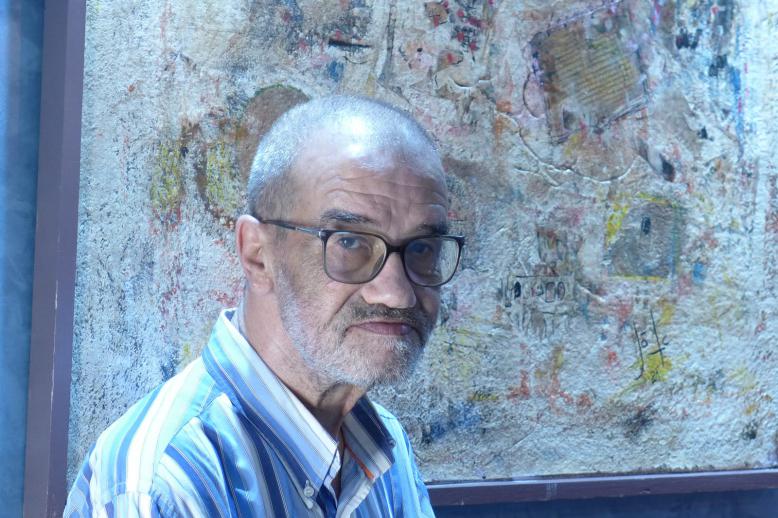الملحون المغربي والمقام العراقي
يرى الكاتب والباحث المغربي محمد بوعابد في دراسته عن الملحون المغربي، أن نشوءه في واحات تافيلالت قبل أكثر من ستة قرون، وفي مدينة سجلماسة تحديدا، وهي ثاني مدينة إسلامية تشيد في المغرب، وقد انتقل الملحون منها إلى مدينة مراكش الحمراء، التي احتضنته على يد شيوخها، وبعد ذلك نقلته إلى الربوع المغربية كفاس ومكناس ومدن أخرى، حيث وجدوا في طرب الملحون طاقة ثقافية وإبداعية. يعبّرون من خلاله عن عواطفهم وهمومهم، وقد حاول الباحث بو عابد أن يجري مقاربة بين شعر الملحون وبين الشعر العربي القديم، حيث يرى أنه امتداد لذلك الشعر، وقد اختار قصيدة المرسم التي تحاكي قصيدة امرئ القيس في الوقوف على الأطلال، كدلالة على مدى تأثر شعراء الملحون بشعر القدماء، ويستخلص من ذلك أن الملحون كمادة شعرية، هو نتاج لتجذر الشعر العربي في المغرب وبلاد الأندلس:
"حيث التشابه على مستوى الأشكال الفنية وتقارب الصيغ العروضية، فبعض الأشكال شبيهة إلى حد بعيد بالشعر العمودي.. وأخرى تتقاطع مع الموشح الأندلسي "
ثم تناول الباحث نشوء الزجل، وهو ضرب من الأنواع العروضية المعروفة، وكيف تحول المعنى إلى أن الزجل هو الذي يتوسل أصحابه في كتابته باللسان المغربي المحكي،حيث استخدمت اللهجات الدارجة التي امتزجت باللغة العربية الفصحى، لتكوّن لغة متوسطة بين العامية المحكية والعربية المكتوبة والمنطوقة في إطارها التعليمي والديني.
خروج الملحون والمقام من سطوة المكان سيجعلهما أكثر شعبية، وهذا يعتمد على التبادل الثقافي والفني بين البلدين، كي يتعرف العراقيون على فنون أشقائهم في المغرب، وفي الوقت نفسه، يتعرف المغاربة على فنون أشقائهم العراقيين في بغداد
وغناء الملحون يعتمد على الزجل الذي أفاض الباحث في الحديث عنه، وهذا الغناء الطربي يصاحب الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية والتي تستخدم فيها الأدوات الموسيقية المتنوعة، ومنها العود والكنبري وهو أداة وترية أيضا. إضافة إلى البندير والكنبوز والتعريجة والربابة.
يتميز منشدو الملحون بأنهم يولون أهمية للكلمة ودلالاتها، بنفس القدر الذين يولونه للموسيقى والصوت، وكأنهم يصنعون من اللغة موسيقى خاصة بها، لذلك فإن "القطعة الغنائية لطرب الملحون" تبدأ بالسرد القصصي لحكاية أو رواية من بدايتها إلى نهايتها، وهذه الحكاية موزونة ومقفاة وتعتمد على الأوزان العروضية الخفيفة، وقصائد الملحون تعتمد على طرح الكثير من القيم والعبر والمفاهيم التي تتعلق بالحياة وتجاربها، وتتخذ مسار الرواية التي تصل إلى ذروتها بعد مخاض وحبكات وعُقد، وتنتهي بالخاتمة التي تتفاعل أكثر، حتى أن نغمات المنشدين تميل إلى السرعة لختام هذا الكورال الجميل الذي يتناول قضايا شائكة، مثل أغنية الشمعة التي كانت تتسرب إلى أعماق النفس الإنسانية، لتسفح الكثير من زوايا العتمة فيها، وتكشف الهموم والمتاعب والقدرة على التحمل في صراع الإنسان مع ما يحيط به، كما يتناول الملحون قضايا العشق بمعناه التصوفي الذي يعتمد على الذوبان في المعشوق. ولذا فإن جمهور الملحون ليس من العامة، بل من النخبة المثقفة التي تدرك ما يختزنه الزجل من المعاني العميقة. إنه سحر الطرب الأصيل الذي تتعانق فيه الكلمة بالموسيقى في هارموني جميل.
ثمة قواسم مشتركة بين الملحون المغربي والمقام العراقي، تجعلني أضعهما جنبا إلى جنب من ناحية تاريخية النشوء، فالدكتور محمود أحمد الحفني يتحدث عن الفنان منصور زلزل، وهو أشهر عازف عود في الدولة العباسية، والذي نهض بالموسيقى العربية من حيث التجديد والابتكار، وقد كان معاصرا لإبراهيم الموصلي وهو أستاذ عبقري الموسيقى الأندلسية زرياب، الذي هاجر إلى الأندلس هربا من العراق، واستطاع أن يؤسس هناك معلمة غنائية وموسيقية.
ترى الباحثة العراقية في الموسيقى الأستاذة فاطمة الظاهر، أن تاريخ المقام يعود إلى العصر الأول للخلافة العباسية، وذلك من خلال المخطوطات التي ألفها بعض الأعلام في مجال الموسيقى، وقد وصل إلينا شفاها بعد أن تناقلته الأجيال، ولكنّ ظهور المقام على هيئته التي نراها اليوم، فيعود إلى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، حيث تطور المقام وأصبح يُدَرّس في بعض المدارس الخاصة، ولكنه ازدهر في بغداد في أوائل القرن العشرين، وأصبح يمثل غناء المناطق الحضرية في المدن الكبرى ولاسيما بغداد، ويقابل الغناء الريفي الذي اشتهر في الريف وانتقل إلى المدن، وتمضي الباحثة فاطمة الظاهر في تعريف المقام، على أنّه لون غنائي يتكون من مجموعة من الأنغام المترابطة والمنسجمة مع بعضها البعض، وهو قالب غنائي، وليس سُلّما موسيقيا كما يتبادر إلى الذهن، فهذه القوالب هي مقامات غنائية ولا تُغنّى إلا في العراق، ويسمى مؤدي المقام بالقارئ، لأنه يقرأ المقام دون مصاحبة إيقاعه.
وكما في الملحون المغربي فإن المقام العراقي يغنى بالشعر الدارج أو العامي ويسمى بالزهيري، الذي يعتمد على الجناس والإكثار من الاستعارات، ولكن أغلب المقامات الرئيسية تستخدم الشعر الفصيح ولاسيما عيون الشعر العربي التي لها علاقة بالغزل والفخر.
ولكنّ المقام لم يحافظ على صفائه اللغوي، فقد ازدحمت نصوصه المغناة بكلمات ومقاطع تركية وفارسية، وذلك نتيجة لسيطرة العثمانيين على العراق، ودخول مفرداتهم إلى مجمل الحياة، ومنها الأغاني والمصطلحات الموسيقية. وإذا كان الملحون يتسارع إيقاعه في نهايته القطعة الموسيقية والغنائية، فإن المقام ينتهي عادة بـ "البستة"، وهي مقطوعة خفيفة ومتلائمة، ومن نغم المقام نفسه الذي أنشده القارئ، وعادة يغنيها الأعضاء العازفون ويشاركهم الجمهور أحيانا، وللبستة متعة ينتظرها المستمعون، لأنها تسعى لجعل المقام أكثرَ تنوعا وفرحا.
ويبدو أن المقام العراقي والملحون المغربي واللذين تجمعهما صفات مشتركة، يعانيان الآن من عدم الاهتمام في الأوساط الفنية، بعد أن أصبح الفن الهابط هو البضاعة الرائجة في سوق الفن. كما أن الملحون بقي أسيرا ضمن المغرب فقط، ولم ينتقل إلى البلدان العربية. لذلك فأغلب أهل الشرق لم يسمعوا به، إلا من خلال أغاني فرقة جيل جيلالة.
ويصح القول على المقام العراقي الذي بقي ضمن رقعته الجغرافية ولم يمتد إلى البلدان العربية، ولاشك بأن الكثير من المغاربة لم يسمعوا به أيضا، إلا من خلال بعض أغاني المطرب ناظم الغزالي.
لذلك فإن خروج الملحون والمقام من سطوة المكان سيجعلهما أكثر شعبية، وهذا يعتمد على التبادل الثقافي والفني بين البلدين، كي يتعرف العراقيون على فنون أشقائهم في المغرب، وفي الوقت نفسه، يتعرف المغاربة على فنون أشقائهم العراقيين في بغداد.