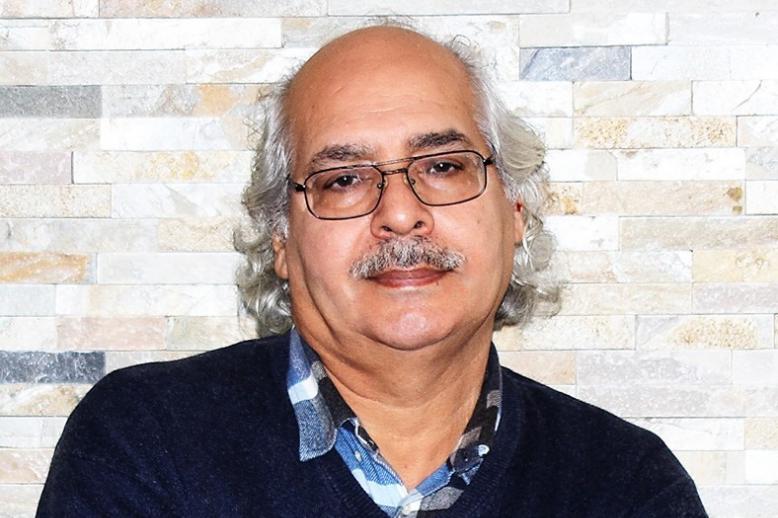الوصايا والأناشيد في زمن كورونا العنيد
اهتراءٌ
قشرةُ الكوكبِ قد اهترأت، اهترأت تماماً، وما عاد بالإمكانِ رتقُها. فإمَا نسيجٌ جديدٌ، كُليةً، وإمَا عُري ثوبِ الملك الأحمق الأعمى. أجلْ، لقد حانت ساعة الانكشاف، وعرفنا أننا غدونا، جميعُنا، حُفاةً عُراة، جميعُنا بلا استثناءٍ واحدٍ!
الوصايا العشر لمن يريد النجاة
1- لا تُعطِ من نفسِك لأحدٍ.
2- لا تتوهمْ، أبداً، أن أحداً سوف يُعطيك من نفسِه.
3- لا تظن في نفسِك القدرة على عمل شيء، فلا شيء يمكن عمله حيال أي شيء.
4- لا تفترض، ابتداءً، أن ثمة ضرورة لعمل أي شيء، أو أن هذا الوجود يتأسس على الوعي بضرورةِ العمل أو العمل انطلاقاً من الوعي، فلا وجود، بالمرة، لشيء كهذا.
5- لا تنتظر أن تتغير أحوالُ الحياة، أو تتبدل طبائع الناس وأخلاقهم على نحو ما تأمل، فذلك الذي تأمله لم يحدث من قبل، ولن يحدث مستقبلاً.
6- عِشْ في الظلِ، ما استطعت، واحتجبْ عنهم، جميعاً، كإلهٍ أُحيل إلى التقاعد.
7- فلتحرصْ، قدر طاقتك، على تصفيةِ روحك من الانفعال والتعاطف، وعلى تنقيةِ نفسك من أوزار الحبِ والكرهِ والإشفاق وشهوة الانتقام.
8- الزمْ الصمت العميق، وجُد عليهم، بين الحين والآخر، بابتسامة تهكم خفيفة تليق بما يقترفون من ألعاب الصغار، وتفاهاتهم.
9- فلتحيا في الأبديةِ، لا في الزمانِ ولا في المكانِ، ولتعلمْ أنه ليس ثمة، في حقيقة الأمر، لا غد ولا أمس، لا هناك ولا هنا.
10- أخيراً، فلتبقِ بمتناول يدك، كل الوقت، قرص سيانيد، أو شريط حبوب منومة، أو ربما مسدس صغير محشو بطلقةٍ وحيدة تعرف، جيداً، كيف تطلقها على رأسك، بنجاح، حين تدعو الحاجة.
الوجود البشري قد اقترن، ومنذ اللحظة الأولى له على سطح هذا الكوكب، برغبة التعبير عن ذاك الوجود، الأمر الذي دفع أجدادنا الأوائل إلى اختراع وسائط التواصل
ثلاث خطوات للاكتفاء
الخطوة الأولى: فلتتعلم كيف تعي أن ما بين يديك يكفي تماماً.
الخطوة الثانية: فلتتعلم كيف تعي أن لا شيء يكفي، بالمرَة.
الخطوة الثالثة: فلتتعلم كيف تعي أن الكفاية، في حقيقة الأمر، تقبع بعيداً بعيداً، فيما وراء الوفرة والعوز معاً.
في رثاء يوري جيفاجو
وهكذا، لم يتبق لك، من بعد كل هذي المآسي التي كابدتَ، كل تلك الحروب والثورات التي في شباكها علقتَ، كل الأفراح والمسرات الصغيرة التي جربتَ، كل هاته النسوة والجميلات اللاتي أحببتَ، وكل هذه القصائد الحزينة البديعة التي كتبتَ، سواي؛ أنا قارئك الأخير، الشاهد البائس على كل ما كان، على كل ما هو كائن!
وهكذا، لم يتبق لك، من بعد كل ما ذكرت، وكل ما غفلت عن ذكره، سوى قلب عليل واهن، كان محتماً أن ينفجر في صمت مخجل، وأنت تحاول النزول، بأقصى ما تستطيع من سرعة، على درج حافلة عتيقة، كي تلحق بظلها، المخايل المراوغ، لتحقق حلمك، الأخير، بأن يكون طيفها، العابر، آخر ما تبصره عيناك، الغائرتان في محجريهما، قبل أن تجمدا للأبد!
وهكذا، ما تبقى لك، من بعد كل بعد، سوى حقيبة مهترئة من جلد ودم متخثر وعظام، ملقاة فوق إفريز حجري، يعبره السابلة بنظرات ذاهلة عجول، وببعض إشفاق أو جزع، وبعمى فادح عن إبصار تلك الهوة المتوسعة من تحت أقدامهم؛ الهوة المفتوحة، بلا نهاية، على الفزع الأكبر، وعلى الصمت الرحيم!
قوة التخلي
لن تحوز ما تريد حتى تريده حقاً، لكنك لن تعرف كيفية أن تريد قبل أن تفهم، حقاً، سر ألا تريد، بالمرَة. وهكذا تُشيد قوة المرء، وقدرته على السيطرة على الأشياء، عبر إرادة قتل الإرادة، حيث يتلاشى ويختفي، بصمت وهدوء ومن دون ألم يُذكر، سحر الاشتهاء، جاذبية الرغبة، وغواية الاحتياز. يختفي كل شيء ويتلاشى على نحو طبيعي تماماً، لا كما يُقتلع سِنٌ معطوبٌ من لثة ملتهبة متورمة، بل كما تسقط ورقة شجر ذابلة يابسة من فوق غصنها، أوان خريفها، بقوة الشوق إلى توديعِ الغابة وحياتها.
أجلْ، فلتطمح حتى الحدود القصوى للطموح البشري؛ حد التوحد بموضوع الطموح والتماهي التام معه، حد ابتلاعك له وابتلاعه إياك، حد احتيازه عبر نفيه الذي هو، من الزاوية المقابلة للنظر، نفيك أنت بالذات، أو حد التخلي عن كل طموح في الأفق يلوح، وهذا هو سلاحك السري ، لو أنك تعلم، أيها الغافل!
نشيد الأناشيد
ها قد غاب النهار، وجن الليل، وآبت الطيور إلى أعشاشها والوحوش إلى أوكارها، لكنك بعد لم تعودي!
قطعت شوارع المدينة أفتش عن ظلك. قصدتك حيث تعيشين، وحيث تُقبرين.
ابتعتُ ذكراكِ من الحوانيت القديمة، ومن الدروب العتيقة، لأزرعها في تربة الرجاء، وانتظرتُ صيف الكرمة.
صليتُ صلاتي، قرأتُ كتابي، ومتُ موتي، لكنك لم تعودي!
سينقضي الليل، عما قريب، ويلتمع الفجر المخضل بالندى. سأقطف نجمة الصباح الساهرة، وأسلكها عقدا من فحم وألماس، أغزلها وشاحا من فضة وضياء.
وعندما يُعاود النهار المغيب، سأجلسُ على عتبة الدار أنتظر عودتك، عارفا أنك، أبدا، لن تعودي!
أبدية
كأسٌ من الشاي الخفيفِ المُحلَى، ترشفُه بتلذذٍ هانئ، وأنتَ تُجالِس كتابَك على طاولةٍ رخاميةٍ عتيقة، في هذا المقهى البحري القديم، بشرفاتِه المُشْرعةِ على المدى الأزرق، والنوارسُ الجائعةُ للسمكِ الصغيرِ وللعُلو... هي كلُ ما لديكَ من أبدية!ٍ
ربما ليسَ أبداً
بكيفيةٍ ما، عرف دائماً أنَه سيواصلُ العيشَ، حتى بعد أن يوسدوه الثرى المبتلَ، ويسدوا أمامَه بوابةِ الخروجِ الأخيرةِ المُقَببة، فالعناصرُ الاثنان والتسعون التي يزدحم بها وجوده، من قبلِ أنْ يوجَد، والمُدرجةُ ضمن قائمةِ الدوامِ الكوني، غير قابلةٍ للتلاشي. لا، لم يكن السؤال يبحث فيما إذا كان سيبقى، أم سيفنى، بل في إمكاناتِ وطبائع البقاء. وكذلك لم يكن سؤالاً عن المغزى أو الغائية، وإنما عن الطريقةِ والكيفية. فكَر بأسى في هذا الجنسِ البشري الأحمق؛ في همومِه ومساعيه وشغفِه لاستجلاءِ المصير وإدراكِ معنى الوجود، في تنقيبِه البائس في حفرياتِ البداياتِ، وفي تحديقِه اليائس بجِنانِ الأكوانِ والنجمات، وفي لا يقينية كلِ يقينٍ يبدعه له شوقُه وولعُه!
- إذن، أراكَ قد وضعتَ قدماً بين أولئك المؤمنين ممنْ تُنكِر عليهم إيمانَهم. تهانيَ.
تذوق بأسى صامتٍ رزين الطعمَ المالحَ لسخريتِه المُعتَادة. سرح ببصرهِ في اتجاهِ الموجِ المُنقلبِ زبْداً مِلحياً يشي بهشاشةِ العناصرِ التي يتدرع، عقلياً، بخلودِها وبلا نهائيتِها. زفرَ بصوتٍ لا يكادُ يَبين:
- ليسَ بعد يا صديقي، وربما ليسَ أبداً.
السير والطريق
ثلاث مراحل من عمرك، ثلاثة مواقف من الحياة:
- أن تكون شاباً، فتشعر أنك عائش إلى الأبد، وتؤمن بواجبك في، وبقدرتك على، تغيير العالم.
- أن تغدو رجلاً، فتدرك أنك واحدٌ بين مليارات الآحاد، وأن العيش مهمة بالغة الصعوبة، وأن الطريق بلا نهاية، وتروح تتساءل عن إمكانية، وكذلك جدوى، محاولاتك المضنية لإعادة رسم الخرائط وتعبيد السُبل، لتقنع، في النهاية، بوعد خجول، قد تزجيه لك الحياة، عن إمكانية فهم الحياة.
- أن تصير شيخاً، فتعرف أنك لست كائناً، أنك لم تكن أبداً، في حقيقة الأمر، وأنه لا وجود لأي وجود، لا من قبل، ولا من بعد، وأن كل شيء سادر في الحلم الضبابي الأزلي، ثم ترتاح، في نهاية النهاية، إلى قاعدة خلاصك الذهبية؛ ما أروع الإغفال، ما ألذ النوم من دون أحلام!
الوجود والكلمات
دائمًا، وبمواجهة آلاف الكتب، ملايين الصفحات الورقية والإلكترونية، وأطنان الكلمات التي استهلكت كل مداد البحر، أقف متحيرًا، مشدوهًا، وعاجزًا عن إيجاد إجابة، نهائية ومقنعة، لسؤال يظل يلح على عقلي:
من أي نبعٍ، غامضٍ، تنهل تلك الرغبة الحارقة، لدى الإنسان، في اقتراف فعلة التعبير، الإشاري والرمزي هذه، عن الذات عبر الكلمات؟
أستغرب قول من يرى أن الوجود البشري قد اقترن، ومنذ اللحظة الأولى له على سطح هذا الكوكب، برغبة التعبير عن ذاك الوجود، الأمر الذي دفع أجدادنا الأوائل إلى اختراع وسائط التواصل، بداية عبر الأصوات والهمهمات وإيماءات الجسد والحركات الإيقاعية والتعبير بالتجسيم أو التصوير....إلخ، وصولاً إلى ابتكار الحرف المشحون بطاقة صوتية ودلالية ومفهومية لا تستنفد، وليس انتهاءً بإعلان بعض مفكري ما بعد الحداثة بشأن موت اللغة وقيامة بلاغة الصمت.
حقيقة الأمر، بالنسبة لي، أن الوجود لم يكن في حاجة، لازمة، للتعبير عن وجوده، وأنه قد عرف أزمنة لاستمرار الوجود في حالة انعدام التعبير، ولم يتهدد ذلك الوجود بالتعرض لأية سكتة قلبية، ما يعني أنه قابل لتكرار الأمر. صحيح أن تلك الحالة من صمت الوجود لطالما وُصفت بأنها بدائية، لكن مثل هذه الأوصاف ربما لا تعني ما هو أكثر من تدليل آخر على ميلنا، هل أقول الغريزي؟ للاستنامة للعادة والمألوف، أمَا لو دققنا النظر قليلاً فقد نكتشف الطاقة، الرهيبة والسحرية واللا محدودة، المختزنة في الصمت والفراغ من كل تعبير عادي ومألوف.
وفي هذا السياق، أعاود النظر في مثل تلك الأوقات، المدهشة والثرية، التي يشير إليها المتصوفة والروحانيين، عند استسلامهم لحالة الصمم والخرس الكلامي، خلال معارج الروح. كذلك فإني أراجع التفكير في أزمنة الموت الكتابي، التي كثيراً ما تقبض على روح بعض كبار المبدعين، وتقهرهم على التزام الصمت التام. وليست حالة ليو تولستوي، الناثر الأعظم ربما في تاريخ النثر القصصي الإنساني، وإصراره على التزام الخرس الكتابي لسنوات عديدة، وبالرغم من إلحاح أعظم معاصريه عليه للرجوع عن ذلك، بالبعيدة، ولا بالفريدة، في هذا الصدد.
تساؤل أخير:
هل يمكننا مواصلة الوجود من دون تلك المقدسة الطارئة المسماة الكلمة؟
جواب أخير:
ربما لا يمكننا ذلك، وحسب، وإنما يتوجب علينا اجتراح هذه المهمة الجليلة!
آهٍ، ما أروع ذلك الصمت الشامل حين يلف فراغ الوجود الشاسع اللا نهائي!