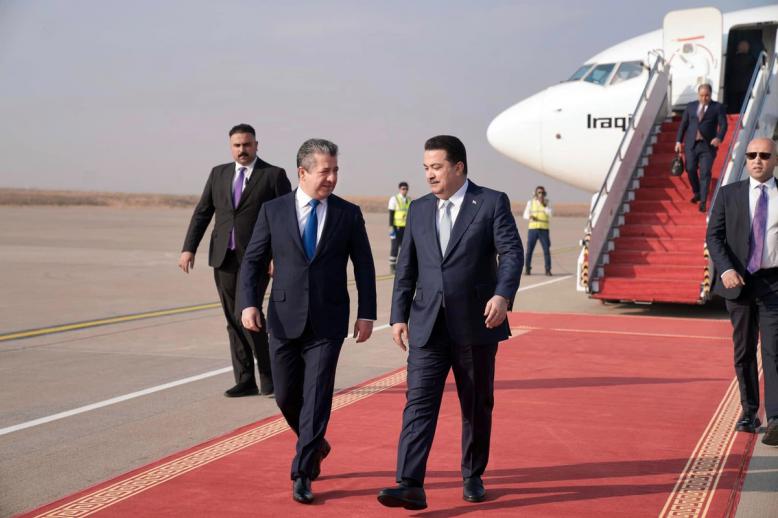جمهوريات عربية أمام تحديات فاصلة
فجرت أحداث العراق ولبنان مرة أخرى الكلام حول مصير بعض الجمهوريات العربية، بعد أن طرح على نطاق واسع منذ تسع سنوات عندما اندلعت ثورات وانتفاضات واحتجاجات في عدد من الدول أسقطت أنظمة تمترست في الحكم سنوات طويلة. وبصرف النظر عن دوافعها والأسباب والتدخلات التي رافقتها، فهي أنهت حقبة اعتمدت فيها الحكومات على قوتها الباطشة، ونجا منها من استجابوا إلى تطلعات وأحلام شعوبهم أو امتلكوا مؤسسة عسكرية وطنية حافظت على أمن واستقرار البلاد.
بدأت الموجة الحالية مع تعاظم الاحتجاجات في السودان والجزائر، فسقط نظام عمر البشير، ودفعت قوى الحرية والتغيير نحو تشكيل حكومة مدنية، ورحل قسرا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ولا تزال الجزائر في مرحلة مكابدة، طرفاها المؤسسة العسكرية والقوى المدنية، غير أن الطريق الذي دخله الطرفان قد يؤدي إلى انسداد حقيقي، ويمكن أن يعرض البلاد لاهتزازات تستمر وقتا، حتى يتمكن أحدهما من حسم الجولة لصالحه، بضربة قاضية أو عبر سياسة تسجيل النقاط التي تقود إلى انحسار أحدهما وإقرار بالهزيمة أمام الآخر.
تبدو تطورات الحالة في العراق ولبنان بحاجة لمزيد من الوقت كي تتبلور فكرة رشيدة لمصير الجمهوريتين، لأن الركائز التي يعتمدان عليها جذورها ممتدة في الشارع، ويستغرق تبديلها تحولات كبيرة في العقلية والهيكلية السياسية، ما يمكن حدوثه لاحقا، حيث يتطلب التغيير الذي ينشده المتظاهرون في البلدين وجود طبقة قادرة على تقديم شخصيات لامعة وأحزاب تستطيع تعويض الفراغ المتوقع، إذا أدى الحراك الراهن إلى نتيجة إيجابية وتغيير التوازنات التاريخية، وتسليم الجماعات الحاكمة بسهولة، لأن الجمهوريتين تستندان على قواعد متعددة، سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية، تفوق كثيرا المنطلقات التي ساقها المحتجون.
ويجد هؤلاء دعما مباشرا وغير مباشر من جهات خارجية، وتفاعلا لافتا من قبل دوائر مختلفة، اتساقا مع الجاذبية الفطرية التي تمثلها الكثير من الانتفاضات الشعبوية، حتى ولو كانت أهدافها غامضة، أو تقود لمجهول بسبب عدم الجاهزية السياسية وتعارضها مع بعض الثوابت الوطنية، فالطرب الحاصل مع كل تظاهرة في أي مكان في العالم يدفع نحو تشجيعها قبل معرفة الطريق الذي سوف تسلكه بعد هدوء العاصفة، أو انتظار تقنين الحراك وبلورته في شكل مطالب عاجلة واضحة المعالم والأهداف والنهايات.
ترسل هذه النوعية من التطورات إشارات قوية بشأن مستقبل ما تبقى من جمهوريات في المنطقة، لأن موجة الاحتجاج والتظاهر إذا انطفأت لن تعدم العوامل الداخلية التي تتغذى عليها، ولن تفتقر للتشجيع الخارجي اللازم لاستمرار تدفقها، ولن تتوقف الجماهير عن المطالبة بالتغيير، فلم يعد التضييق في مجال الحريات مجديا في ظل تعدد البدائل المتاحة، وفترت أهمية القبضة الحديدية، ولن تستطيع مجاراة طوفان الانتقادات الحقوقية المسيّسة، ولذلك أصبح التسريع بخطوات الإصلاح الجذري عملية ضرورية، فأي علاج شكلي قد يحقق هدفه لمدة قصيرة، لكنه سيفقد مفعوله مع أول محك جماهيري.
اذا كانت بعض الدول العربية نجت من الموجة الأولى لتماسك مؤسساتها الحيوية، فإن الموجة الجديد تعتمد على خلخلة الأرض من تحت أقدامها تدريجيا، لتفقدها العافية التي تتمتع بها، حتى إذا جاءت اللحظة المناسبة تكون فقدت جزءا كبيرا من أجهزة المناعة التي حمتها سابقا، ما يستوجب الحرص الدائم على الجاهزية وتقوية البنى الرئيسيّة من خلال توفير خطوط حماية للدفاعات المنوط بها مهمة التصدي للحفاظ على قوام الجمهورية.
تتجاوز عملية الحماية الشق الظاهر للقوة في شكله الأمني والعسكري، وتصل إلى الوجه الصاعد لها، والخاص بإعداد الدولة وتعضيدها بصورة محكمة تساعدها على سد الثغرات والفجوات التي تسقط بها الأمم. وأعني بها القوام السياسي الجاد الذي يملك قدرة فائقة على مواجهة أي ارتدادات من الداخل والخارج، فعندما يحتمي نظام جمهوري بجملة من الثوابت التي تتجاوب مع تطلعات الشعب ويشعر أنه جزء أصيل في معادلة الحكم وفاعل وليس رقما هامشيا لن يخرج عن طوعه، أو يتجاوب مع أي تحريض يأتي من هنا وهناك، ولو فعلت ذلك شريحة فيه سوف تكون هناك شرائح أكبر قادرة على ردعها من دون لجوء إلى حشود مفتعلة تتسبب ممارساتها المنفلتة في خسائر.
من يمعن النظر في طريقة تعامل المدافعين عن النظامين في لبنان والعراق وخروجهم للتصدي للجماهير الناقمة عليهما، يجد أن بعض التصرفات أججت الاحتجاجات ولم تخمدها، ومدت المتظاهرين بعوامل قوة لم تكن مأخوذة في الحسبان. فقد انكسرت حواجز الخوف، وسقطت جدران عديدة للصمت، ودخلت اللعبة فضاء رحبا من المناورات المتبادلة، يكسب فيها من لديهم خطابات متماسكة، ومن يملكون الأدوات الإبداعية التي تساهم في زيادة رقعة الرفض وتوسيع نطاق النقمة والغضب.
سقطت أنظمة عندما تجاهل حكامها توفير الحد الأدنى من المطالَب السياسية، والتي لا تقل أهمية عن توفير المأكل والملبس والمشرب والرغبة في الخروج من حلقات الفقر المدقع، ونهضت أخرى عندما استوعبت العبر والدروس، ولم تتكاسل عن الإحساس بنبض الناس، ومن يضربون مثلا بأن هناك أنظمة ديكتاتورية باقية ولم تسقط لمجرد أنها تسد رمق رعاياها، فهم غافلون عن حركة التاريخ، حيث يتأخر الحساب السياسي، غير أنه لا يموت وستأتي لحظة مكاشفة ولو بعد حين، لأن أنماط الحياة تتغير بشكل سريع، واحتياجات البشر تتبدل، وتطلعاتهم تتزايد مع ارتفاع مستوى التواصل والعلم والمعرفة.
يخطئ من يتصورون في العراق ولبنان أن الحساب النهائي لن يأتي، ويخطئ أكثر من يعتقدون أنهم قادرون على خداع الناس طوال الوقت، ولو كان هذا أو ذاك مبني على نوايا حسنة، فالنتيجة واحدة في الحالتين. تخلف وربما تدمير للقوى الحية في المجتمع، وفقدان الكثير من وسائل المقاومة للاستهداف الذي يتصاعد، ويجد في عوامل التدمير الذاتي فرصة لتحقيق أهدافه، فقد ابتليت بعض الدول العربية بقيادات أخطر من الأعداء، تتفنن في توفير الذرائع للخصوم والمنافسين، وما لم ينهض هؤلاء من كبوتهم ويتلمسون خطوات الإصلاح الحقيقي ستواجه شعوبهم مصيرا قاتما.