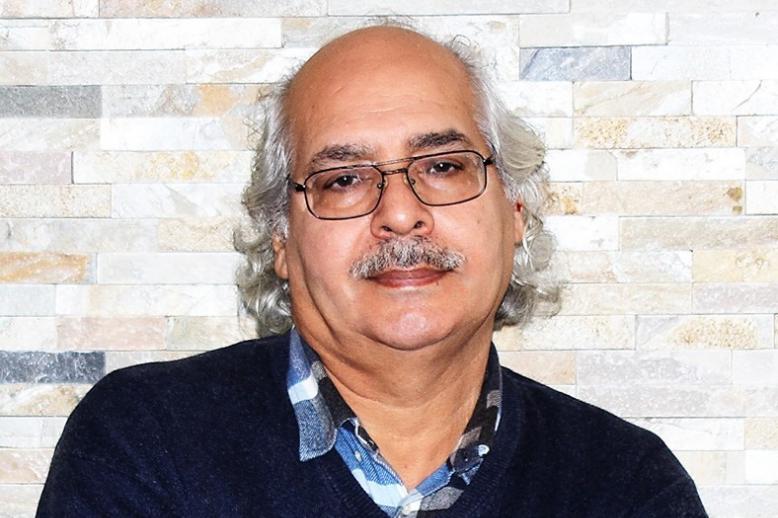ديانة الكورونا
(1)
بعد أسابيع من العزل الذاتي بالمنزل، استجابة للتعليمات المشددة بتوخي الحذر من الإصابة بالعدوى الكورونية، كوني واحداً من كبار السن ومن الذين يعانون مرضاً مزمناً بالقلب معاً، أجدني مندفعاً لتحدي كل هذه التعليمات، وللإطاحة بكل تلك المحاذير والتنبيهات، والخروج، مرة أخرى، لملاقاة الشارع.
تلوح الحياة، لي، ماضية في طريقها المعهود، وبرغم كل شيء. وتبدو الشوارع، لعيني، قادرة على استيعاب حركة الناس وامتصاصها ولفظها، كعهدها، حتى لو بقيت المقاهي والمطاعم مغلقة، وحتى لو نعمت قطارات ترام الرمل، أخيراً، بعدم تكدس ركابها فيها، أو غدت الحركة المرورية، على الطرقات والمحاور، أكثر سلاسة وأشد انسيابية.
نعم، هي الحياة تدافع عن وجودها الذاتي بقواها الذاتية، وهم أبناء النوع العاقل يستمسكون، وإلى الرمق الأخير، بكل ما عهدوه وأحبوه في حياتهم، البائسة العابرة المغوية الجميلة تلك؛ أعني بمجرد الحلم والمخايلة بالعيش، وبفرحة استقبال عيد يُراد لهم أن يراجعوا النظر في أفراحه، إذا ما أرادوا أن يحافظوا على حيواتهم وما تبقى من سنوات عمرهم.
أجول بسوق شيديا، المزدحم على عادته، فتتعثر خطواتي بخطوات المندفعين لابتياع حاجات العيد، مضافاً إليها مخزون الطعام الكبير، المطلوب لستة أيام تالية من الحظر والإغلاق شبه الكلي، كما تتعثر عيناي بعيونهم، التائهة المستطلعة الجزعة اللا مبالية الضاحكة الآملة والموغلة في محاولة استكناه ما يخبئه القدر، وكما تتعثر أذناي بنداءات الباعة، المتعالية المتصادية المنغمة الخافتة الشاكية المرحة المشبعة بحزن دفين عميق الغور والمتعلقة بأهداب أمل سري غامض في خلاص يجئ أو فرج يتنزل عليهم.
أعود إلى البيت مُحملاً بالخزين اللازم لاستقبال زياد وشيماء، اللذين صمما على عدم زيارتنا طول الشهر الكريم مخافة أن ينقلا إلينا دور الانفلونزا (هل هي الكورونا اللعينة؟) التي أصابتهما في بيتهما بالقاهرة، شاعراً بالانهزام الشخصي بعد قرار حنين ومحمد بعدم المجئ، خلال العيد، لاشتباههما بمخالطة أحد المصابين بالفيروس قبل أيام، ما يعني الحرمان من رؤية الحفيدة هَنا.
ديانة الركوع، في المعازل والكارنتينا الكوكبية، تحت أقدام عقل، جهنمي غامض، أكاد ألمحه قابعاً، بعيداً بعيداً، في غور كهف غروره واستعلائه وشهوته النخبوية للسيادة!
(2)
لأول مرة، ربما، خلال شهور الحظر الكوروني تلك، أراها ترتعد، وهي تتطلع نحوي، كمن يستنجد، قائلة:
- أنا خائفة.
كنتُ قد نقلت إليها، غير مرَة، أفكاري وتصوراتي حول الأمر. وكانت تشاركني شكوكي وظنوني، على الأقل في سياقها العام ومهما اختلفنا في بعض التفاصيل هنا أو الجزئيات هناك، لنمضي الأيام، الطويلة الثقيلة المنذورة للحظر والعزل البيتي، في نقاشات لا تنتهي حول معنى الحياة أو حقيقة الحب أو حدود الجمال، أو وبصفة خاصة، حول الكتابة الأدبية وأسرارها وتقنياتها، ثم حول الموت.
- لا أكاد أصدق أن شيئاً سيعود إلى ما كان عليه من قبل نزول هذه الجائحة على رؤوسنا.
تقول بهلع مستجد، فأرد ببرود رواقي معهود:
- لا شيء يعود، أبداً، إلى ما كان عليه، وهي مع ذلك تبقى، دوماً، على نحو ما عهدناها عليه، بشكل أو بآخر.
- لأول مرة، خلال تلك الفترة العصيبة، أدرك، الآن فقط، كم هي عصيبة حقاً. ليس الأمر أني خائفة من الموت؛ موتي شخصياً أو حتى، لا قدر الله، موت أحدكم أمام عيني، بل الخوف من الشعور، الصادم والكاسح، بانسداد الأفق أمامي كلية، فلا مستقبل يلوح ممكناً، ولا انشغال يبدو مقبولاً أكثر من مجرد تمرير العيش، يوماً بيوم، وساعة بعد أخرى، كما لو أني أطبخ لوجبة واحدة، من دون أن أفكر فيما ستأكلون، غداً أو بعد غد، كما اعتدت التفكير فيكم!
وكنتُ أفهم ما تعنيه كلماتها، المنزعجة المرتعبة، أو ما تعانيه هي، داخلياً، من حسٍ، كاوٍ ضاغط وساحق، بالصدمة!
كانت تحدِق، اللحظة، بعمق قرار هاوية الوجود، التي انفتحت، بغتة، أمام أعين الجميع؛ هاوية الرعب والتفاهة، انعدام المعنى وانسداد شرايين الرجاء، ويقين أن لا معين، لا رفيق،لا إله؛ فقط أنت والهباء، وحدك وقدر العدم.
(3)
بكيفية جهنمية، أدرك، بحزن وغضب، أنهم قد أفلحوا، معنا، في أولى تجاربهم السريرية الكوكبية، وأدخلونا، منصاعين مذعورين ومتضرعين، إلى عنبر العقلاء الكوروني.
بحزن وبغضب، أدرك أنهم قد اجتازوا، بنجاح لافت، أولى خطواتهم، المحسوبة المرسومة سلفاً، لإعادة برمجة وضبط الشخصية البشرية على موجة الهلع الوجودي، المطلق البدئي والخام، وعلى قبول الحصار، ومن ورائه الهزيمة الماحقة، أمام كائن، مجهري غامض، ليس أكثر من مجرد حامض أميني تافه يطمح إلى التشكل والسيرورة!
ما حقيقة الأمر؟
وهل يترنح، فعلياً، وجود ومستقبل نوعنا البشري، متخبطاً على حافة الوعيد بالفناء والاندثار؟
أمْ تُرى أن وراء الأكمة ما وراءها، ومَن وراءها؟
وما غاياتهم من ذلك كله؟
الحقيقة أني، كما غيري، لا أعرف على وجه الدقة. لكن ما لا حصر له، من الافتراضات والتكهنات والأفكار الشريرة، تظل تسوط مخيلتي، وتروِع عقلي...
مثلاً:
حروب ومصادمات، شبه تقليدية، وإن بأدوات وأسلحة فوق اعتيادية، من أجل إعادة رسم وتقسيم خرائط السيادة، بين القوى الكبرى المتنافسة على الصعيد الكوكبي، من أجل السلطة والثروة ومناطق النفوذ والاستغلال والهيمنة.
إطلاق، جرئ شيطاني ولا مسؤول، لقوى العلم وممكناته الرهيبة، يخرج عن حدود السيطرة البشرية، ويضع الكوكب رهينة لذكاء اصطناعي سري يتلاعب به، وفق قوانين وقواعد لعب غير مسبوقة، جينياً أو فيروسياً أو افتراضياً أو ما لا أعلم.
ديانة جديدة، ذات طبيعة عصرية، وبمخيلة وأدوات وتقنيات ما بعد حداثية، تخط ألواحها المقدسة ووصاياها المستجدة، بشفراتها السرية العلمية والرقمية، نخبة، عالمية غامضة، تفترض أن هذا الكوكب، الأزرق البديع البائس، قد شاخ بما لم يعد ممكناً الصبر عليه، وأن ثمة إجراء، قسريا شاملا ساحقا مفزعا ولا حدود لرهبته، قد بات ضروياً لإنقاذه من ذلك السيل العرم من سكانه العاقلين، المتكاثرين بشكل لا عقلاني يهدد موارده، المحدودة بطبيعتها، وإلا فهو الهلاك المحتم للجميع.
لست أعرف الغايات، هذا أمر مؤكد، لكني أقدر على تمييز جملة من العلامات والمؤشرات، ولربما كان من الأصوب القول حزمة من الأسئلة والاستفهامات، غير المعقولة ولا المنطقية، عند التمهل للنظر بالقضية بعد هذه الشهور من الصدمة والترويع، التي عشناها، وربما تلك السنوات من الهلع والامتثال، التي يراد لنا أن نتهيأ لنعيشها...
مثلاً:
كيف نفسر كل هذا الارتباك، وتلك الفوضى من التصريحات، والتصريحات المضادة، والنظريات، والنظريات المناقضة، التي يخرجون بها علينا كل يوم، بل كل أقل من ساعة، سواء بشأن منشأ الفيروس أو طبيعته أو خصائصه أو آثاره القاتلة أو طرق انتشاره والعدوى به أو حتى سبل الوقاية منه، ناهيك عن بروتوكولات علاجه، المعمول بها هنا أو هناك؛ وهي فوضى يقع فيها الجميع، عن قصور في المعرفة، أو ولم لا؟ عن فائض مخبوء وسري منها، ابتداءً من صغار الأطباء، وصولاً إلى أكبر المعاهد العلمية والجامعات والمنظمات الأممية المعنية بالأمر، وعلى قمتها، بطبيعة الحال، منظمة الصحة العالمية التي أخشى أنها تلعب دوراً غير علمي، بل ومن غير المستبعد أبداً، دوراً غير أخلاقي ولا إنساني بالمرة، في هذه الجائحة؟
وكيف نقرأ ذلك الاندفاع، السريع والمتطرف، الذي استسلم له غالبية قادة وزعماء الدول الكبرى الاستعمارية، ثم تبعهم الجميع على مستوى العالم، لإغلاق الكوكب كلية، ولإيقاف كافة مظاهر الحياة الاعتيادية، التي شق بها النوع العاقل طريقه التاريخي الشاق لعشرات الآلاف من السنين، ثم النكوص عما تم التواطؤ عليه، بجرة قلم وتصريح تلفزي، والعودة، بكل سرعة أيضاً، ساعين لإدارة عجلة الحياة اليومية، لمجتمعاتهم ولشعوبهم، لدواعٍ إقتصادية قهرية، أو كما يقولون؟
كذلك كيف يمكننا تمرير الوقائع، الصلبة المحددة رقمياً، بشأن إحصائيات الإصابات والوفيات ومعدلات التعافي الخاصة بجائحة كوفيد 19، والتي تفيد بأنه على مدار حوالي نصف سنة، فإن حالات الوفاة على مستوى العالم لم تبلغ حد نصف المليون وفاة، وأن معدلات الشفاء من المرض تدور حول نسبة الثمانين بالمائة من الإصابات، وأن معظم المتوفين هم من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ما يعني أن أمر الوفاة أو التعافي مرهون، إلى حد بعيد، بالمناعة الطبيعية لدى المصابين، وقدرتهم الذاتية على مقاومة الفيروس، الذي لم يحصد من أرواح البشر ما تعودت الانفلونزا الموسمية على حصده منها سنوياً، على الأقل حتى اللحظة الراهنة؟
أخيراً، كيف نفهم كل ذلك الاحتشاد والتجييش لوسائل وأدوات القهر والسيطرة، العقلية والنفسية والروحية، من ميديا، رسمية كانت أم غير رسمية، ومن مواقع للأخبار وللفنون وللتواصل الاجتماعي، ومن معاهد علمية وجامعات وأكاديميات، ومن جوامع وكنائس ومعابد وغيرها، لوضع سكان الكوكب، الأشقياء هؤلاء، في مصيدة الحظر والفزع والاستسلام التام لما يقال لهم من أقوال، مضطربة ومتعارضة كما لاحظنا قبلاً، ولتهيئتهم لقبول إما نهايتهم وتوديع أحبابهم، كما قالها بوريس جونسون صراحة، وإما الامتثال، المطلق العاري من كل قيد أو شرط، لما يأمرون به ويفرضونه عليهم من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، وليته يجدي؟
(4)
هي أفكارك وأوهامك وضلالاتك الذاتية عن مؤامرة مزعومة، تهرف بها، كما يهرف آخرون غيرك، وحسب!
سيقول لي قائل، وسأحاول أن أجيبه مخلصاً:
قد تكون. وصدقني فأنا لا أعرف إن كنتُ مصيباً، فيما أذهب إليه، أم أني غير ذلك. لكني أعرف، وبالمقابل، أنك بدورك، لا يمكنك القطع بما تعتقده في وترميني به، وأنت أعجز عن نفيه وإزاحته، ببساطة، كما لو أنه غثاء وحماقة لا معنى لهما بالمرَة.
وفي مثل تلك الأوقات العصيبة، أسعى وتسعى، ما وسعنا السعي، لاستعادة ضبط وبرمجة هويتنا الإنسانية على بوصلة وجود بدهية قلما تُخطئ سبل النجاة والوصول: الغرائز الأولية البسيطة، المنطق العقلي الصوري والاستدلالي والتجريبي والعلمي، والمبادئ الأخلاقية، المختبرة والمجربة والتي أبدعها وصاغها وصقلها ورسخها الجنس البشري عبر تاريخه الحضاري غير الطويل قياساً إلى عمر الكوكب.
لكن الخشية، كل الخشية، من مساعي أولئك الطامحين إلى برمجة هوية إنسانية جديدة غير تلك التي شذبتها قرون من الكدح والحلم والعمل والشقاء؛ أولئك المبشرين بديانة كوفيد 19 المستجدة؛ ديانة الركوع، في المعازل والكارنتينا الكوكبية، تحت أقدام عقل، جهنمي غامض، أكاد ألمحه قابعاً، بعيداً بعيداً، في غور كهف غروره واستعلائه وشهوته النخبوية للسيادة!