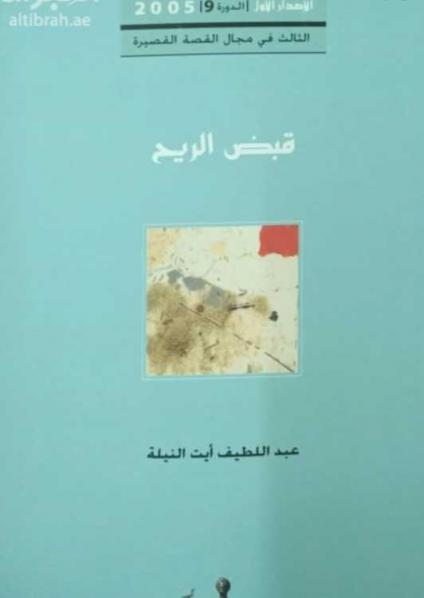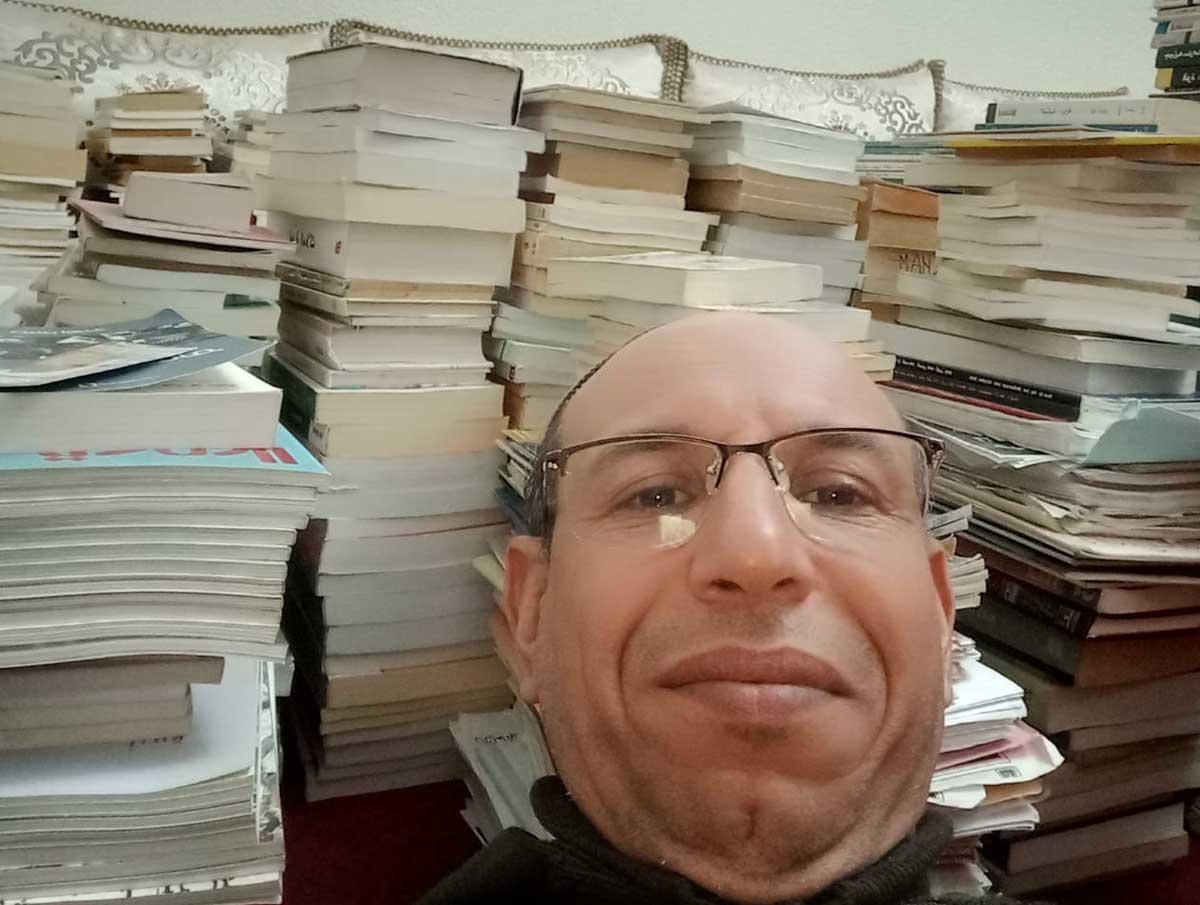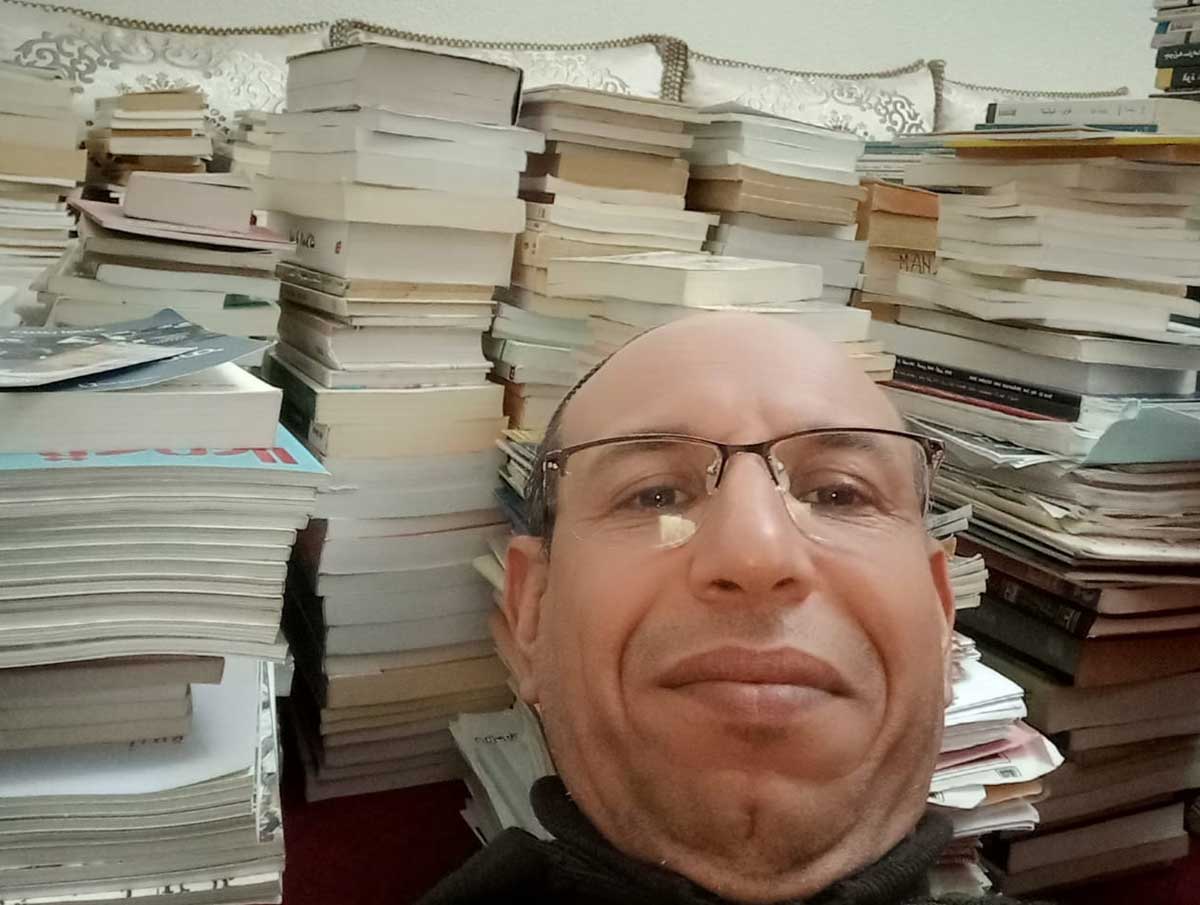عبداللطيف النيلة يدفع قارئ 'قبض الريح' لتجريدها من جلباب الرمز
للأديب المغربي عبداللطيف النيلة ولعٌ في كتابة القصة، حتى أنه حصد الكثير من الجوائز في المغرب وخارجه، وله ثلاث مجاميع قصصية، فالكتابة لديه على ما يبدو تأمل متروٍّ للحياة اليومية، وكأنه يقوم بعملية تعدين في أعماق شخوصه وهم في حالة اشتباك مع مصائرهم وأقدارهم، لذلك فإنه ينأى عن كتابة القصة التقليدية التي تقوم على قاعدة النمو الطبيعي للأحداث كي تصلَ إلى ذروتها، ولكنه تعمّدَ كسرَ هذه النمطية، حيث انتهج أسلوبَ منح الحدث حرية غير مشروطة، أي أن أحداث قصصه سائبة، دون نهايات معلومة، وقد يبدأ من نهاية الحدث ثم يصل إلى بدايته. وفي كل ذلك النسق ثمة نبضٌ حياتي يتحرك بتلقائية وواقعية، ومهمة الكاتب تتركز على توجيه اللقطات عبر الموشور السردي الذي يقوم بتحليل الألوان وجعلها منفصلة عن بعضها، وكأنّها فصولٌ مستقلة، فأغلب قصصه مجرد مشاهد متتابعة، قد لا يمت المشهد الأول عن الذي يليه إلا بخيوط واهية، وهذا ما يجده القارئ في قصته الموسومة "صيف الألم" والتي تتشظى إلى ألوان ومواضيع مختلفة، وكأنها "ماتريوشكا" أي الدمية الروسية، فما أن تعثر على دمية حتى تجد في داخلها دمية أصغر منها.
بطل هذه القصة يشعر بحرارة الجو الخانقة، فيلوذ بنفسه مطلّا على التلفزة، وهنا يظهر لنا رجلٌ يستلقي على رمل الشاطئ، بينما كرة الأطفال تُربك هدوءه، وما بين قراءة الجريدة والتحرش والموعد مع عشيقة، يظل هذا الرجل مجرد شخص خاوٍ إلا من مظلته البرتقالية الفاخرة، ثم ينتقل الكاتب في مشهد آخر إلى مختبر الدكتور ريموند الذي تلهيه انشغالاته المختبرية والعلمية عن علاقته الزوجية، فيفقد معنى الحياة التي يتصورها مجرد ميكرسكوب للكشف والتحليل، وهنا تُطرح إشكالية العلاقات الإنسانية الصميمة والتي لا يمكن أن تخضع إلى الحسابات العلمية، ثم يتحول الكاتب إلى مشهد "ما روته جميلة"، والتي تتحدث عن هواجس الانجذاب بين الجنسين، والتي تتخللها الكثير من حالات التردد والمراوغة، حيث تصطدم الرغبات بالأنا العليا، حيث سلطة الأعراف الاجتماعية، والتي تكبح الحب وتعتبره إثما يطارده العقل الواعي. أمّا مقطع "الألم" حيث يلتقي بطل القصة برجل فرنسي في يوم ممطر، وبينما يتبادلان الأنخاب في أحد بارات مدينته، ولكنه ينشغل عن ريمون الفرنسي ليغوص في تداعيات وأفكار تقتلعه من تلك اللحظة، ثم يفاجئه ألم في بطنه فينسحب من البار وسط ذهول الفرنسي ريمون وذهول القارئ أيضا لأن الكاتب لا يعلن عن أسبابه، ولماذا مزّق بطاقة الفرنسي، ثم جمع أجزاءها من جديد.
وهكذا يقحمنا الكاتب في عوالمه التي تتخطى لحظة الحدث ومكانه، لتتسلل من يقظة يومية راهنة إلى أفعال وانشغالات تمزج بين الأحلام المتخيلة والواقع، في إطار موجات من تيار اللاوعي الذي انتهجه الكاتب الأميركي وليم فولكنر في معالجاته الروائية، ولاسيما في روايته الشهيرة "الصخب والعنف".
في قصة "طفلنا الذي يحبو" يتأرجح بطل قصته ما بين اتساع الحلم وضيق الوسيلة، فهذا الشاب المطوّق بالفاقة، لأنه عاطل عن العمل، فيلجأ إلى مخزون التخيّل الذي يستدعيه كلما اشتدت عليه وطأة الحياة وقسوتها، فحينما يسافر لا يجد صديقه كي يقضي ليلته في شقته، فيلجأ إلى عمارة سكنية محاولا إقناع العساس بأن يبيتَ ليلته هناك، ويتعاطف معه الأخير، ولكنّ بطل القصة يرطّب جفاف لحظته، باستدعاء الحلم، حيث اللقاء بالمرأة التي رافقت مخيّلته، وربتت على بعض متاعبه، واستنهضت فيه الهمّة أن يتجاوز محنة الضياع، لذلك فهو يتحسس كل ذلك من خلال الحذاء الذي اشترته له ذات يوم. ورغم ثراء أحلامه، لكنها غير متوازنة وزاهدة، فهو يتمنى أن تنجب له طفلا حتى وإن كان على هيأة دُمية لا تكبر، بل تحبو فقط، وكأنه يريد أن يقبض على فحوى الأمل المستحيل ويجعله محنطا.
لقد استطاع الكاتب أن يقدم لنا نموذجا لحالات من الإحباط دون أن يمنحنا أي مؤشر لأسبابها، لذلك فإن فكرة البطالة التي سلّط الكاتب عليها كمؤشر وحيد لهذا الانكسار في شخصية بطله، أن نستشعر أيضا أن أغلب أبطال قصصه يعيشون وعيا حادا لأزماتهم، مما يخلق نوعا من الغربة عما يحيط بهم.
ومفهوم الاغتراب بمعناه الفلسفي ينسحب أيضا على إبراهيم، وهو بطل قصة "ما الذي حدث لي"، فهو أيضا يمثّل حالة الإحباط المتفشية عند شريحة عريضة من الشباب، فنراه يغرق بالإرهاق والكسل، ويلوذ بالخمرة، وحينما يُجبر من قبل العائلة أن يشتغل في حانوت أبيه، يهرب من واقع السوق وضجيجه، ويهيم -ذهنيا- على شواطئ البحر حيث العشيقة التي يلتحم معها جسديا بدون رغبتها، عبر تداعيات لا شعورية، وانتقالات رشيقة من مشهد إلى آخر، حتى يجد القارئ نفسه أمام مشهد مسرحي، لشخص واحد يتقمص عدة أدوار "مينودراما" وهو مثخن في العجز والسلبية في مواجهة الواقع المحيط به، بحدته أو نعومته، حتى أنه غير قادر على مواجهة المالك الذي جاء يطالب أهله لتسديد الكراء الشهري لبيتهم.
أما قصته "الأعزل" فتتناول شخصا لا يمتلك من الحياة سوى ذكريات عتيقة لا يعبأ بها أحدٌ، يعود إليها من خلال الصندوق الذي احتفظ في داخله بالبدلة العسكرية والأوسمة، كما أنه يحتفظ في جسده على أثر الرصاص الذي طرز ساقه وجزءا من بطنه. ولكننا لا نعلم عن ماهية هذا الشخص الذي وصفه الكاتب بالأعزل، ولا نعرف خلفيته، ولكن جروح جسده تشي بخلفيته العسكرية فقط، وقد ظهر كأعزل من ملامحه وتاريخه الشخصي وحتى من اسمه، ولكنه مازال يعلن وجوده من خلال تسكعه ولقاءه بأصحابه حيث يلعبون الروندة وما فيها من التراشق الفكه من خلال الدعابات الساخرة بينهم، والتي يحلو له أن يحكي عن بطولاته مستشهدا بالآثار المرسومة على جسده، وهو في حالة استدعاء الماضي الذي يطلّ علينا بين الفينة والأخرى من خلال الذاكرة، لكنّ هذا البطل الذي يعاني من أمراض مزمنة كالسكري، يرى في المدينة القديمة لمراكش متنفسا له حيث سوق السمارين والمقبرة وباب الخميس، وحركة الزحام.
ولعلّ قصته "بحث في مقبرة" تختلف عن بقية قصص المجموعة، لأنها تتضمن صوتا أنثويا، يحاول حياكة الحدث، فالسارد أنثى وحيدة في زحمة الأصوات الذكورية في بقية القصص، فهذه المرأة التي تجلس في ركن من مقهى، ويتقدم شاب لا تعرفه، ويستعير منها ورقة وقلما، ومن هنا يبدأ تعلقها به، أو كما تعبر عن ذلك بقولها:
"وكأنني أقرضته حياتي"
ثم بعد ذلك ينقلنا الكاتب إلى آخر مشهد حيث الشاب في المقبرة، فيجد القارئ نفسه بين أهم حلقتين في القصة وهما: بداية القصة ونهايتها حينما تذهب إلى المقبرة لزيارة قبره، وهكذا يكسر التسلسل السردي، ليضع القارئ أمام حكاية تتأرجح ما بين الذكرى ولحظة تأمل نتائجها المؤلمة على صعيد التصدع العاطفي، حيث نُدرك من خلال السياق أنه مات إثر حادثة سير، وكانت ثمة امرأة معه أثناء تلك اللحظة المشحونة بالموت، أي أنه كان في حياته غير وفي لها وللمرأة الأخرى، ومن هنا تُدرك فداحة الحياة، في كونها نزوة عابرة، وبأن الأحلام قد تتحول إلى قبور صامتة، مستنجدة بأسلوب الرسام الهولندي فان كوخ والذي رسم السماء بعينين مجنونتين.
من خلال هذه المجموعة المتميزة، أستطيع القول بأن الكاتب المغربي عبداللطيف النيلة قد تمكن من ترويض أدواته القصصية، وجعلها أكثر أناقة وجاذبية، وذلك من خلال قدرته على رسم الصورة ونحت شخوصه بعناية، إضافة إلى عنايته بتأثيث الأمكنة بجمالية الوصف، والوقوف عند التفاصيل الصغيرة حتى يتبلور المشهد، وكأن القارئ يعيش بين فضاءاته، كما أنه القصة لديه لا تمنح نفسها بسهولة إلا بعد أن يجردها القارئ من جلباب الرمز الذي يغلّفها بشفافية. كما أنه يتعمق في دواخل شخوصه، ليستل منهم بعض المفاهيم والقيم، وبأن القاسم المشترك بينهم هو الإحباط، وما حصيلة أفعالهم سوى "قبض الريح".