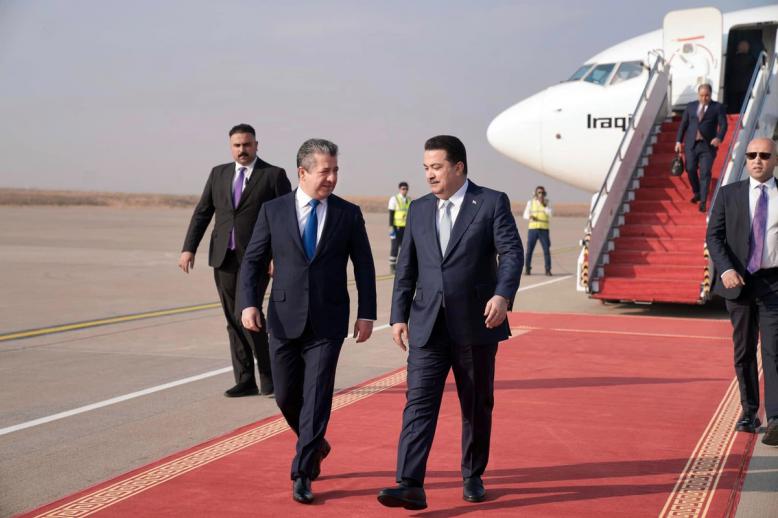كان القاتل والقتيل فرنسيين
حادثة الذبح التي تعرض لها معلم فرنسي في محيط باريس لا يمكن منع تكرار حدوثها بناء على وصفة أمنية مسبقة.
ما جرى يمكن أن يكون فرديا بمعنى أن القاتل اتخذ قراره ونفذه من غير أن يُعلم أحدا أو قد تكون العملية مدبرة من قبل جماعة ارهابية.
النتيجة واحدة. هناك وحوش سائبة تتغذى على حقد وكراهية ورغبة في الثأر والانتقام لا يمكن ضبطها والسيطرة عليها لأنها لا تعلن عن نفسها إلا بعد وقوع الجريمة التي تضرب المجتمع مثل صاعقة مفاجئة.
من حق المجتمع الديمقراطي في الغرب أن يحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما جرى. هناك تقاعس في اداء الواجب. ولكن المشكلة تكمن في أن تلك الأجهزة مقيدة بالقانون الذي يمنع تقييد حريات الأفراد على أساس ما يفكرون فيه. وحين يتجسد ذلك الفكر المتطرف على الأرض يكون الوقت قد فات.
فإلى متى يستمر ذلك التناقض القاتل؟
حين يدعو اليمين المتطرف إلى تعليق مواطنة المتطرفين من الإسلاميين وطردهم خارج حدود أوروبا ينتفض معادو العنصرية ويعتبرون تلك الدعوات نوعا من الانقضاض على المبادئ الديمقراطية التي أقيمت على أساسها أوروبا الحديثة. وهم محقون.
ولكن الدولة معنية بذلك النقاش بطريقة أخرى.
فمنفذو العمليات الارهابية بالرغم من كونهم مسلمين غير أنهم مواطنون أوروبيون بالولادة والعيش والدراسة. وغالبا ما ينقصهم الانتماء عن طريق العمل فهم ينتمون إلى جيوش العاطلين عن العمل الذين يسهل تجنيدهم من قبل التنظيمات المتطرفة أو أنهم يملكون أسبابا شخصية تدفع بهم إلى الحقد على مجتمع يعاملهم بقسوة وينبذهم ويلقي بهم إلى العتمة.
تلك مشكلة ينبغي النظر إليها بطريقة جادة فهي أساس الأزمة.
واقعيا فإن المتطرفين هم كائنات مأزومة غير منسجمة مع محيطها وغير قادرة على تفهم ما يجري من حولها ووضعه في سياقه الطبيعي. كل ذلك هو نتيجة طبيعية للعزلة والشعور بالتهميش العنصري والفشل.
ذلك ما تعرفه المؤسسات الغربية المعنية وما سبق لمسؤولين أوروبيين من طراز رفيع أن أشاروا إليه. غير أن العمل على تلافيه ظل في مستويات تقارب الصفر. كما لو أن صفحة الندم لا تُفتح إلا حين تضرب فاجعة التطرف المجتمع وتعيده إلى الاحتجاج الاستفهامي بكل صوره.
في كل الأحوال كان في إمكان الدولة العلمانية أن تحث موظيفها على الأقل على الابتعاد عن التصرف بغباء وبلاهة أثناء تدريس طلاب قادمين من مجتمعات لا تزال العقيدة والرموز الدينية تشكل جزءا مهيبا ومقدسا من وجودهم.
وكما أرى فإن ذلك المعلم القتيل راح ضحية غباء المؤسسة التي لم تحطه علما بالمعلومات الأمنية التي يُفضل بناء عليها أن لا ينزلق إلى الموضوع الإشكالي الذي شكل مسوغا لأن يلجأ القاتل المأزوم إلى العنف تعبيرا عن رغبته في الثأر لرموزه الدينية وعقيدته.
لم يكن القتيل عنصريا كما وصفه البعض. فالعنصرية لا يمكن أن يمارسها معلم مع تلاميذه الذين يعرف أنهم في رعايته كما أنهم سيقابلونه وجها لوجه عبر أشهر طويلة.
كان القتيل ضحية كسل وغباء واهمال المؤسسات الأمنية والتربوية والراعية لشؤون المهاجرين. اما القاتل فإنه هو الآخر ضحية. مَن أتيحت له فرصة التجول في بعض أحياء باريس وفي الضواحي التي تسكنها غالبية مسلمة لابد أن يدرك بيسر أن الدولة الفرنسية سلمت التنظيمات الارهابية شبابا يافعين، تسربوا من التعليم ولم ينضموا إلى قوائم العاملين.
الوضع شيء هناك. بل هو أسوأ مما نتخيل. يمكنني أن أقول إن العنف يُمكن أن يُرى هناك باعتباره سلوكا طبيعيا.
غير أن ذلك كله لا يُعفي الأجهزة الأمنية مما يقع عليها من مسؤولية. فهي تملك عيونا في تلك المناطق. وهو ما يعني أنها تعرف الكثير من الحقائق وبالأخص في ما يتعلق بتنظيم الإخوان المسلمين الذي آن الأوان لكي ترفع أوروبا يدها عنه وتعلنه تنظيما إرهابيا.
ربما كانت حادثة مقتل المعلم الفرنسي قد نتجت عن تصرف فردي أرعن وطائش ولكن ذلك التصرف ما كان له أن يقع لولا البيئة الاجتماعية والثقافية التي حرضت عليه.
في النهاية يمكن القول إن ذلك الإرهاب كان فرنسيا.