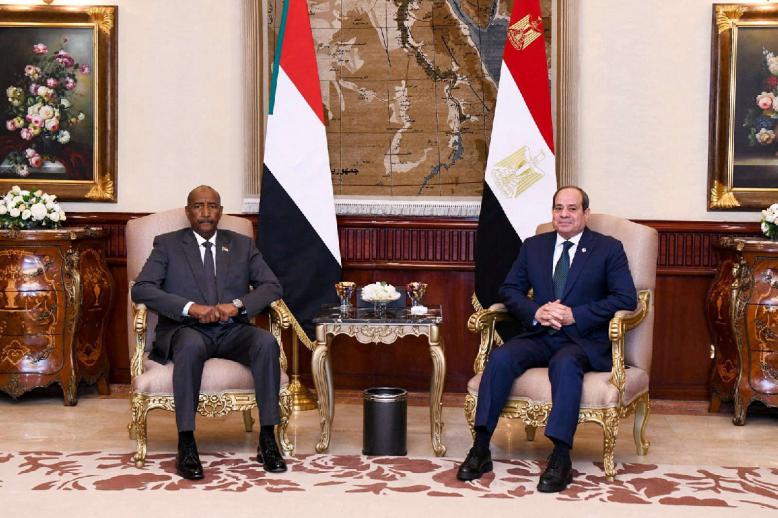مرجعية الدستور العراقي وثوابت النظام الديمقراطي
في مثل هذه الأيام، قبل عشرين عامًا، وتحديدًا في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر، خرج ملايين العراقيين منذ ساعات الصباح الأولى من بيوتهم متوجهين إلى مراكز الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الدائم، الذي ساهم في صياغته وكتابته سياسيون وخبراء ومتخصصون يمثلون مختلف مكونات المجتمع العراقي.
غالبية أبناء الشعب العراقي صوّتوا بـ(نعم) لصالح مشروع الدستور، وكانت تلك رسالة بليغة ومعبرة وعميقة في دلالاتها ومعانيها عن تطلّع العراقيين إلى طيّ صفحات الديكتاتورية والاستبداد، وفتح صفحة جديدة مختلفة عن سابقاتها، ووضع أسس ومرتكزات سليمة وقوية ورصينة للعراق الجديد، وكان الدستور هو المحور وقطب الرحى.
كان خروج العراقيين قبل عشرين عامًا وتصويتهم لصالح الدستور يمثل تحديًا كبيرًا، أثبت شجاعة وإقدام وإرادة هذا الشعب، في خضم ظروف وأوضاع أمنية وسياسية كانت خطيرة وحساسة للغاية.
ولم يكن الدستور في جوهره ومضمونه مثاليًا، فقد وُلد في ظل ظروف صعبة ومعقدة جدًا، ومنذ البداية كان واضحًا أنه يحتاج إلى مراجعات عديدة وإعادة نظر في بعض مواده، وهذا ما اتفقت عليه معظم الكتل والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية.
إن وجود ثغرات وهفوات ومكامن ضعف لم يُلغِ قيمة الإنجاز والمكسب الذي تحقق من خلال إقرار الدستور، إذ إن وضع اللبنات الأساسية والرئيسة للنظام الديمقراطي أمر لا بدّ منه من أجل الانطلاق والتقدم إلى الأمام، مع استمرار عمليات الإصلاح والتعديل والتغيير المطلوبة في إطار الدستور ذاته وتحت سقفه.
ولعل المؤشر المهم على أهمية الدستور هو أن القوى التي وقفت ضده في بادئ الأمر، راحت فيما بعد تحتكم إليه وتعتبره مرجعًا لها، وتدعو الآخرين إلى الاحتكام إليه، وترفض القفز عليه أو تجاوزه.
واليوم، فإن كل خطوة تُتخذ في إطار الدستور ووفق ضوابطه من شأنها أن تسهم في تقوية وتعزيز النظام الديمقراطي التعددي في البلاد، وكل تحرك يتقاطع مع الدستور ويصطدم به لا يفضي إلا إلى إضعاف النظام وتعريضه للخطر، وبالتالي فإن ذلك الخطر ينسحب على الجميع.
ولا شك أن بلدًا مثل العراق، يمتاز بتنوع نسيجه الاجتماعي والسياسي، لا يمكن إدارة شؤونه بنجاح من دون مشاركة حقيقية من قبل كل الأطراف السياسية التي تعكس ذلك التنوع وتعبّر عنه وتترجمه بصورة صحيحة على أرض الواقع.
والعراق ليس البلد الوحيد في العالم الذي يحمل ميزة التنوع، فهناك بلدان أخرى تحمل الميزة ذاتها، مثل سويسرا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا ولبنان وإيران ونيجيريا وغيرها.
وبعض هذه الدول نجح في التوصل إلى صيغ مناسبة وملائمة لاستيعاب وتوظيف ذلك التنوع واستثماره بالشكل الصحيح للتقدم إلى الأمام، وترسيخ مبادئ وقيم الديمقراطية والحرية والعدالة والنهوض والازدهار، بينما أخفق البعض الآخر منها وفشل، ليعيش في دوامة الصراعات والنزاعات والحروب، ويبقى رازحًا تحت وطأة الفقر والمرض والتخلف.
النموذج الأول سار في الطريق الصحيح من خلال تبنّي النظام الديمقراطي الذي صهر كل المكونات في بوتقة واحدة، وضمن حقوقًا للجميع مثلما رتب واجبات على الجميع، ووفّر فضاءً واسعًا لكل المكونات كي تشارك مشاركة حقيقية، وفي كل المستويات، في إدارة شؤون البلد. لذلك نجد أن الحروب والصراعات الداخلية والمشاكل السياسية الحادة والاحتقانات التي تعطل مسيرة البناء وتهدد مصالح الناس ليست لها حيز في الواقع العام، على العكس تمامًا من النموذج الثاني الذي اعتمد النظام الديكتاتوري الشمولي الاستبدادي، القائم على حكم وتسلّط أقلية قومية أو دينية أو إثنية على مقدّرات البلاد، وإقصاء وتهميش كل المكونات الأخرى، واعتماد منهج القمع والتنكيل بحق الآخرين، بحيث تغيب كل مظاهر المعارضة والرأي الآخر، حتى وإن كان طابعه سلميًا لا يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلطة والنظام.
وقد مثّل العراق في عهد نظام البعث النموذجَ الأسوأ للأنظمة الديكتاتورية، إذ قمع الأكراد في الشمال، والشيعة في الجنوب والفرات الأوسط، والسنة في الموصل والرمادي وتكريت، والتركمان في كركوك، والمسيحيين في أماكن مختلفة. ولم يكن يمثل مكونًا بعينه، ولم يدافع أو يحمِ مكونًا بذاته، رغم أنه كان يحاول دائمًا الإيحاء بأنه يمثل طائفة معينة في مقابل طائفة أخرى، أو قومية في مقابل قوميات أخرى.
وبعد زوال النظام السابق كان من الممكن للعراق أن يكون نموذجًا صالحًا وحسنًا للديمقراطية في بيئة إقليمية تعاني التخلف والقصور وضعف الثقافة السياسية الديمقراطية، وشيوع ثقافة التسلّط والقمع والإقصاء، وما زال ذلك الأمر ممكنًا ومتاحًا رغم الكمّ الكبير من المشاكل والتحديات التي واجهها ويواجهها العراق من الداخل والخارج على حد سواء.
إن تكريس مبدأ المشاركة الوطنية الحقيقية يمثل الخطوة الأولى لجعل العراق نموذجًا صالحًا وحسنًا للأنظمة الديمقراطية في المجتمعات التعددية، والمشاركة الحقيقية كمبدأ لا بدّ أن تقترن بوجود دستور دائم يحظى بالقبول والاحترام، ويكون هو المرجعية السياسية والقانونية لشركاء الوطن، ولا يكون عرضة للمساومات والصفقات السياسية التي تضمن مصالح طرف أو أطراف معينة، في الوقت ذاته الذي تهدد فيه مصالح البلد برمته وتجعله في مهب الريح.
واليوم، فإن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تُعد خطوة أخرى نحو ترسيخ أسس ومرتكزات وثوابت النظام الديمقراطي، إذا ما أُجريت في ظل أجواء سليمة وسياقات قانونية صحيحة، بعيدًا عن الاستئثار والاستغلال، والتشهير والتسقيط، والخداع والتضليل، وشراء الذمم والأصوات.