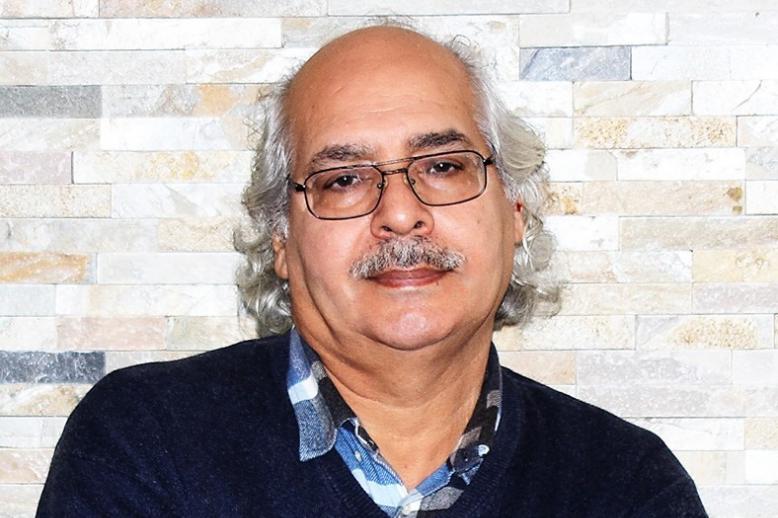اللعبة والتفلسف: عن كرة القدم في حياتنا
أسدى أبيقور نصيحة لكل من يشغفُ بالفلسفة مفادها أنَّ التفلسفَ ينبغي أنْ لا ينقطع عن الضحك، ومعنى ذلك أنَّ الهدفَ من المعرفة الفلسفية هو تذوق المتعة، والشعور بالمرح.
هنا يكونُ السؤال قائماً بشأنِ إمكانيةِ صياغةِ مقولةٍ على غرار ما قدمه فيلسوف الحديقة، لكن مع استبدال الضحك باللعبة «ينبغي أن نتفلسفَ ونحن نلعب»؟ ولعلَّ المسوغَ الأبرز لاشتقاق العبارة الجديدة أنَّ المشترك بين الفلسفة واللعبة هو المتعة، كذلك فإنَّ التواضع يجمعُ بين الفيلسوف واللاعبِ ينفتحُ كلاهما على غير المتوقع الذي يحدث دائماً، على حد تعبير أندريه مالرو» ربما يتدخلُ صوت مختلفُ متحججاً بأنَّ اللعبة هي ضمن ظواهر الحياة اليومية البسيطة، وبالتالي لا يصحُ اصطفافها على خط الفلسفة. غير أنَّ التحويل المبدع فلسفياً هو الذي يحيلُ ما ليس بفلسفةٍ إلى عمل فلسفي، على حد تعبير المفكر اللبناني علي حرب.
إذن فمن الطبيعي أن تكونَ اللعبةُ مصدراً للتفلسف، أولا يقع خارج حزام النقاش والسؤال كأضعف الإيمان، لأنَّ التجاهل ما وصل إليه الاهتمام باللعبة على المستوى العالمي من جماهيرية عريضة، والتهكم على هذه الحقيقة بالقول على شاكلة إنها «أفيون الشعب» أو تفاهة تزيدُ جهل الجُهلاء لا يلغي فعاليةَ اللعبةِ في تكوين خطابها المؤثر على مستوى أوسع. ومن المناسب هنا الإشارة إلى أنَّ الفيلسوف الألماني كانط، على الرغم من تفرغه الكامل لتدشين ثورته المعرفية وتزهده عن العلاقات العاطفية، بحيثَ أثار هذا الموضوع جدلاً إلى أنْ اعتبرت حياته الجنسية من أخطر المسائل الميتافيزقيقة في الغرب، لكن في شبابه كان يُصر بعد الانتهاء من إلقاء محاضراته، على الذهاب إلى المقهى للعب البليارد، لأنه كان يعتقد أن في ذلك تنشيطاً للذهن، حسبما يذكر ذلك الكاتب العراقي علي حسين.
مواجهة الواقع
من الحقائق التي يتغافلُ عنها البشرُ باستمرار ولا يريدُ التقيُد بمضمونها هي ما اكتشفه الفيلسوف الفرنسي باسكال، الذي قد ذهبَ إلى أنَّ السبب الوحيد لتعاسة الإنسان هو قلة معرفته كيف يجلسُ في غرفته هادئاً، طبعاً قد لا ينكرُ أحدُ صحة هذا التشخيص، لكن لو عاش الإنسان وفق هذا المنطق منذ بدء الخليقة، لما تمكن من أن يخطوَ خارج كهفه خطوة واحدةً. إذن اختار مواجهة الواقع بدلاً من الركون إلى الهدوء، غير أنَّ ذلك يتطلبُ التدجج بترسانة من الاستعارات، لأنَّ الدخول إلى هذا المعترك بصورة مباشرة متجرداً مما يكون مصدراً للعزاء ليس خياراً أمثل بالنسبة للإنسان، ومن المعلوم أن الحقيقة تبدو صادمةً أكثر من الأوهام، لذلك يقولُ ماركيز دوساد: «الأوهامُ المُسلمُ بها أفضلُ من الحقائق الفلسفية المُحزنة» ولا يصحُ أن يُحَمًلَ الكلام على أنه دعوة لترويج الوهم والتجهيل، بل هو إدراك لضرورة تصريفِ التوتر والشعور بالاغتراب، من خلال قنوات مُتعددة، إذنْ الاختزال في النظر إلى المشهد يعني التغافل عن الخصوصية الموجودة في التركيبة النفسية والسلوكية لدى الكائن البشري، وتميزهِ في البحث عن الوسائط التي تُمثلُ التطلع لإعادة ترتيب علاقته مع تحدياتٍ حياتية. ويتمكنُ من خلالها صياغة سردية جديدة ولعلَّ اللعبةَ تندرجُ ضمن هذه المساعي الرامية لإضافة الطاقةِ البلاغية إلى الواقع، واللافتُ في مجال اللعبة هو تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع، وبذلك تختلفُ عن بقية الفعاليات السائدة في الكيانات المُجتمعية، وغالباً ما تنطلقُ من الهامشِ الأسماء التي تخترقُ فضاءاتٍ مطبوعةٍ بمؤثرات ثقافة المركز، ولولا أور مابيل القادم من مخيم اللاجئين، لما تأهل المنتخبُ الأسترالي إلى نهائيات كأس العالم في الدوحة. لذا تدوي الإستادات العالمية بالهتاف حباً بأيقونات رياضية صاعدة من منطقة الظل، وهذا يفتحُ المجال لإعادة النظر بشأن إشكالية الهوية وتضايف الإثنيات المختلفة في الفضاء المُجتمعي.
ومن الواضح أنَّ الانتماء لا يمنعُ من اختطاف الأضواء والتفوق، وربما هذه الفرصة التي تتيحها اللعبةُ للحركة بعيداً عنْ المرجعيات بأشكالها المختلفة، هي السرُ وراء شعبيتها على المستوى العالمي. وبالطبع فإنَّ كرة القدم تأتي في المقدمة من حيث الجماهيرية، وتحولت إلى بورصةٍ للصفقات الخيالية، على أي حال فإنَّ ما يهمُ ليس الشق الاقتصادي في الموضوع، لأنَّ العالمَ بأسره أصبحَ متجراً كبيراً، بل حظوة التفاعل مع حيثيات المُستطيل الأخضر. والطريفُ أنَّ الكاتب الأوروغواياني إدواردو غاليانو يشيرُ إلى دور الكتاب الذي ألفه عن كرة القدم في إنقاذ حياة شخصية سياسية، وإذ ينقلُ صاحب «كتاب المُعانقات» عن فيكتور كونتانا، بأنّه وقع في 1997 بيد القتلة المأجورين وانهالوا عليه ضرباً، وبينما هو على مشارف الموت تناهى إلى سمعه أنَّ أفراد العصابة يتحدثون عن الكرة، فإذا به يشارك في النقاش مدلياً برأيه، ولم تكنْ معلوماته إلا ما قرأه في كتاب إدواردو غاليانو وبذلك استعاد حريته المُصادَرة.
التضامنُ الوجداني
تؤكدُ القصة المشار إليها آنفاً على ما تبثهُ اللعبةُ من مبدأ التشارك بين أفراد الفريق ومُحبي الساحرة المستديرة. وبدوره اعترف ألبير كامو بأنَّ الرياضة كانت شغله الشاغل لافتاً إلى أنَّها المجال الوحيد الذي تلقى فيه دروس الأخلاق. يُذكرُ أنَّ مؤلف «الإنسان المُتمرد» كان يلعبُ حارساً للمرمى في فريق جامعة الجزائر. وعندما سُئل أيهما يفضل المسرح أم كرة القدم؟ فقد آثرَ اللعبة على أقدم فنٍ في التاريخ. وكانَ مُحقاً في ذلك لأنَّ التشويق في اللعبة يكمنُ في عنصر اللامتوقع، وعلى الرغم من توجيهات المدرب الذي هو بمنزلةِ المخرج في المسرح غير أنَّ ما يشهدهُ الملعب قد لا يتطابقُ مع ما خطهُ مُسبقاً على أوراقه، ولا يقعُ ضمنَ حساباتهِ، فيما الخروج عن النصِ وآلية توزيع الأدوار على الركح، يعتبرُ استثناءً في الاشتغال المسرحي. لا يتقيدُ المُتابعُ للعبة ذهنياً بسيناريو جاهز، إنما ينفتحُ على احتمالات مُتعددة، لذلك لا غرابةَ في احتفالهِ بفوز فريقهِ حتى لو كان واثقاً من تاريخه وإمكانياته. وهذا ما يضاعفُ المتعة في العرض.
يضربُ سارتر بكرة القدم مثالاً لإضاءة المبادئ الفينومينولوجية، شارحاً بأنَّه حين يرى المباراة يراها بوصفها مباراة، لا بوصفها مشهداً بلا معنى يتنافسُ فيه عددُ من الأشخاص ملاحقين شيئاً مستديراً. ما يعني أنَّ من تجربة المشاهدة يتولدُ المعنى والمُتعة. ما يقولهُ مؤلفُ «أبواب مُقفلة» يتطابقُ تماماً مع آلية هوسرل في تقديم الفلسفة الظاهراتية لطلابه، إذ طلب منهم احتساء القهوة والتمتع بها بعيداً عن كلام مرسل عن تركيبتها الكيميائية، أو الحقول للمصدرة لهذه المادة، بل ما يستحقُ المتابعة هو المذاق والرائحة واللون والوعد بالانتعاش، لا شكَّ في أنَّ ما يشدُ المتابعُ إلى الفنون والأعمال الأدبية هو لفحة الفنتازيا وجنوح التخيُل، إذ يتمُ التوسل بالمؤثراتِ الصوتية والضوئية والبصرية لإنشاء عوالم موازية تتخففُ فيها القيود والإكراهات المؤطرة للواقع. وبهذا يكونُ الفنُ تعويضاً عن اللذة غير المحققة. هنا لا مهربَ من التساؤل أينَ الخيالُ من اللعبة؟ وهل يكونُ دورها تعويضياً على منوال بقية الفنون الأخرى؟ نعم إنَّ التماهي مع الفريق والتضامن الشعوري مع أفرادهِ يسدُ فراغات نفسية لدى المُتابعِ، وبالطبع يسحبُ تأثير هذه الحالة على اللاعبين قبل الجمهور. يفصحُ ما قالهُ كامو بشأنِ حبه لفريقه عن التآلف الوجداني بين المشاركين «لقد أحببتُ فريقي حباً جماً، من أجل فرحة الانتصارات بالغة الروعة حين ترتبطُ بالتعب الذي يتبعُ الجهد، لكنَّي أحببتهُ أيضاً بسبب الرغبة البلهاء للبكاء في أُمسيات الهزيمة». وما يرويه اللاعب البرازيلي السابق إيلانو، الذي يديرُ فريقاً من الدرجة الرابعة في بلده عن تعاطف عناصر فريقه مع لاعبٍ كانت زوجته تعاني من مرضٍ عضال، إذ تعاهدوا على الفوز من أجل شريكة حياة صديقهم، يؤكدُ وجود درجة عالية من التواصل الإنساني في الفريق.
الفنيات العالية
الإثارة في اللعبة تقومُ على ما يقدمهُ اللاعبُ مباشرةً أمام جمهوره ولا وجود للجدران الفاصلة بين الطرفين، إذ ما إن يسجلَ هدفاَ حتى يركضَ نحو الحضور ملوحاً بما يعبرُ عن تقاسم الشعور بالسعادة القصوى مع المشجعين، الأمر الذي يصعدُ من زخم الأجواء التفاعلية في الملعب. وما يأخذُ بالتشويق إلى مدىً أقصى ويجعله متفرداً ليس إلا الفنيات العالية في الاستعراض، بحيثُ ما يقعُ عليه البصرُ أحياناً يفوقُ مستوى المخيلة «ميتا الخيال» لدى الجمهور والمدرب في آن واحد. والدليلُ على ذلك رؤية الحركات التي تعبرُ عن شدة التأَثُر، فالمدرب المتموضعُ على تخوم الخط مرتدياً طقماً أنيقاً يتأملُ المواجهة، فجأةً يقفزُ في الهواء محتضناً كل من يراهُ، وربما يصادف حسناءَ وبذلك يكون من الفائزين المحظوظين، أو يربتُ على رأسه كما فعل زين الدين زيدان أكثر من مرة مباغَتاً بمهارات استعراضية لعناصر فريقه، ومن نافلة القول، إنَّ الرشاقة في الأداء والخفة في الحركة والسرعة في القرار من مواصفاتٍ مشوقة في اللعبة، يقول المهاجم الهولندي الشهير آرين روبن، إنَّه كان عليه أن يتخذ القرار في جزءٍ من الثانية عندما انفرد بالكرة وهو أمام حارس المرمي للفريق الخصم إيكر كاسياس وجهاً لوجه في نهائيات كأس العالم 2010.
معجم اللعبة
قد يرى البعضُ في اللعبة عموما، وفي كرة القدم خصوصاً، عبثاً وتفاهةً أو ما يسميه هيدغر بـ»اللاأصالة في الوجود» صحيح أنَّ الغرض من اللعبة هو التسلية بالدرجة الأولى، وقد يلجأُ إليها الناسُ هرباً من الأزمات المضنية، لكن لا تخلوُ اللعبة من رمزية حضارية وثقافية، فأصحبتْ النوادي الرياضية إلى جانبِ الفرق الوطنية تُعبرُ عن حيوية المجتمع وشغف مواطنيه بالحياة والمرح. زيادة على ما سبق إنَّ متابعة مباريات كرة القدم لم تعدْ متعةَ بالفرجة، أو المشاهدة حسب، بل التعليق المصاحب لوقائع اللعبة يفتحُ مجالاً للتشابك مع الحقول اللسانية والمعرفية، كما ترى ذلك في هذه العبارة «تجاوز غوارديولا الخيط الضيق بين العبقرية والجنون» كذلك فإن ما يقدمه عصام الشوالي عبارة عن تغطية بلاغية تنزاحُ فيها المفردات نحو سياقات مختلفة، إضافة إلى أن اللمحات التاريخية الموجزة التي يسردها عن الملاحم الكروية، تكشفُ عن خلفية الثقافة الرياضية لدى الشعوب، كما يتعاملُ المعلقُ بمنطق تحويلي مع نصوصٍ أدبية ويطوعها بما يكملُ المتعة الفرجوية، وبذلك ينشأُ معجم خاص باللعبة من المحتمل أن يتمَ تداول مفرداته في سياقات أخرى، أكثر من ذلك فإنَّ مطالبةَ المعلق من المدرب بضرورة عدم الانسياق وراء الأخطاء وتخميناته بشأنِ ما يجريه من التغييرات في المستطيل الأخضر، كل ذلك ينزلُ ضمن ما يمكن تسميته بميتا اللعبة، طبعاً يتفاعل بعض المعلقين بقوة مع قرارات المدرب، فكان الشوالي يرجو من بيب غوارديولا، ألا يتفلسفَ في مباراة فريقه مع واتفورد كأنَّه أراد بذلك القول، بأنَّ ما كتبته على لوحتك يا فيلسوف لا يتطابقُ تماماً مع مجريات الساحة، لأنك غالباً ما تأخذ دور الصدفة بنظر الاعتبار عندما ترسمُ خطتك، هنا نذكّر بكلام باسكال، أن السخرية بالفلسفة تفلسفُ.
قصارى القول عن اللعبة إنها نشاط إنساني يتشابكُ مع مظاهر الحضارة والحقول المعرفية، قبل كل ذلك هي استعارة رشيقة لافتتان بالمرح والخفة والمرونة.