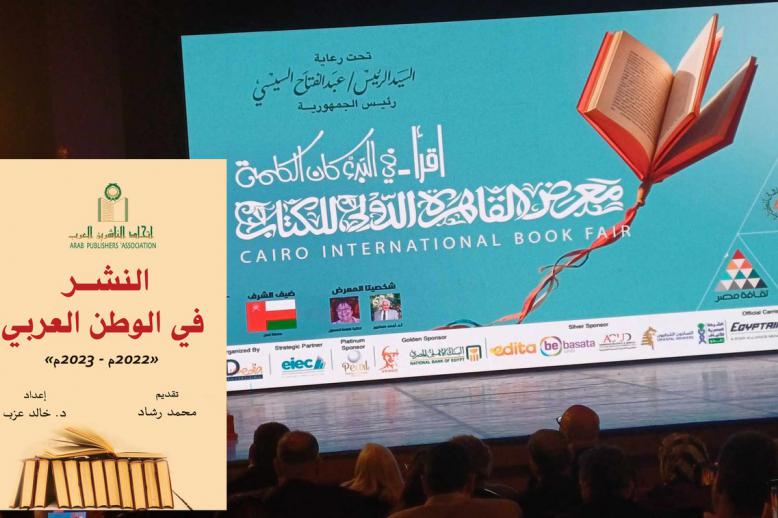جورج ميرو يستعيد أطروحة الضوء والتراب
جورج ميرو فنان تشكيلي سوري، وُلِدَ وعاش في الحسكة، على ضفاف نهر الخابور. شرب من ماء هذا النهر، وعام فيه، وتعمد بتراب هذه المدينة، وبقيت رائحته تلاحقه كثيرًا حتى بات ضيفًا مقيمًا في أحاسيسه، وبالتالي في أعماله. بقي هذا التراب يفعل فعله فيه على امتداد الزمن، فكان كلٌّ منهما وفيًّا للآخر، كما كانت بداية استحمامه بالضوء الذي كبر فيه وبعثره مع الألوان على بياضٍ تحوّلت جميعها إلى حقول حنين وشوق، وبيادر وفاء وحب.
ميرو بقي أمينًا لذاكرته البعيدة، وهذا يشير إلى نقاء فطرته وقوة ارتباطه بماء خابوره، وهذا يُسجَّل له ويكسب مسلكه تراكمًا عشقيًا معرفيًا بقصد الحفاظ على الإنساني دون أي انحراف عن قيمه. كما يساعده ذلك على نهوضٍ لا تراتبي، يجعل العلاقة مع متلقيه علاقة فاعلة في مجمل تحوّلاتها، وهو ما يضع وعيه المستنير في حركة اندفاعٍ تغييرية، لا على مستوى المجاورة فحسب، بل على مستوى التداخل، على قاعدة الحركة الدافعة واستجابةً لمقتضيات التناظر بين أعماله كجزءٍ من نتاج حقلٍ ثقافي، وبين أطروحاته ودرجة اقترابه من عمق السجال القائم والمستديم.
فهو يضع عملية البلورة في طريقٍ تؤدي، على نحوٍ ما، إلى تغييرٍ في بنية خطابه التشكيلي، إذ ينطلق من استعارة ألوان أرضه وآهاتها، وحقول بلاده وشمسها، ويجبلها مع حنينه وحبه حتى يصبح منتجه محاكاةً لأحاسيسه دون أن يعزلها عن العالم الخارجي، ودون أن تتهاوى في ذاتيته، حتى لو اقتضى الأمر ذلك. فهو يؤكد أن الإنصات إلى الداخل، سواء في دلالاته أو في لحظة تحوّلاته، هو الذي يقول إن القيمة الجمالية للأشياء هي الوجه الآخر للقيمة الاجتماعية.
ومن هنا، فإذا كانت المعطيات موجودة خارج الذات المُبصِرة، فإن الطاقة الإدراكية المتوالدة لكلٍّ من الفنان ومتلقّيه هي التي تجعل الرابط بينهما وبين العمل المنتج استكشافًا لحقل الممكنات. ولكن ما قيمة ذلك إن لم يرافقه توسيع دائرة الخلق، والدعوة إلى البحث في الخزائن القديمة، عبر استيعاب المزيج المتحوّل من الخلطة، واستغلال كل الإمكانات غير المستغلة؟
ولا شك في مقدرة ميرو على سرد كل ذلك في مملكته الفنية، فهو ينتقل من اللعب باللون، وعلى نحوٍ أكثر الترابي منه، حيث رائحة الخابور وضفافه، ونسمة جبل عبد العزيز وسفوحه، فهما مركز منحاه، حيث يتجه صعودًا إلى المختلف، ليدق باب عالمٍ مفتوحٍ بكل فصوله ومخاوفه. أقول، فهو ينتقل من اللعب باللون إلى الاهتمام بفائض الديناميكية والحركة، ليتمكن من نقل نوارس أفكاره إلى عرضٍ فيه رؤيا استغرابية قد تطيح بأكثر مفردات خطابه، وإن كانت لغته لها أسرارها التي تبيح لنا التعامل معها بكشف مناحيها ودلالاتها، ضمن عالمٍ يلفظ بحركاتٍ عملية حينًا وإيمائيةٍ في أكثر الأحيان.
أما التداخل بينهما فقد يكون مركز انطلاقٍ نحو تحقيق فعل المتعة في أعلى مستوياته، وبحضور كل عناصر تحققه، فالأمر هنا يتعلق بتداخلٍ عذبٍ بين فعلي القراءة والتدليل، دون أي انحيازٍ لوجدانية الحالة. فالأمر مرتبط بما يغطي الواقعة باختيارات المادة الحكائية، كشرطٍ لاختراق تداول العلامة.
وفضلاً عن ذلك، فإن نمط ميرو وما يشتغل عليه يثير اهتمامنا، على الأقل بما يشكل مداخله مع الانحياز التام لحدود الزمن الإنساني. وأولى تجلياتها ردم الهوة الفاصلة بين أشيائه، ليغدو واقعه فضاءً يكتمل فيه مدلوله، فهو يضيف عملية تواصلية جديدة بغرض تمثيلٍ آخر للعالم ذاته ضمن زمانيةٍ موحدة، وبأهميةٍ مكانيةٍ مهما كانت درجة التغاير والاختلاف في استعادة أطروحة الضوء والتراب.