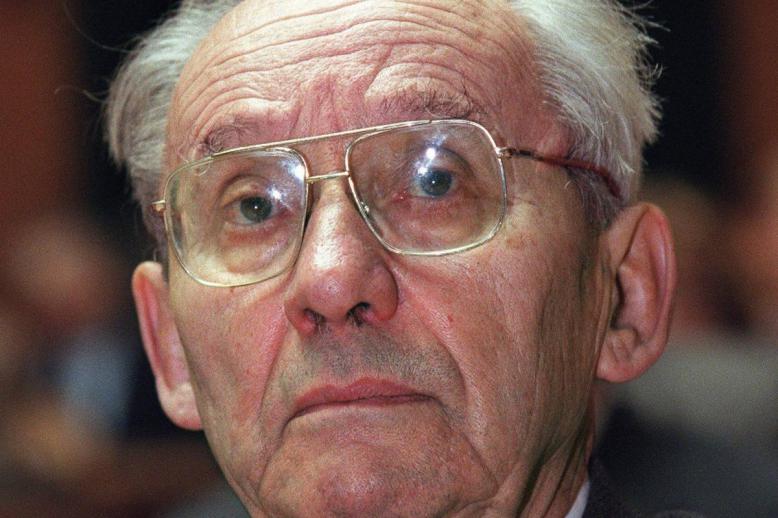التصوف .. الفصل الأخير في التجربة الروحية
يرى أقطابنا من أهل التصوف في الإسلام أن حق الانشغال هو أن تنشغل بالله ذكرا وعبادة وطاعة، ويرون أن تمام الانشغال بالله مستقره ومستودعه الاستئناس والأنس واستدامة الطمأنينة، وهذا المقام يتحقق لذوي الوصل إذا ما استهدفوا قلوبهم بقطع العلائق والشواغل التي طالما أفسدت القلب بمثالب الحقد والغل والحسد وغمط الناس وازدياد العجب بالنفس التي تحض الإنسان على الاستغراق التام في الشهوات كالطعام والنكاح وحب المال، أو تلك النفس المستغرقة في الغيبة والنميمة والفجور في الخصومة. وإذا انشغلت بالله وحده لا شريك له كان الإقبال الإلهي عليك بدوام الذكر وراحة الطاعات، ونعيم العبادات وملازمة القرآن بغير انقطاع متصلا بلذة التلاوة وبصيرة التدبر.
مَلامِحُ سَلامَةِ القَلْبِ:
وحينما تجاهد نفسك بقطع الشواغل والعلائق عنها تكون أيها العبد الراغب في الوصل والمحبة قد قطعت نصف الطريق، وبقي النصف الآخر متعلقا بالقلب الذي ينبغي أن يكون أكثر صفاء ونقاء، وهذا الصفاء تمام معنى السلامة التي جاء ذكرها في كتاب محكم أمين، يقول رب العزة والجبروت "إلا من أتى الله بقلب سليم" (سورة الشعراء ـ آية 89)، قال سعيد بن المسيب :"القلب السليم هو الصحيح، وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض"، يقول الله تعالى "في قلوبهم مرض" (سورة البقرة آية 10)، وقال ابن عثمان النيسابوري في تفسيره للقلب السليم: "هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة"، فالله لا يقبل إلا قلبا سلم من الكفر والشرك أولا، ثم قلبا جاء بعيدا عن شره الدنيا حتى يكون هذا القلب على استعداد مطلق ليقين الإيمان وتلقي أسرار الحكمة.
إذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه
أما ابن عاشور في تفسيره للقرآن الكريم فيشير إلى القلب السليم بأنه الموصوف بقوة السلامة، والمراد بها هنا السلامة المعنوية المجازية، أي الخلوص من عقائد الشرك مما يرجع إلى معنى الزكاء النفسي. وضدُّه المريض مرضاً مجازياً، والاقتصار على السليم هنا لأن السلامة باعث الأعمال الصالحة الظاهرية وإنما تثبت للقلوب هذه السلامة في الدنيا باعتبار الخاتمة فيأتون بها سالمة يوم القيامة بين يدي ربّهم .
أما الإمام السعدي فيرى أن المقصود بالقلب السليم الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله وهواه تابعا لما جاء عن الله.
وسلامة القلب أي صحته من الرذائل التي بالضرورة قد توقع بالمرء في شرك أكبر كان أم أصغر كالرياء والنفاق والموالاة، والسلامة للقلب تعني أيضا فراغه من كثرة الكلام في غير ذكر الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسولنا وحبيبنا وسيدنا المصطفى (صلى الله عليه وسلم): "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكره الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي" (رواه الترمذي).
ولاشك أن هناك قلوبا كثيرة أوصدت أبوابها عن الحق، وأصبحت بمنأى عن الاستقامة والهدى، ولكن من رحمة الله بعباده المؤمنين المسلمين أن جعلهم على حالة وصال دائمة بالتقوى والهداية، ففي حديث البخاري عن ابن عباس قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط أي نفر قليلون، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد لم يصدقه بشر، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه! ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم لعلهم قوم عيسى، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك" (مسند الإمام أحمد).
والتصوف الإسلامي يقدم منهاجا رائعا لسلامة القلب في سياج رصين من القرآن الكريم والسنة والنبوية العاطرة، سلامة تصل العبد بربه وتجعل غاية العارف وجود معروفه كما سئل أبو يزيد البسطامي عن درجة العارف، فقال: "ليس هناك درجة، بل أعلى فائدة العارف وجود معروفه" وسئل بماذا يستعان على العبادة؟ فقال: "بالله، إن كنت تعرفه" ويقول عن العارف "من عرف الله فإنه يزهد في كل شيء يشغله عنه".
وإبراهيم بن أدهم صاحب الشخصية الأشهر في تاريخ التصوف وفقا لقصة توبته ذائعة الصيت والذي تركزت أقواله وآراؤه في الزهد حول مراقبة النفس وترك الدنيا والحزن على ما فاته من الطاعات، يشير إلى أن العبد إذا جاد بنفسه لله، أورث قلبه الهدى والتقى، وأعطيَ السكينة والوقار، والعلم الراجح والعقل الكامل. وإذا أردت أيها العبد الطائع إلى ربك أن تكون ذا قلب سليم فالتواضع توجيه أول لعظمة الله، وهي صفة كما يقول ذو النون المصري تذوب وتصفو، ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه؛ لأن النفوس كلها فقيرة عند هيبته.
فَضْلُ التَّوَاضُعِ:
وصاحب الخلق القرآني نبينا الأشرف (صلى الله عليه وسلم) يقول كثيرا في هديه النبوي عن فضل التواضع وذم الكبر والغرور الذي هو بوابة للتهلكة، عن عبدالله بن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بَطَر الحق وغَمْط الناس". (رواه الإمام أحمد). عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرِّ في صُوَر الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى (بولس) تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال". (سنن الترمذي).
وعن ركب المصري رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "طوبى لمن تواضع في غير منقصة [أي: معصية]، وذل عن نفسه من غير مسألة، وأنفق مالاً جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. وطوبى لمن طاب كسبه، وصلحت سريرته، وكرمت علانيته، وعزل عن الناس شره، وطوبى لمن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله". (رواه الطبراني والمنذري).
والتواضع هو عدم التعالي والتكبر كما تشير موسوعة الأخلاق الإسلامية (2012)، ولقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالتواضع، يقول تعالى: (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين). (سورة الشعراء، آية 215). ويقول عز وجل في موضع آخر من الذكر الحكيم: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين). (سورة القصص، آية 83).
والفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الذي كان في بداية أمره قاطع طريق بين أبيورد وسرخس بالقرب من سمرقند بخراسان وكان في عشق جارية كان في طريقه إليها فسمع تاليا يتلو "ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله". (سورة الحديد، آية 16)، فقال: يا رب، قد آن، فرجع. فسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد إليه، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته".
بَيْنَ التَّوَاضُعِ والرِّضَا:
إذا كانت لفظة التواضع مشتقة من الضعة، فالأخيرة هي رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته، وفضيلته لا تكاد تظهر في الناس (موسوعة الأخلاق الإسلامية، 2012، صفحة 207). والرضا ضد السخط، وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: "رضي الله عنهم ورضوا عنه". (سورة المائدة، آية 119)، وبحق أهل الرضا أحوالا ومقامات يرضى الله عنهم، وأهل الرضا لهم جزاء معروف، يقول تبارك وتعالى: "لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد". (سورة ق، آية 35).
وها هو أبو نصر السراج الطوسي الملقب بطاووس الفقراء وأحد أئمة التصوف الإسلامي الذي يوصف دوما بأن كتابه "كتاب اللمع" أول مرجع في التصوف الإسلامي يعرض بشكل متكامل الطريق الصوفي مع ذكر مصادر عديدة له، يقول عن الرضا هو مقام شريف، وهو باب الله الأعظم وجنة الدنيا وهو سكون القلب تحت حكم الله عز وجل. والطوسي نراه في كتابه يعقد الصلة دوما بين حال الرضا ومقام الوجد حيث يقول: "الذي يحجب عن الوجد رؤية آثار النفس والتعلق بالعلائق والأسباب، لأن النفس محجوبة بأسبابها، فإذا انقطعت الأسباب، وخلص الذكر وصحا القلب ورق وصفا، ونجعت فيه الموعظة والذكر وحل من المناجاة في حل غريب، وخوطب وسمع الخطاب بأذن واعية وقلب شاهد وسر طاهر، فشاهد ما كان منه خاليا، فذلك هو الوجد".
الرِّضَا ثَمَرَةُ المَحَبَّةِ:
ومرجع ذلك كله أن الرضا ثمرة المحبة، وهو من أعلى مقامات المقربين والواصلين، ذلك أن الحب يورث الرضا بأفعال الحبيب، وفيما يروى عن أبي طالب المكي الواعظ صاحب كتاب "قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد"، من أن الله تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين فيقول: سلوني، فيقولون: رضاك". وختاما نورد حديث الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) عن الرضا إذ يقول: "إذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه".