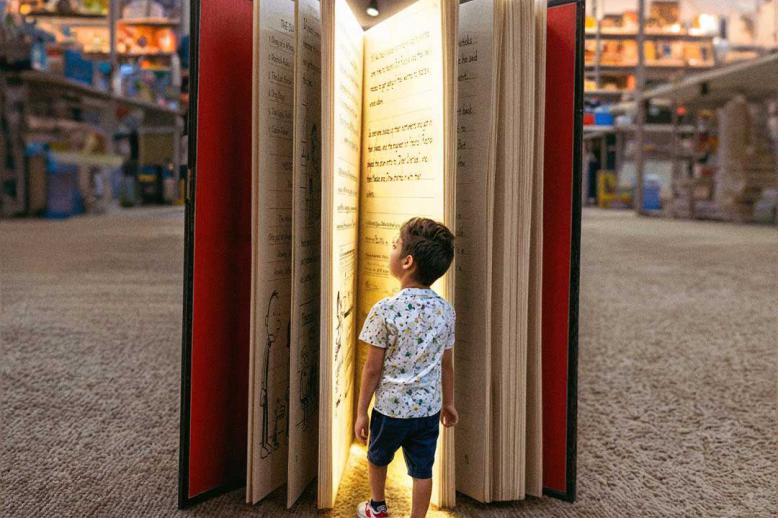باحث يشكك في مقولة نزول القرآن بلغة قريش
قامت فكرة هذا الكتاب "من الوحي إلى المصحف" للباحث محمد حسن بدر الدين على قاعدة أنّ نشوء علم الحديث، والأسس التي تكوّن عليها، هي التي شكّلت طبيعة العلوم الإسلاميّة كلّها دون استثناء، بما فيها علوم القرآن، فلم يفلت من سلطتها أيّ علم، ولم يخرج عن بوتقتها أيّ عالم مهما كانت جرأته. وقد صبغت الفكر الإسلامي وجميع مسائله بطابعها الرّوائي الحديثي والإسنادي. وتبعاً لذلك، لم تخرج معلوماتنا عن جمع القرآن وتدوينه وإعجامه، وما تعلّق به من قراءات واختلافات وأحرف سبعة وأسباب نزول، عن هذا الطّابع. وعلى هذا الاعتبار، إنّ البحث في العلوم الإسلاميّة هو، في واقع الأمر، بحثٌ في الأحاديث والرّوايات.
وميزة هذا الكتاب الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، أنّه طبّق ذلك على موضوعه قيد الدّرس؛ فتناول الرّوايات والنّصوص الخاصّة بمادة المعالجة تناولاً شاملاً ودقيقاً؛ حيث اهتمّ الباحث بجمع الرّوايات من مصادر كثيرة، ورتّبها، وقام بتحليلها وتفكيكها ونقدها، وتركها تفصح عن نفسها وتقدّم مضامينها ورؤاها دون توظيف أو إسقاط.
اهتمّ الباحث بتجديد النّظر في ثلاث قضايا شائكة في الثّقافة الإسلاميّة وشديدة التّرابط هي: القضية الأولى مشكلة تدوين النصّ القرآني: وتتعلّق ببنية المصحف وظروف تدوينه منذ نزوله مروراً بعهد الخلفاء، حتّى آخر أيّام عليّ بن أبي طالب. وقد وقع الاعتناء فيها بتتبّع أحوال المصحف في العهد المكّي ثمّ المدني، ومناقشة موضوع الإعجام والبحث في حركة التّطوير التي خضع لها المصحف، وتعلّقت بتحسين شكله لتسهيل قراءته على المسلمين.
بعض علماء المسلمين من محدّثين ومفسّرين هم الّذين اختلقوا روايات الأحرف السّبعة والقراءات واللّحن في القرآن، وأذاعوها ونشروها بين عامّة النّاس
الثّانية: تجديد النّظر في مشكلة الأحرف السّبعة، وبيان علاقتها بعلم القراءات، ولغة المصحف وقراءاته. وقد تتبّع الباحث أهمّ الأقوال والآراء القديمة والحديثة المتعلّقة بها تعريفاً وتنظيراً وتحليلاً. وخرج بنتائج جديدة أهمّها ضعف الأسانيد التي اعتمدت عليها، وتناقضها فيما بينها، ما يجيز القول بوضعها واختلاقها إثر مقتل عثمان، واضطراب الأحوال السياسيّة والاجتماعيّة، وظهور الفرق والمذاهب المتنافسة التي أيّدت مذهبها بالأحاديث والمرويات.
الثّالثة: قضية مشكلة القراءات، والسّعي نحو فرضها تدريجيّاً، وخاصّة مع ابن مجاهد (245-324هـــ)، والرّبط بينها وبين المصاحف. وهذه المسألة مرتبطة بسابقتها، ولذلك بحث الباحث في وجوه الالتقاء بينهما. وكانت النتائج مخيّبة للآمال؛ إذ لم تفلح القراءات في حلّ مشاكل الاختلاف في قراءة نصّ التّنزيل؛ بل زادتها اضطراباً.
وأوضح الباحث أنه رُوعي في تسمية القرآن، كما لاحظ محمّد عبدالله دراز (1894-1958)، كونه متلوّاً بالألسن، وروعي في تسميته كتاباً كونه مدوّناً بالأقلام .وقال "بين الألسن والتّدوين بالأقلام تكمن طبيعة هذا البحث وإشكاليّاته وغاياته وأهدافه؛ فهو تدقيق حول الصّلة بين حركة التّدوين وظروف نشوء العلوم الإسلاميّة الأولى، ولاسيما علوم الأحاديث والقراءات، باعتبارها علوماً مسنَدة تعتمد على الرّوايات والمنقول من الأخبار. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تكون مصدر اتّفاق؛ بل هي أساساً مصدر اختلاف؛ لأنّها قامت على الأخبار وأقوال الرّواة، فهي متضاربة بطبيعتها بحكم اختلاف هؤلاء الرّواة في الثّقافة والفهم والنّظر والقدرة على النّقد والتّمييز.
واختلف الباحث مع المقولات التي دافع عنها نصر حامد أبو زيد (1943-2010) في كتابه "مفهوم النصّ"، واختار منها مقولتين: المقولة الأولى: أنّ القرآن يصف نفسه بأنّه رسالة؛ والرّسالة تمثّل علاقة اتّصال بين مرسل ومستقبل من خلال شفرة أو نظام لغوي. ولمّا كان المرسل في حالة القرآن لا يمكن أن يكون موضوعاً للدّرس العلمي، فمن الطّبيعي أن يكون المدخل العلمي لدرس النصّ القرآني مدخل الواقع والثّقافة .
المقولة الثّانية: أنّه لا خلاف بين علماء الأمّة، على اختلاف مناهجهم واتّجاهاتهم قديماً وحديثاً، في أنّ الإسلام يقوم على أصلين هما: القرآن والحديث النبويّ الصّحيح. هذه الحقيقة لا يمكن التّشكيك في سلامتها.

وقال الباحث "لا ندري لماذا اعتمد نصر حامد أبو زيد هذه الأحكام المطلقة في بداية دراسته لمفهوم النصّ القرآني، مع أنّها تقوم على مسلّمات خاطئة. فليس مطلوباً أصلاً، عند دراسة أيّ نصّ، أن ندرس الكاتب. ولا وجود لمدخل علمي محدّد لدراسة النصّ كما افترض في تعميمه. وإنّما هي مناهج ومقاربات شتّى تفرضها طبيعة الموضوع المدروس ومقتضياته. كما لا يوجد اتّفاق بين علماء الأمّة قديماً وحديثاً على أنّ الإسلام يقوم على أصلين؛ فعن أيّة أمّة يتحدّث، وعن أيّ علماء؟ أليس لكلِّ واحدة من فِرق الخوارج والشّيعة والزيديّة والإباضيّة منظومتها وأصولها؟ على أيّة حال، لم نعتمد في هذا البحث التّدقيق في الجزئيّات المتعلّقة بالتّعريفات والمفاهيم المعلومة أو التّراجم المشهورة، ولكن بحثنا في الجذور العميقة، التي كوّنت الأفكار والآراء المتعلّقة بالخصوص بتاريخ القرآن، وظهور القول بالأحرف السّبعة، وربطها بسياقها التّاريخي والمعرفي، بالتّركيز على الأخطاء الواردة في الأفهام والمناهج، وعدم الخضوع للآراء السّائدة في أدبيّات الفكر الإسلامي".
ولفت أن الهدف من تجديد النظر في هذه القضايا الشائكة "مشكلة تدوين النصّ القرآني، ومشكلة الأحرف السّبعة، ومشكلة القراءات" كان "إزالة الغموض عن البدايات التي تكوّن فيها المصحف، وتتبّع مراحل تدوينه، عبر قراءة جديدة تتجاوز المفاهيم السّائدة والمعارف المكتسَبة عبر القرون الماضية، التي شكّكنا في متانتها وأصالتها بحجج نقليّة وعقليّة، لنؤسّس تصوّرات جديدة ومضبوطة حول جمع نصّ التّنزيل حتّى استقرّ على هيئته الحاليّة.
وقال إن هذه التصوّرات الجديدة ارتكزت على مبدأ أنّ القرآن لم يدوّن رسميّاً في الفترة المكيّة، وإنّما برزت مبادرات شخصيّة من بعض الصّحابة في تكوين مصاحف خاصّة بهم. وقد ارتبط ذلك بمبدأ الانتظار حتّى يكتمل الوحي. قدّمنا جديداً في هذا السّياق وهو أنّ عبدالله بن أبي السّرح لم يكن من كتّاب الوحي في الفترة المكيّة، وأنّ قصّة ارتداده لفّقها خصومه السياسيّون. وعلى هذا الأساس لم يُجمع القرآن في العهد المكّي ولا في العهد المدني، وإنّما ظلّ محفوظاً وموزّعاً على الأدوات السّائدة للكتابة مثل: الجلود والرّقاع واللّخاف والأكتاف. ورجّحنا، تبعاً لذلك، أنّ ما فعله أبو بكر الصدّيق في عهده لم يكن جمعاً رسميّاً ولا تدويناً للقرآن، وإنّما هي نسخة شخصيّة اتّخذها لنفسه، ولم يفرضها على أحد من النّاس، ولم يعطها لأحد منهم. وكشفنا أنّ المراحل التي مرّ بها الجمع في عهد الخلفاء إنّما أملتها الضّرورة بسبب الاختلاف في القراءة؛ وهذه الاختلافات كانت من صنع الصّحابة أنفسهم.
وأضاف الباحث أن البحث قدّم جديداً أيضاً حول التّدوين زمن عليّ بن أبي طالب، وقد ظلّ مغيّباً في الكتب القديمة والحديثة. فقد اكتشفنا أنّ قضيّة اللّحن لم تتعلّق بأخطاء عمليّة، وإنّما وردت بعض الصّيغ والتّعابير في القرآن التي تخالف النّظام النّحوي الإعرابيّ الذي وضعه علماء اللّغة بعد نزول القرآن؛ فظهرت وكأنّها خارجة عن مألوف اللّغة، ولكنّها سليمة بحسب بعض اللّهجات القبليّة الأخرى.
وأشار إلى أنه إثر مقتل عثمان ازدهرت حركة الوضع والاختلاق للنّصوص الدينيّة المتعلّقة بالقرآن نتيجة الصّراعات السياسيّة والطائفيّة. وفي خضمّ هذا السّياق المضطرب اختلقت الرّوايات حول اللّحن والأحرف السّبعة والقراءات. وقد لاحظنا خلطاً شديداً بين اللّغة واللّهجة في فهم موضوع الأحرف السّبعة عند العلماء المسلمين، ما أسهم في حصول مزيد من الغموض في استيعاب هذه المشكلة. كما حصل الخلط أيضاً في حصر القراءات في سبعة أوجه. وقد ظهر ذلك متأخّراً بعد جيل الصّحابة بقرنين على الأقلّ.
وشكّك الباحث في مقولة نزول القرآن بلغة قريش مبينا أنّ لغة القرآن أوسع وأشمل، كما بين في مبحث إشكاليّات الالتقاء بين القراءات والأحرف السّبعة أنّ الرّبط بينهما كان جهداً ضائعاً؛ حيث ظلّ المفهوم مبهماً في الفكر الإسلامي إلى اليوم؛ لأنّه قام على اختلافات لا يمكن الجمع بينها.
وقال "ظهر القول بقراءة القرآن بالمعنى؛ أي التّلميح بتحريف القرآن بصورة خفيّة، في منتصف القرن الأوّل الهجريّ، وتمثّلت في تلك الرّوايات حول الأحرف السّبعة التي فاق عددها نسبيّاً كلّ الموضوعات الأخرى في الحديث. ثمّ بدأ الفقه يؤيّد ذلك على لسان مالك بن أنس، وسفيان بن عُيينة، والطّحاوي، والطبريّ، وغيرهم؛ وتابعهم في ذلك كلّ من جاء بعدهم، وإن لم يصرّح بعضهم. أمّا ابن حجر العسقلانيّ فقد جعل من الإبدال والتّغيير في بعض مفردات القرآن قاعدة لقراءته وكتابته، على الرغم من أنّ القرآن في عقيدة جميع المسلمين ليس من كلام جبريل أو محمّد ليتصرّفا فيه بأيّ وجه من الوجوه.
وأكد الباحث أن الرّسول لم يكن يسمح لأيّ قارئ بأن يتلاعب بالقرآن لفظاً ولا لحناً ولا رخصة وقتيّة ولا توسعة، لأنّه يعلم أنّه إذا انتشر القرآن بالقراءة بالمعنى؛ أي باختلاف في اللّفظ، فإنّه لا يمكن بعد ذلك توحيده، فيكون محرّفاً منذ نزوله. فضلاً عن أنّه ليس من أدبه، ولا من بلاغته، أن يقول ما نَسبه إليه المحدّثون في روايات الأحرف. ولذا نرجّح أنّ حديث عمر واختلافه مع هشام بن حكيم هي قصّة موضوعة لا تليق بعمر ولا بهشام، ولا تصمد أمام النّقد التّاريخي. أمّا ما نُسب إلى ابن مسعود وأُبيّ بن كعب، فهي مجرّد آراء شخصيّة، إن افترضنا صحّة الإسناد إليهما؛ وهي - لا محالة - آراء تتناقض مع القرآن. ولذا نرجّح أنّ ما نُسب إليهما هي روايات ملفّقة.
وشدد على أن المفسّرين لم يأتوا بأيّ قول أو شرح لغويّ أو معنويّ لأيّة رواية في تلك الأحرف سوى الخلط واللّغو، ولن يأتي أحد بقول منطقيّ ذي بال؛ لأنّ تلك الرّوايات لا تقوم على مضمون واضح؛ ولذلك ظهر التكلّف والإسفاف في تأليفها. وقد تبيّن أنّ أغلب النّصوص، التي كدّسها الطبريّ في تفسيره، موضوعة، وأنّ الحاكم صحّح روايتين لا أصل لهما، فالوضع قاسم مشترك بين تلك الرّوايات والأخرى الّتي في الصّحاح والسّنن؛ لأنّ المضمون الأصليّ للرّوايات واحد والغاية واحدة. لذلك، يتّضح أنّه لا يثبت نصّ مهمّ من تلك الرّوايات المتعلّقة بالأحرف، ثلاثة كانت أو سبعة أو عشرة؛ لما فيها من تناقضات وغياب انسجام.
ومع الأسف، إنّ بعض علماء المسلمين من محدّثين ومفسّرين هم الّذين اختلقوا روايات الأحرف السّبعة والقراءات واللّحن في القرآن، وأذاعوها ونشروها بين عامّة النّاس، وشرحوها وبيّنوا ضرورتها؛ وإن قال بعضهم بضعفها أو وضعها. وبذلك يكون الوضّاعون زرعوا بذور التّحريف، ورعاها أهل الحديث بالشّرح والتّصنيف.