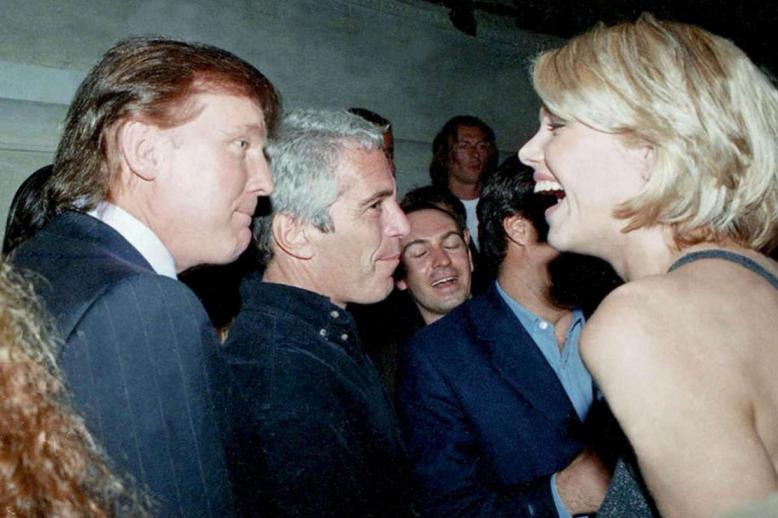حين لا يكون الصمت فضيلة
لو ان تسوية 2016 أنقذت لبنان، لكنا فهمنا دفاع أركانها عنها، لكنها أنهكت لبنان وأضعفت العهد والحكومة. والطريف أن المتضررين منها هم من يدافعون عنها، والمستفيدون منها هم من يعتدون عليها. ولو ثبتت جدوى حكومات التوافق المعتمدة كأنها التزام بنص دستوري، لكنا فهمنا كذلك تكرار تأليفها، لكنها جمدت العمل بالنظام الديمقراطي البرلماني، وأخضعت لبنان لـ"نظام الشورى" المعمول به في دول غير برلمانية، أي أنه جرى تغيير النظام اللبناني من دون تعديل دستوري.
ماذا بقي بعد من لبنان؟ غيروا هويته، غيروا ميثاقه، غيروا نظامه، غيروا حضارته، غيروا خصوصيته، غيروا مناخه، غيروا فئة دمه، وها هم يغيرون شعبه... ولا أحد يثير المصير. بلعوا ألسنتهم. الرجاء السكوت، لبنان يحتضر. حتى أن العسكر المتقاعدين سكتوا وخيبوا الأمل بعد المجتمع المدني والطلاب والأحزاب.
حين تغطي التسوية الغبن تصبح غلبة. وحين يغطي التوافق التآمر يصبح تواطؤا. وحين تغطي الحكمة الانحراف تصبح غباء، وحين يغطي الصبر التمادي يصبح ضعفا. وحين تغطي الشرعية، بجميع مؤسساتها، ما هو ليس شرعيا تصبح في طور الأفول. وحين يسكت الوطنيون في السلطة والمجتمع عن كل ذلك يصبحون جزءا منه. سنة 399 ق.م. حكم مجلس أعيان أثينا بالموت على سقراط، الفيلسوف، لمجرد أنه لازم بيته ولم يغادر المدينة حين حكمها "القضاة الثلاثون" وعاثوا بديمقراطية أثينا.
ألا نلاحظ أننا نعيش واقع دولة تحت العقوبات من دون عقوبات دولية؟ عقوباتنا سيادية. إنتاج محلي. صناعة وطنية. منذ سنوات والطبقة السياسية تمارس سياسة وقعها على الشعب اللبناني مماثل وقع العقوبات الأميركية على الشعب الإيراني: العقوبات الدولية على إيران هدفت إلى تجويع الناس، وضرب الاقتصاد، والحد من التصدير، ومنع الاستثمار، وخفض النمو، وتهديد النظام النقدي، ورفع نسبة البطالة، ودفع الشعب إلى التظاهر والإضراب... فها نحن في لبنان نعاني، بفضل الدولة، كل هذه الحالات من دون عقوبات دولية.
ماذا ينتظر أصحاب الحس الوطني - أكانوا في الحكم أم في المجتمع - ليرفعوا هذه "العقوبات" عن الشعب، ليعيدوا النظر بمواقفهم وبتحالفاتهم وبصمتهم؟ إذا كان النجاح معيار التسوية فقد فشلت، وإذا كانت الصفقات معيارها فقد "سبق الفضل"، وإذا كانت تحولات مرتقبة في المنطقة معيارها فيجب أن نلاقيها لا أن ننتظرها. ما لا يدركه "المنتظرون" هو أن مراكز القرار الدولي، خلافا للماضي، لم تعد تميز في لبنان بين موال طوعا وموال قسرا، وباتت تضع مكونات التسوية في سلة واحدة، وتفكر في منظومة بديل من خارج الطبقة السياسية اللبنانية المدنية. وهي تلتقي بذلك مع الشعب اللبناني الذي سئم الجميع (وجدد للجميع). لكن هل يكون "خيار" مراكز القرار أفضل من خيارات الشعب السيئة؟ وأصلا: هل هي مسؤولية مراكز القرار أن تقود التغيير في لبنان، أم واجب الشعب أن يقرر مصيره ويحمل قدره ويحسم خياره؟ لا بل هو دور الدولة إن تقوم بالتغيير في الدول الديمقراطية.
لا تنحصر المشكلة القائمة بموالاة عهد ومعارضة حكومة. الأزمة أعمق بكثير وتطال مصير البلد لا مصير العهد والحكومة فقط. إنها محاولة استخدام الدولة لإعادة الوطن إلى ما قبل 2005، بل إلى ما قبل 2000؛ فيمسي لبنان حالة عددية بالنسبة للبعض، وامتدادا عضويا لنوعية الحل السوري/الإيراني للمنطقة بالنسبة للبعض الآخر، علما أن الحل الأميركي ليس بأفضل ما دامت "صفقة القرن" عنوانه والتوطين الفلسطيني اقتراحه. ما لم تكن لدى القوى الاستقلالية القدرة على قلب الطاولة من الداخل، بقاؤها في الحكم صار مشاركة واعية أو جاهلة في هذا المشروع.
منذ التسوية سنة 2016، حصلت تطورات دولية وإقليمية كان يفترض أن تصب في مصلحة القوى الاستقلالية لو أحسنت القراءة الجيوسياسية وأجادت العمل الوطني. فسلاح حزب الله أصبح "سلاحا" بيدها، لا بيده، بعد العقوبات عليه وانسحاب أميركا من الاتفاق النووي. لكن، عوض أن تستخدم القوى الاستقلالية هذا "السلاح"، بمعنى الورقة الضاغطة، قدمت سلاحها، التسوية والحكومة، لحزب الله لكي يستخدمهما ضدها.
ليس المطلوب من القوى الاستقلالية الخروج من الحكومة كمجلس وزراء، بل من هذه المنظومة التسووية التي تشكل الحكومة إحدى حلقاتها وأدواتها التنفيذية. أما القول إن الاستقالة تدخل البلاد في المجهول، فهو ذريعة للهروب من القرار الجريء. لا يوجد في السياسة مجهول ومعلوم، بل إرادة وتخاذل. التخاذل يجعل المعلوم مجهولا، وهذه هي حالنا؛ والإرادة تجعل المجهول معلوما، وهذا هو أملنا الباقي.
إن الخروج من الحكومة لممارسة معارضة تقليدية لا لزوم له، فهو مشاركة في الحكم بطريقة مختلفة لأن المعارضة التقليدية في مثل هذه الحالات لا تشرع السلطة - وهي شرعية - بل المشروع الآخر المشكو منه. لذا، ليست الحاجة إلى موالاة أو معارضة، بل إلى خلق منظومة وطنية جديدة تقدم نفسها للشعب والعالم بديلا من مسار التراجع والانهيار، وتثبت أهليتها لاستعادة لبنان ووقف عملية تغييره الجارية منذ ثلاثين سنة.
تصطدم هذه الفكرة بعائقين جديين: الأول هو صعوبة إيجاد هذه المنظومة من دون الاستعانة بجزء من القوى السياسية حتى لو وقع الخيار على مجموعة غير مدنية. الثاني: عدم وجود حل دستوري جاهز حاليا للأزمة الوجودية التي يعيشها لبنان يحوز على تأييد متعدد الطوائف. هذا الواقع المزدوج يحتم حصول تعديل في ميزان القوى، أو على الأقل، تعديل في نوعية التحالفات.
حبذا لو يبادر رئيس الجمهورية، بعد، إلى "الإصلاح والتغيير"، هو الذي انتخب في ظلاله، فيعفي الشعب والمجتمع الدولي من هذه المهمة الشاقة. أهذا هو الحل أم هو العائق الثالث؟