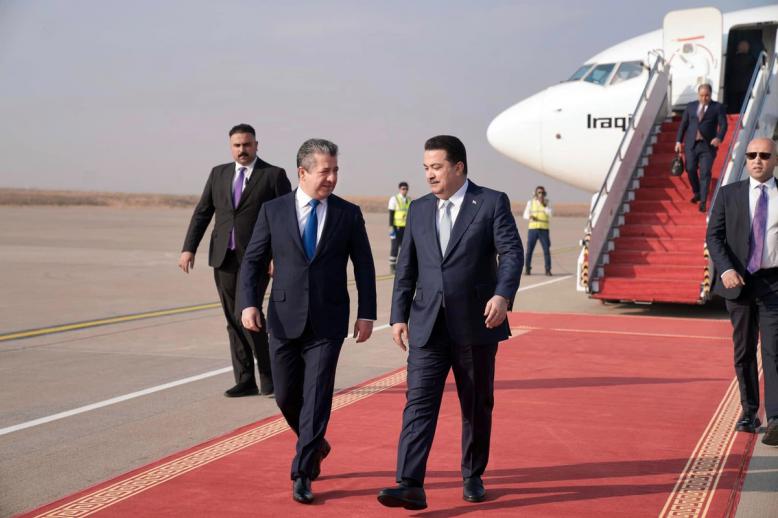خطاب الكراهية في سوريا.. من القصة السريرية إلى القيامة
فاز هذا المقال بجائزة المركز الأوّل في الدورة الأولى لمسابقة «100 صوت سوري ضد خطاب الكراهية» .
مضت عشر سنوات ونيف على اندلاع الحرب السورية التي مورست فيها شتى أنواع العنف، وأدت إلى دمار هائل للبشر والحجر.
عشر سنوات والخطاب الأكثر استخداماً من الفاعلين في الحرب هو خطاب الكراهية، والنتيجة حاضر مأسوي، ومستقبل غامض يخشى كثير من السوريين أن يجعلهم يترحمون على الحاضر المأسوي الذي يعيشونه (أقله المستقبل القريب)، فكيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ وماهي الأسباب؟
هل فعلاً كنا نعيش قبل العام 2011 حياة مثالية تسودها المحبة، والعدالة، والمساواة كما يصورها قسم من السوريين؟ هل يصح ما يردده البعض من قبيل «والله قبل كنا كلنا إخوة، ولم نكن نعرف أو حتى نهتم بمعرفة مذاهب أو قوميات بعضنا، ولم نكن نعرف معنى الكراهية»؟ وأكثر من ذلك قول البعض إن «خطاب الكراهية دخيل على ثقافتنا وظهر بفعل التدخلات الدولية التي تريد الشر بنا»؟
هل كان هذا حالنا فعلاً قبل العام 2011؟ وهل يعقل أن ينقلب الحال 180 درجة بين عشيّة وضحاها - كما يقال - بفعل تدخلات خارجية؟
وهل فعلاً خطاب الكراهية دخيل وطارئ على ثقافتنا؟
قصة سريرية
يُجمع الأطباء على أن أولى الخطوات العلاجية هي اعتراف المريض بمرضه، والخطوة الثانية التي يُبنى عليها اختيار طريقة العلاج هي تشخيص المرض عبر توجيه أسئلة إلى المريض، لتكون أجوبته عماداً لما يُعرف طبياً بالقصة السريرية.
في محاولتي الأولى لتكوين قصة سريرية للعنف المفرط الذي استخدم في الحرب السورية توجهت إلى أفراد ينتمون إلى شرائح مختلفة من المجتمع السوري بأسئلة مباشرة عن موضوع الكراهية، لاقتناعي بأن العنف يولد من الكراهية، فيستحيل أن تمارس العنف بحق شخص تحبه، أو حتى لا تشعر بالكراهية نحوه.
كانت معظم الإجابات رافضة لمنطق الكراهية (حتى ممن ينخرطون في الأعمال العسكرية)، ونافية بشكل حازم الشعور بالكراهية تجاه الآخر، في حالة إنكار غريبة.
قررت أن أعيد المحاولة، ولكن مستخدماً أسلوب الأسئلة غير المباشرة، ثم الاستماع إلى أجوبة عن أمثلة طرحتها، وتركت للمستهدفين المجال للاستطراد في سرد قصص وأمثلة مازالت عالقة في أذهانهم.
من الأسئلة التي طرحتها على المستهدفين:
- إن كنا فعلاً قبل العام 2011 لا نعرف، ولا نهتم لدين ومذهب وقومية الآخر، فكيف تفسر وجود مناطق معروفة بلون ديني، أو مذهبي، أو قومي واحد (وهنا لا أتحدث عن القرى والمناطق التي يقطنها سكانها منذ مئات السنوات، بل عن الأحياء والضواحي المبنية حديثاً، على سبيل المثال أحياء عكرمة الجديدة، والإنشاءات، ووادي إيران البياضة في حمص، والمزة 86، وجرمانا، والسومرية في دمشق، وأحياء العزيزية فيلات، والشهباء، والشيخ مقصود، والحيدرية، والميسّر في حلب، والصليبة، وحارة علي جمّال في اللاذقية...إلخ).
كم علاقة عاطفية ناجحة سمعت بها كان طرفاها مختلفَين دينياً أو مذهبياً رغم أننا درسنا في مدارس وجامعات واحدة؟ ألا يشير هذا إلى أننا كنا نمارس رقابة ذاتية على عواطفنا قد تصل أحيانا درجة الكبت كيلا نتسبب لأنفسنا ولأهلنا بإشكالات كبيرة تبدأ من الوصم بالعار، وقد لا تنتهي إلا بسفك دماء هنا وهناك لإزالة «وصمة عار» حب عابر للطوائف والأعراق، في ترجمة لمثل شعبي شهير «يللي بياخد من غير ملته بموت بعلت»؟
سأحاول تقديم صياغة أمينة لبعض الأجوبة والأمثلة التي طرحها المستهدفون، تحمل في مضمونها أسباب الشعور بكراهية الآخر ونتائج هذا الشعور:
«تغدى عند الحوراني ونام عند الدرزي» (مع الإشارة إلى صياغة أخرى لهذا المثل تُستخدم في حلب: «تغدى عند اليهودي ونام عند النصراني»): مثل شعبي سوري قد يبدو للوهلة الأولى أنه يحمل مدحاً للطرفين (الحوارنة والدروز) لكن المتعمق في مضمونه سيلاحظ حتماً أنه جاء متناغماً مع خطاب كراهية مركّب: أولاً ديني يستهدف فئة (لا يجوز تناول طعامها لنجاسته)، وثانياً مناطقي وعشائري يستهدف الفئة الأخرى (إياك أن تبيت عندهم فالنائم مثل الميت لا يشعر بما يجري حوله، وهؤلاء لا يؤتمن جانبهم).
كنت أتطلع إلى معسكر الصاعقة (معسكر في المرحلة الثانوية يستفيد المشاركون فيه علاماتٍ تضاف إلى علاماتهم في الشهادة الثانوية أثناء تقدمهم إلى مفاضلة القبول الجامعي) ليكون فرصة لتحسين وضعي في المفاضلة، وفرصة للتعرف على أصدقاء جدد من مناطق مختلفة، لكن بعد ثلاثة أيام قررت الانسحاب من المعسكر، والعودة إلى السلمية لأنني لم أتحمل ما كان البعض يظنونه دعابة تمس معتقداتي، ويتبادلونها كلما مررت بجانبهم (...............)، والأغرب أن أحد المتعاطفين معي أثناء تدخله زاجراً ومهدداً أولئك المتنمرين صرخ: «بلا قلة أدب وسخافة، ولك هدول يللي عم تتمسخر عليهم هني (حسب القول الدارج) أهل الفكر، والفقر، والكفر»!!! كفر... كفر... كفر... إن كان المتعاطف معي يصفني بالكافر فما الذي أفعله هنا؟!
كنت سعيداً وأنا أقدم ليرة سورية لأستاذي تبرعاً للصومال (أيام ما كانت الليرة تحكي، وأيام ما كنا نبعت مساعدات في ثمانينيات القرن الماضي)، تلقفت إيصال التبرع بلهفة واعتزاز، وقرأته بصوت مسموع: «تبرع من الشعب العربي السوري لشقيقه الشعب العربي في الصومال»، ثم وببراءة طفل لم يكمل عامه العاشر توجهت إلى المعلم: «أستاذ، أستاذ في خطأ، هاد الوصل مو إلي، هاد مكتوب عليه عربي سوري، وأنا كوردي سوري». بمجرد أن أنهيت عبارة «كوردي سوري» كانت يد المعلم تصفع وجهي صفعة أسقطتني على الأرض، ثم عاجلني بركلة، وأتبعها بشتائم، وتهديد ووعيد إن عدت إلى حديث كهذا. أثناء عودتي إلى المنزل شاهدت مشاجرة بين سائقين تدخل أحد المارة بينهما مصلحاً، وسمعته يخاطب أحد السائقين قائلاً: «الشغلة ما بدها عناد، فضوها سيرة، وبلا تجحيش يا زلمة، لو ما بعرفك كنت قلت أصلك كردي»!
أثناء مغادرته القاعة سُمِع صوته وهو يخاطب بعض المتجمهرين حوله بجملة: «شو شايفيني شاوي»؟ متبوعة بقهقهة عالية علقت في أذهان الحضور أكثر مما سرده في محاضرته عن العروبة.
في صبحية نسائية كانت تشتكي لصديقاتها من إهمال ابنتها للدراسة، وتَراجع علاماتها، فتقول: «الله يخلصني منها على أهون سبب، والله لزوجها لأول واحد بدق بابنا، حتى ولو كان نازح». (نازح نسبة إلى السوريين الذين نزحوا من الجولان المحتل إثر حرب حزيران 1967).
توجه في الخطبة الثانية بالدعاء، والمصلون يؤمنون خلفه، ومما ورد في دعائه: «اللهم شتت شملهم، ويتم أطفالهم، ورمّل نساءهم واجعلهن سبايا لنا». لا أذكر من كان المستهدف بالضبط من دعاء خطيب الجمعة ذاك، لكن كمية الكره والعنف في هذا الدعاء كافية لإغلاق باب التسامح والحوار مع الآخر المختلف عنك، أو معك، بغض عن النظر عن مقدار الاختلاف، ومضمون الشيء المختلف عليه.
اليوم نرى أن كثيراً من السوريين طبقوا مضمون ذلك الدعاء بحذافيره على المختلفين معهم من أشقائهم السوريين، فواقع الحال أننا ساهمنا بتشتيت شملنا، ويتمنا أطفالنا، ورملنا نساء سوريات، ومع كل أسف وخزي قسم منهن أصبحن سبايا فعلاً.
تشريح
ما تقدّم عينة فقط من الأمثلة والقصص التي تشير بشكل واضح إلى أن خطاب الكراهية ليس أمراً طارئاً ودخيلاً على الحياة السورية، لكنه تفجر وتوسع بشكل مخيف بعد العام 2011، لأسباب عديدة، أهمها:
انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فالعالم الافتراضي أتاح للعاملين على نشر خطاب الكراهية تحقيق نتائج أفضل بجهد ووقت وإمكانيات أقل، فكل ما تحتاجه للوصول إلى عدد كبير من المتلقين المتنوعين المنتشرين في أمكنة كثيرة «لابتوب» أو «موبايل»، وشبكة إنترنت، وحساب قد يُنشأ باسم مستعار في كثير من الأحيان.
السبب الأهم تحول سوريا إلى ساحة لتصفية حسابات وتنافس على تمرير مشاريع اقتصادية وسياسية، ما وفر إمكانيات ضخمة استُخدم جلها في ترويج خطاب الكراهية، فالحروب تحتاج إلى كارهين، لا إلى متحابين، وهذا قد يفسر عدم التكافؤ بين المروجين لخطاب الكراهية والمتصدين له من حيث الإمكانيات والنتائج، فكثير من الاجتماعات والأبحاث والمقالات كان عنوانها «التصدي لخطاب الكراهية»، لكن واقع الحال أن خطاب الكراهية والعنف الناجم عنه في حالة انتشار مستمر. وإضافة إلى الإمكانيات الضخمة التي وضعت في خدمة خطاب الكراهية نرى عوامل أخرى، منها:
الانتقائية والازدواجية لدى البعض ممن كتبوا وعملوا على التصدي لخطاب الكراهية، ولكن متى؟ فقط عندما يكون خطاب الكراهية يستهدف مصالحه (أبناء دينه ومذهبه، أو عرقه، أو جماعته، أو عندما يكون خطاب الكراهية يستهدف مصالح الجهة الممولة له)، بينما يأخذ «وضع المزهرية» كما يقال عندما يكون المستهدف من خطاب الكراهية منافس، أو «عدو» له.
قلة المتصدين لخطاب الكراهية قياساً بالعاملين على نشره، فالمتصدي لخطاب الكراهية في منطقتنا يعاني غالباً من ضغوطات مادية ومعنوية، بل وحتى أمنية. هذه الضغوطات تبدأ بحرمانه من فرص العمل، مروراً بوصفه بالرمادي اللامبدئي، وانتهاء بخطفه أو اعتقاله، أو حتى هدر دمه.
العاملون على نشر خطاب الكراهية يستخدمون لغة بسيطة سهلة الفهم، وسلسة الوصول إلى عامة الناس عبر مداعبة غرائزهم. أما المتصدون لخطاب الكراهية فقد غرق قسم منهم في خطاب نخبوي صرف، وبالتالي بقيت أبحاثهم، ودراساتهم، واجتماعاتهم، ومقالاتهم أسيرة أدراج النخب التي هي في الأساس محصنة من الوقوع في فخ التضليل وممارسة العنف بسبب خطاب الكراهية، فالنخبوي الحقيقي من الصعوبة أن يكون مضلَّلاً (بفتح اللام) منقادا إلى ممارسة العنف تحت تأثير خطاب الكراهية، وقد يكون مضلَّلاً (بكسر اللام، هذا إن صح اعتباره من النخبة مع تجاوز الشرط الأخلاقي).
إسعاف
بناء على كل ما تقدم، أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة تقييم للجهود التي بُذلت (ولبعض باذلي الجهود) في التصدي لخطاب الكراهية، والعمل على تشكيل «منتخب سوري للتصدي لخطاب الكراهية»، منتخب عابر للطوائف، والأعراق، والأيديولوجيات، والاصطفافات السياسية، ويقع على عاتقه:
بناء استراتيجية مستدامة للتصدي لخطاب الكراهية، يكون هدفها الوصول إلى عقول وقلوب السوريين والسوريات.
ابتكار حلول إسعافية للحد من العنف الممارس الناجم عن خطاب الكراهية، ولدرء موجة عنف محتملة ومرشحة لتكون أشبه بتسونامي، أو لنقل: درء الانفجار الكبير الذي نشعر باقترابه ولا نراه، انفجار كهذا إن وقع سيرسم حدوداً بالدم لدول منكوبة مسلوبة ستبقى غارقة في الدم.
مفهوم الحلول الإسعافية لا يعني بالضرورة تقديم علاج يقضي على المرض من جذوره، وإنما العمل على إنقاذ حياة المريض، وإبعاد الخطر عنه، تمهيداً للبدء بالعلاج المطلوب الذي قد يكون طويل الأمد. واستناداً إلى هذا الفهم أقترح أن يرتكز الحل الإسعافي لمعالجة خطاب الكراهية في الحالة السورية على ركيزتين اثنتين:
الركيزة الأولى: الكراهية ليست غاية، بل وسيلة تستخدم لتحقيق أهداف سياسية اقتصادية.
يتفق الكثيرون على أن أهم حوامل خطاب الكراهية في الحالة السورية: الدين والمذهب، العرق والقومية، المناطقية والعشائرية. فما الغاية الحقيقية من خطاب الكراهية والعنف الممارس في الحالة السورية؟ هل فعلاً تخاض المعارك (بالعموم) لتحقيق أهداف دينية أو قومية صرفة؟ أم أن الرايات الدينية، والشعارات القومية ما هي إلّا واجهة تستخدم لإخفاء الأهداف الحقيقية (اقتصادية - سياسية)، وتأمين أكبر عدد من المحاربين المتفانين؟
نستذكر على سبيل المثال:
إبادة الهنود الحمر في القارة الأميركية تحت عنوان التبشير المسيحي وتخليص الهنود من وثنيتهم (ينصح بقراءة رسائل المطران بوتولومي دي لاس كازاس).
محارق اليهود النازيّة تحت عنوان ديني عرف بـ «الهولوكوست» (الحرق تضحية من أجل الله).
الإبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطنة العثمانية بحق الأرمن مطلع القرن العشرين تحت شعار محاربة الكفار.
مجازر عصابات «إسرائيلية» (الهاغاناه - الأرغون - شتيرن) بحق الفلسطينيين.
وسأقف ببعض التفصيل عند معارك كان طرفاها الأساسيان يتبعان ديناً واحداً، أو ينتميان إلى قومية واحدة، مقتصراً على تقديم أمثلة لمرحلة ما بعد النبوة (كيلا ننجر إلى نقاشات لا طائل منها تحرف بوصلتنا وتبعدنا عن الهدف الحقيقي):
حصار مكة المكرمة، وضرب الكعبة المشرّفة (قبلة المسلمين) بالمنجنيق من قبل جيش الخليفة المسلم عبدالملك بن مروان أثناء معركة كان طرفها الثاني خليفة مسلماً أيضاً، هو عبدالله بن الزبير. هل كان الهدف من كل ما جرى «إعلاء كلمة الله ونصرة الدين»؟!
بما أن البعض يسعى إلى حصر خطاب الكراهية بالمسلمين (في إطار ما بات يعرف بالإسلاموفوبيا) متجاهلين حقيقة أن كل الأديان، والمذاهب عانت من وجود رجال دين متطرفين انتهازيين سوّقوا لخطاب الكراهية خدمة لأجندات سياسية، واقتصادية تبناها الحكام (أي كانوا علماء السلاطين والملوك كما يقال)، فمن المفيد أن نذكر على سبيل المثال بحرب الثلاثين عاماً، التي اندلعت قبل نحو أربعمئة عام في أوروبا الوسطى، ودارت أغلب أحداثها على الأرض الألمانية. انتهت الحرب في العام 1684 باتفاق مونستر الذي أعاد تشكيل القارة الأوروبية من جديد، ورسم حدوداً جديدة، ويعتبر البعض أن اتفاق مونستر هو حجر الأساس الذي هندس وشكّل القارة الأوروبية بشكلها الحالي، وتنوع أنظمة الحكم فيها. بنظرة إلى مجريات الحرب، والمتدخلين فيها، نرى أن الغاية الحقيقية للحرب لم تكن دينية، (السلطنة العثمانية المسلمة كانت من بين المتدخلين في الحرب رغم أن طرفيها الأساسيين يدينان بالمسيحية، وخاضا الحرب تحت شعارات مسيحية). وكيلا يشكل على القارئ/ـة بعد هذه الاستفاضة، نحن هنا لا ننفي بالمطلق دور الدين في اندلاع الحروب، ولكن نسعى إلى توضيح أن الدين في كثير من الأحيان لم يكن السبب الرئيس والحقيقي، وتحديداً كما أسلفت في مرحلة ما بعد النبوة.
الحرب الباردة بين جناحي حزب البعث، العراقي والسوري، التي بلغت ذروتها في ثمانينيات القرن الماضي. حرب بين جناحي حزب واحد، له شعار واحد، (أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة)، فهل فعلاً كان السبب الرئيس لتلك الحرب تحقيق أهداف قومية عربية؟!
أمّا كردياً، فقد يغيب عن أذهان البعض أن واحدة من أعنف الحروب التي خاضها الكورد كانت حرباً كردية - كردية، مطلع تسعينيات القرن الماضي في إقليم كردستان العراق بين ثلاثة أحزاب ترفع شعارات قومية كردية. (الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني).
ما الذي نريده من كل ما تقدم؟
إن الركيزة الأولى لمواجهة خطاب الكراهية برأيي يجب ألا تقوم على التصدي لخطاب الكراهية بشكل مباشر، وإنما على تفكيك أسلحة خطاب الكراهية، فماذا لو عرف وتيقن من يخوضون الحروب، ويمارسون العنف ويغذونه بسبب شعورهم بالكراهية تجاه الآخر (دينياً، أو قومياً، أو مناطقياً، أو طبقياً) أنهم ضحايا لخديعة كبرى؟ وأن الكراهية، والعنف اللذين يمارسونهما لم ولن يحققا الأهداف التي تم إقناعهم بها؟ فما يظنونه غاية ما هو إلا وسيلة يستخدمها المتحكمون لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية، والمكاسب ستكون حكراً على القلة المتحكمة، أما الكاره والمكروه (فريقان يشكلان معاً أكثرية) فكلاهما ضحية، وكلاهما خاسر مهما كانت نتائج المعركة.
نحن بحاجة إلى إعادة تقييم للجهود التي بُذلت (ولبعض باذلي الجهود) في التصدي لخطاب الكراهية، والعمل على تشكيل «منتخب سوري للتصدي لخطاب الكراهية»، منتخب عابر للطوائف، والأعراق، والأيديولوجيات، والاصطفافات السياسية.
وماذا لو تيقن السوريون المتورطون في خطاب الكراهية من أنهم يمارسون العنف، ويخوضون حروباً أهدافها الحقيقية مختلفة تماماً عما أُقنعوا به؟ وبأن ما يجري ما هو إلّا تصفية حسابات، وتشكيل تحالفات، وهندسة خرائط جيوسياسية جديدة، وصراع على مكاسب اقتصادية، وأن الأمر ليس طارئاً على المنطقة بل هو حلقة جديدة من سلسلة حروب ابتدأت منذ آلاف السنوات على أراضينا، قانون تلك الحروب الذي ما زال معمولاً به حتى الآن: من يسيطر على المنطقة الممتدة من هضبة الأناضول إلى هضبة فارس يتوج بلقب القوة العالمية العظمى.
الركيزة الثانية: العمل على تعريف هوية سورية رئيسية جامعة، وتنظيم علاقات سوية بين الدولة ومواطنيها.
بات من البديهي القول إن السلطات المتعاقبة على سدة الحكم منذ نشوء الدولة السورية فشلت في إيجاد هوية وطنية سورية رئيسية جامعة، لا تُقصي أحداً (هذا إن افترضنا أنها عملت بشكل جدي على ذلك أساساً) ما أدى إلى:
ترك الساحة للهويات الفرعية كي تتصارع بدلاً من أن تتكامل، أي تحول التنوع الديني والقومي من حالة إثراء ومزية تغني الوطن السوري إلى حوامل لخطاب كراهية، وعلاقات غير سوية بين أطياف الشعب السوري، علاقات مبنية على شك، وريبة، وحذر في أحسن الأحوال.
فشل في تنظيم علاقة سوية بين الدولة والمجتمع، وبين المواطن والدولة. فالسلطات بدلاً من التركيز على حل المشكلة من جذورها - أي إيجاد هوية سورية رئيسية جامعة بعيداً عن الإقصاء - انهمكت في العمل على محاولة إخفاء آثار هذا الفشل عبر تشديد القبضة الأمنية، رغم أن كثيراً من السوريين على مختلف مشاربهم يشيدون بحالة الأمن التي كانت تتمتع بها سوريا، لكن الاكتفاء بالقبضة الأمنية فقط أدى إلى نشوء علاقة غير سوية بين المواطن والسلطة، علاقة هي أشبه بمزيج من الخوف من أجهزة السلطة وعدم الثقة بالقوانين، والكثير الكثير من الاتكالية والسلبية وغياب لروح المبادرة، وقد يفسر هذا بعض الظواهر الملحوظة في المجتمع السوري، ومنها: اعتبار التفاف المواطن على القوانين شطارة، وانتشار ثقافة الرشوة «ارشي بتمشي»، و بالتالي يصبح المواطن الثري مستثنى من تطبيق سلطة القانون، وشيوع فكرة التهرب من الضرائب لعدم معرفة المواطنين بأسباب دفع الضريبة، وبكيفية انعكاس أموال الضرائب خيراً على المجتمع، ناهيك بعدم التوازن بين دخل الفرد ومقدار الضرائب والجمارك ، إضافة إلى التهرب من دفع فواتير الكهرباء، والماء، والتلاعب بالعدادات. وحتى في الخدمة العسكرية الإلزامية فأغلب السوريين سمعوا، وقسم منهم طبق مقولة: «عسكرية دبر حالك». كل هذه الأمثلة تفسر سبب عدم شعور كثير من السوريين بأن «المواطن هو ابن الدولة»، وتفسر نوعاً ما سهولة انتشار خطاب الكراهية، فالمواطن تمت برمجته على التنفيذ، ولم تتح له فرصة التعبير عن رأيه، وغالباً حين سيُطلب منه فجأة الاختيار ستكون أولى محاولاته خاطئة، وسيختار الأسهل، وبما أنه «لا شيء أسهل من الكراهية، أما الحب فيحتاج نفساً عظيمة»، كما يُنسب إلى شمس الدين التبريزي، فقد اختار الكثيرون الكراهية!
قيامة
الوضع المأسوي في سوريا لا يجب أن يقود إلى التخلي عن أحلامنا، والاستسلام وجلد الذات، والبكاء على الأطلال، فما يجري في سوريا ليس حدثاً فريداً من نوعه لم تشهده الكرة الأرضية سابقاً. شعوب كثيرة مرت بمراحل قاسية، وربما أقسى من الحالة السورية، بعضها عمل على تحليل ما جرى بصدقية، واستخلص العبر، وصحّح الوجهة، وبعضها ما زال أسير حالة اليأس والانهزامية والاتكالية والتبعية.
أولى الخطوات نحو النجاح تبدأ بحلم، والثانية التمسك به، ثم العمل على ترجمته على أرض الواقع، وأنا لدي حلم لم يفارقني منذ أن قُتِل أول طفل في سوريا:
«أبي الغالي، أمي الحنون: لا تحزنا، فأنا في مكان أفضل مما كنت فيه، ومع صحبة أجمل ممن كنت معهم. تعرفت إلى مجموعة من الأصدقاء، أطفال بعمري سلكوا طريقي ذاته للوصول إلى هنا: محمد، وموسى، وعيسى، علي، وعمر، وكاوا، عائشة، ومريم، وزينب، ونوروز، نلعب في حدائق جميلة، بكرات جديدة، لدينا الكثير من السكاكر، وكل ما تمنينا أن نحصل عليه يوماً. تجمعنا المحبة والسعادة التي فقدت عندكم، لذا لا تضيعوا الوقت في الحزن علينا، ولا تضيعوا الوقت والجهد بالاختلاف على من سيدخل جنة السماء، بل تعاونوا، واعملوا على بناء جنتكم على الأرض.
أمي وأبي الغاليين، أخبرا أقاربكما، وأصدقاءكما، وجيرانكما، وكل معارفكما أننا نحن الصغار لم ولن نعترف بهلوساتكم أنتم الكبار، فكلنا من آدم، وآدم من تراب، ومهووسٌ وموهومٌ من يحاول عبثاً أن يفرز حبات التراب».