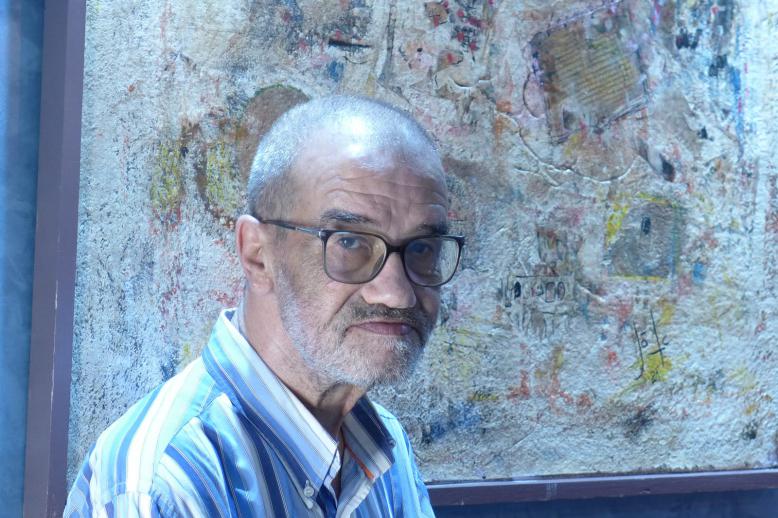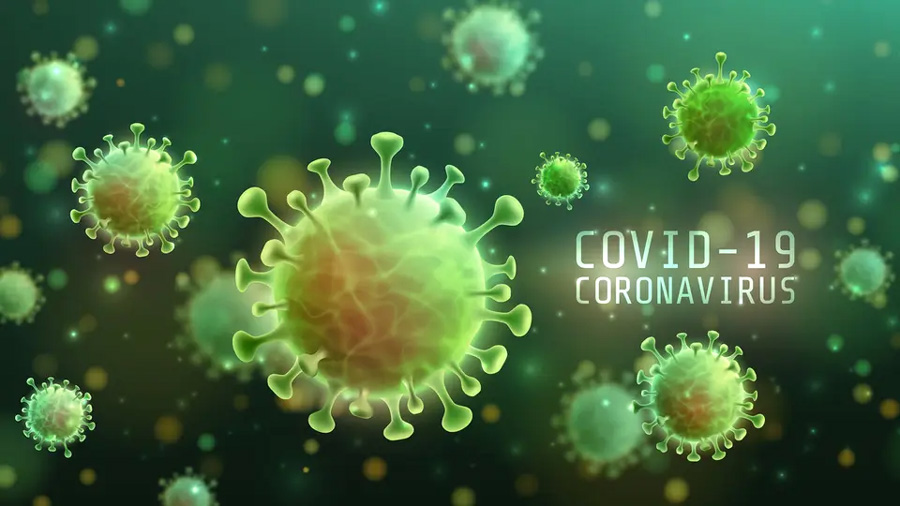كورونا .. صناعة سلاح الخوف
نسهر إلى أن تتجاوز الساعة الثانية عشرة، ثم نهرع لريموت التلفاز؛ لنضغطه على القناة التي تعرض فيلماً ننتظره طوال الأسبوع، "فيلم الرعب". يجد الكثيرون في أفلام الرعب الرغبة الجامحة التي تمنحهم شعوراً بالإثارة يفتقدونه في حياتهم العادية، أو يطمحون لتواجده كجزء منهم؛ لمنحهم نشوة قد حرموا منها. وعند المشاهد القاسية الشديدة الرعب، يشرع المتفرج في تغطية عينيه، ووضع يديه على أذنيه حتى لا يرى ولا يسمع المشهد الذي أزعج كيانه، وجعله يشعر بضعفه من شدة الخوف. وقد يأخذ في تناول الفوشار والمقرمشات التي بحوزته بطريقة هستيرية من شدة الرعب، أو احتضان فرداً بجانبه، أو حتى الوسادة وكأنها درع يحميه من شعور مقيت لديه يذكره مرة أخرى أنه ليس هذا الشجاع كما يدعي، وأن عليه وصول مراتب أعلى من الشجاعة حتى يتغلب على مخاوفه. فيبدأ في استعادة رباطة جأشه، ويشرع في متابعة الفيلم مرة أخرى باهتمام إلى أن ينتهي.
ومع نهاية كل فيلم، يجد أنه لا يزال يشعر بالخوف، فيشاهد فيلما آخر. ويستمر الوضع هكذا إلى أن ينتهي به المطاف إما بالاستسلام بأنه لم يستطع النجاح في تلك الاختبارات المتتالية، فيتوقف عن مشاهدة أفلام الرعب. أو على النقيض، قد يدمن الشعور بالإثارة التي توفرها المشاهد المرعبة، فيدمن على مشاهدة تلك الأفلام لتصنيع هالة من الخوف تجعله يشعر بالشجاعة، لكن في هذه اللحظة يكون قد خسر الشعور بالاستقرار النفسي الطبيعي.
انتشار هذا الوباء عالمياً ربما كان دعوة خفية لضرورة رجوع الإنسان إلى آدميته، ولحضه على عدم البحث عن الاستثارة والشعور بالنشوة بوضع نفسه في فوهة الأشياء التي كانت تسمى قبل ظهور "فيروس الكورونا" بالخطرة
"صناعة الخوف" هي "السلاح" الذي بالرغم من قسوته، يعلم جيداً الأوتار الحساسة الواجب إصابتها في النفس البشرية. فصناعة الخوف وسيلة لاحتواء غضب الشعوب، وكذلك كبت أي محاولة للتمرد والعصيان. وعلى هذا، طورت الدول "سلاح الخوف" بأشكال عديدة شتى؛ لتوجهه إما للشعوب التي تحكمها، أو لدول أخرى ترغب في السيطرة عليها، ورد هجمات عصيانها وغضبها. فصار الخوف صناعة المقصود منها استخدامها كسلاح فتاك يماثل أسلحة الحرب بالأسلحة الثقيلة، والحرب البيولوجية.
"صناعة الخوف" صارت جزءا أصيلا من الحرب النفسية التي سجلت بداياتها مع مستهل الحرب العالمية الأولى، ووصلت أوجها في الحرب العالمية الثانية، ثم دخلت دهاليز فرعية متطورة فيما بعد حتى وصلت مرحلة متقدمة في عصر التكنولوجيات المتطورة الذي نعيش فيه حالياً.
بيد أن الشعوب على الصعيد العالمي صارت مستنيرة، وفطنت خبايا تلك اللعبة، وعلمت أن الخوف صار سلاحاً موجهاً نحوها ليسوقها كقطيع لا رأي له؛ ليتبع أهواء الساسة، وليخدم أغراضا أخرى ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. أضف إلى هذا، إدمان الشعوب على الشعور بالاستثارة من جراء خوض تجارب تجعلها تنهل من فيض الخوف، قد دربها على مواجهة أي أخطار بلامبالاة؛ لمعرفتها أن أي شعور بالخوف زائل. ومن هنا، أدت كثرة صناعة الخوف لحدوث تشوه نفسي عكسي لدى الغالبية العظمى من الشعوب، فجعلت ردة الفعل المتواترة هي "الشعور بالبلادة" و "اللامبالاة"، بدلاً من الشعور الطبيعي بالخوف.
وفيما يبدو أن السحر قد انقلب على الساحر؛ فلقد وضع انتشار "فيروس كورونا" مدى التشوه النفسي لدى الشعوب تحت مجهر. ففي بداية انتشار الفيروس، صار الشعور العالمي المتفشي حياله هو عدم التصديق، على الإطلاق. فأنى لهذا الفيروس الضعيف أن يكون فتاكاً، وهو من السهل القضاء عليه بأبسط المطهرات، وينجلي من على جلد الإنسان بكل سهولة، بواسطة الاغتسال بالماء والصابون فقط، كما يروجون. ومن ثم، لم يصدق العالم جميع النشرات ولا أعداد الوفيات، واعتقدوا أن إشاعة تواجد فيروس الكورونا هو مجرد وسيلة جديدة لصناعة الخوف، التي تخدم أغراضا سياسية أو اقتصادية لدول بعينها. فتم وضع الدول تحت طائلة التحليل، وتأويل النتائج التي تعود على تلك الدول عند إشاعة فوضى وبلبلة عالمية لفيروس ضعيف لا يضاهي الإيبولا Ebola ، أو حتى السارس SARS، اللذين تم اكتشاف المصل المضاد لهما سريعاً بالرغم من قسوتهما، وبالقياس على ذلك كانت إنفلونزا الخنازير، وإنفلونزا الطيور، وقبلهما مرض جنون البقر، وجميعهم سرعان ما اندثروا.
وبناء على ذلك، تشكك العالم قبل أي شيء في نوايا الدول، بل اعتبر المحللون أن الصين هي من خلَّقت ذلك الفيروس لتأميم استثماراتها مع الدول الأجنبية دون الخوض في منازعات سياسية. في حين، خرج العديد من مواطني دول توطن بها المرض يقسمون للعالم، وفي يدهم أدلة إلكترونية على أن الفيروس قد حاز على براءة اختراع منذ عام 2016، ويمكن على رواد الإنترنت التأكد من ذلك من خلال نشر رقم براءة الاختراع، والذي من خلاله يمكن معرفة أسماء من طوّر الفيروس، ومكوناته. بل وأشيع أنه يتم تأجيل الكشف عن المصل المضاد لحين الإنتهاء من تحقيق الغرض السياسي لدول بعينها. ودون أدنى شك، سببت تلك البلبلة العالمية موجة عارمة من عدم تصديق تواجد الفيروس من الأساس. فخرقت الشعوب تعليمات وزارة الصحة، واستخفت بالتحذيرات، واستهانت بتطبيق قواعد الأمن والسلامة.
وفي تلك الأثناء، تنبه بعض العقلاء الذين استفاقوا من التشوّه النفسي أن الوضع العالمي جد خطير، فصارت نوبات الخوف المضادة لديهم إما حذرة أو مبالغا فيها؛ لرؤيتهم موت العديد، وانهيار البورصات العالمية، بل والأدهى، تحول هذا الفيروس الضعيف لجائحة أو وباء عالمي Pandemic يضرب الآلاف كل يوم، ويميت العديد دون تمهيد. والغريب، لا يوجد مصل عالمي موحد له حتى الآن، فهو سهل الانتشار كالنار في الهشيم. ولقد أفضى ذلك، لاستفاقة متفاقمة من التشوه النفسي لدى المتشككين، الذين لم يصدقوا فيما قبل أن الخطر الذي قد يدمر العالم هو مجرد فيروس ضعيف، على عكس ما كان يشاع أن انهيار العالم سوف يكون ناجماً عن حدث جلل كضرب الأرض بنيزك، أو زلزال، أو انهيار جليدي، أو طوفان، أو حتى نزول مخلوقات فضائية، أو تواجد متحولين فيما بيننا.
"فيروس كورونا" نبّه العالم أن الخطر حتى يكون جسيماً، لا يشترط أن يكون قوياً. فأحياناً، الضعف يكون أقوى بمليارات المرات من القوة. فلربما كان انتشار هذا الوباء عالمياً دعوة خفية لضرورة رجوع الإنسان إلى آدميته، ولحضه على عدم البحث عن الاستثارة والشعور بالنشوة بوضع نفسه في فوهة الأشياء التي كانت تسمى قبل ظهور "فيروس الكورونا" بالخطرة. فالشجاعة التامة حالياً، وأقصى شعور بالاستثارة التي تحقق النشوة هو القدرة على تحمل ملازمة المنزل من خلال حجر صحي اختياري، ويتم ذلك بالرجوع للطبيعة الآدمية الضعيفة الهشة، والشعور مرة أخرى بـ "الخوف".