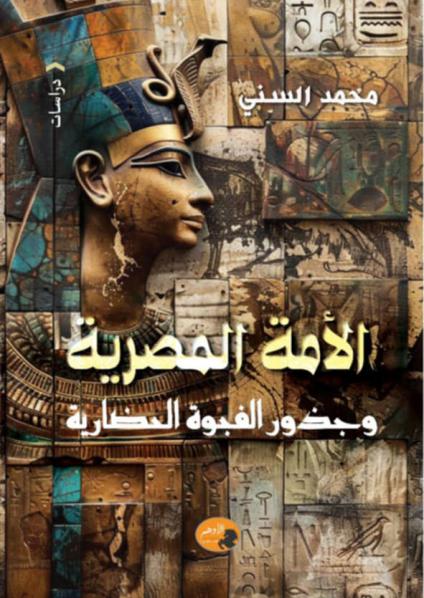محمد السني يقرأ المشروع الحضاري المصري و'جذور الفجوة الحضارية'
تتبدّل خرائط القوة وتتصدّع مفاهيم التاريخ، فيبرز سؤال الهوية الحضارية بوصفه سؤالًا وجوديًا لا مجرد استفسار ثقافي أو سياسي. لماذا تنهض أمم وتُنتج، فيما أخرى تتآكل وتسقط؟ ولماذا تغيب شعوب كانت في قلب الريادة، وتصير أطرافًا هامشية في دورة الحضارة؟ هذه ليست أسئلة تقنية أو اقتصادية بقدر ما هي اختبارات عميقة لمعنى التقدم، ولموقع الإنسان من ذاته وتاريخه وقدرته على الفعل. في قلب هذا السؤال، تتّخذ مصر موقعًا فريدًا. إنها ليست مجرد دولة تبحث عن تنمية، بل حضارة عريقة تتلمّس دربًا للخروج من فجوة مهولة تفصل حاضرها الكسيح عن ماضيها الساطع. لقد كانت مصر، لآلاف السنين، مركزًا لإنتاج المعنى، ومعملًا لتجريب القيم، وموئلًا لنماذج فكرية وأخلاقية وإنسانية أبهرت العالم. غير أن هذا المجد السحيق لم يشفع لها أمام مسارات الانكسار الحديثة، حين أُعيد تشكيل العالم في غفلة من وعيها التاريخي، وانزلقت تدريجيًا إلى مراتب التبعية.
هذه الفجوة الحضارية، التي تتجاوز الفروق في مستوى التكنولوجيا أو الاقتصاد، هي في جوهرها فجوة في الضمير، في الوعي، في المنظومة الأخلاقية التي بها قامت الحضارات ومنها تسقط. وهي فجوة لا تُردم فقط بالمشاريع التنموية أو تحديث المؤسسات، بل بإعادة النظر في البنية العميقة للهوية، وفي ما تراكم من انقطاعات وانفصالات بين الأنا الحضارية ومآلاتها المعاصرة.
ولعل أخطر ما في هذه الفجوة، أنها لم تعد مرئية بما يكفي. لقد ألفنا التراجع حتى صار عاديًا، واعتدنا التبعية حتى بدت قَدرًا. وكأن الأمة المصرية، التي صاغت فجر الضمير الإنساني، دخلت زمنًا رماديًا يُراد له أن يكون أبديًا. من هنا، يصبح السؤال عن الجذور – لا عن النتائج – ضرورة فكرية وأخلاقية، ويغدو التفكير في تجاوز هذه الهوة ليس ترفًا ثقافيًا بل شرطًا للبقاء.
في كتابه المهم "الأمة المصرية وجذور الفجوة الحضارية"، لا يكتفي الباحث محمد السني بتشخيص الفجوة التي تفصل بين مجد مصر القديم وواقعها المتردي، بل يقدّم أطروحة فكرية شاملة تسعى لتفسير هذا الانحدار من موقع الريادة الحضارية إلى موضع التبعية البنيوية. فهو لا يسائل التاريخ كأرشيف مغلق، بل يفتحه ليقرأ فيه ملامح الحاضر، وليضيء مسارات المستقبل، مرتكزًا على ركيزتين أساسيتين: الضمير الأخلاقي كجوهر حضاري أصيل، والتبعية السياسية والاقتصادية كمصدر رئيس لانهيار المكانة الحضارية.
يتخذ السني من التساؤل التاريخي المحيّر مدخلًا: لماذا تفصلنا هذه الهوة الهائلة بين عظمة الماضي وبؤس الحاضر؟ فيرى في مقدمة كتابه أنه "لطالما تعجب المصريون، وغير المصريين، من الفجوة الحضارية الهائلة، بين عظمة حضارة المصريين قديمًا؛ وبؤس حاضرهم. بين (ريادتهم) العالمية المُبَكَّرة منذ قبل التاريخ، وطيلة العصور الفرعونية القديمة، التي شكلت هُوِيَّتهم المتحضرة، والمازجة للحضارات؛ وبين الانحدار، والاضمحلال الحضاري، والتبعية الموضوعية لدول مركز الرأسمالية العالمية، في العصر الحديث. وكذا يتعجبون من الفجوة الحضارية بين فترات (الندية) المصرية للقوى العالمية، إبان العصور الوسطى المصرية؛ وبين مركزها التابع (موضوعيًا) في منظومة الحضارة الحديثة. حيث كانت مصر إبان العصور الوسطى قوة عالمية كبرى، ومركزًا مشعًا من مراكز الحضارة آنذاك، وذلك مع غيرها من مراكز الحضارات الأخرى التي ظهرت على الساحة الدولية، بل إن مصر تفوقت عليهم في كثير من النواحي الحضارية، وخاصة إبان عصور الدول المستقلة الخمس؛ الطولونية، والإخشيدية، والفاطمية، والأيوبية، والمملوكية."
ويضيف"تزداد الدهشة كل يوم، مع كل اكتشاف أثري مصري، أو معرفة أحد جوانب العظمة المصرية القديمة، ومقارنتها بمكانتنا الحالية في خريطة حضارة العصر الحديث. وكذا تزداد الدهشة مع كل اكتشاف أو اختراع علمي حديث، ومع كل تقدم وتطور في إحدى نواحي الحياة المعاصرة المتعددة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والعسكرية، والتكنولوجية، والحقوقية، والأخلاقية، والإنسانية، والكثير غيرها، والتي حدثت وتحدث بمعزل عن مشاركتنا."
وتمتد حيرته إلى ماضي العصور الوسطى حين كانت مصر قوة كبرى "حيث كانت مصر إبان العصور الوسطى قوة عالمية كبرى، ومركزًا مشعًا من مراكز الحضارة آنذاك، بل إن مصر تفوقت عليهم في كثير من النواحي الحضارية، وخاصة إبان عصور الدول المستقلة الخمس؛ الطولونية، والإخشيدية، والفاطمية، والأيوبية، والمملوكية."
يؤسس السني لفكرة محورية مفادها أن الانحدار ليس مجرد نتيجة ظروف خارجية، بل ناتج عن انقطاع تاريخي في الضمير الأخلاقي المتجذر في الحضارة المصرية القديمة، ذلك الضمير الذي صاغه المصريون على مدى آلاف السنين. يقول في وصفه لذلك الإرث "وبذلك استطاع المصريون القدماء تشييد منظومة أخلاقية شاملة تتكئ على فكرة العدالة، هذه المنظومة تعلن بوضوح مخاصمتها للظلم، وانحيازها المُطْلَق للاستقامة... ويؤكد بريستيد في مؤلفه (فجر الضمير)؛ أن ما حفظ حضارة المصريين القدماء هي (الأخلاق)... لذا نحتوا على جدران مقابرهم رمز إلهة العدل (ماعت)، ليتذكروا أن العمل باقٍ معهم."
ويرصد السني بحدة أثر الحكم العثماني الذي وصفه بـ"الاستعمار الكارثي"، إذ يقول "وهكذا؛ فبينما كانت دول أوروبا الغربية، وهم جيراننا على الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط، تنتقل من عصر النهضة العظيم إلى عصر التنوير... كانت مصر تئن تحت براثن الاستعمار العثماني الكارثي، في أبشع فترة اضمحلال وجمود في تاريخها على الإطلاق... فكأن الزمن توقف بالأمة المصرية."
وينقل صورًا مروعة للانحدار الثقافي والتعليمي في ظل العثمانيين، ومنها "وكان الأزهر والكتاتيب النافذة التثقيفية والتعليمية الوحيدة... وانحطت اللغة العربية نتيجة استخدام اللغة التركية كلغة رسمية للبلاد، ولم تنجب مصر طيلة هذا العصر علماءً، أو فلاسفة، أو مفكرين، أو أدباءً، أو شعراءً، حتى بمقاييس العصور الوسطى البالية."
ويضرب مثالًا مأساويًا يرويه المؤرخ شحاتة عيسى عن إشاعة قيام الساعة عام 1735م "شاع الاعتقاد في السحر والخرافات، وراجت أسواق المشعوذين والدجالين. ويحكي شحاتة عيسى إبراهيم في كتابه (القاهرة)، عن إشاعة راجت في أحد الأيام من عام 1735، أن يوم البعث سيكون يوم الجمعة السادس والعشرين من ذي الحجة، وأخذ الناس يودع بعضهم البعض الوداع الأخير، ويهيمون على وجوههم في الحقول والطرقات، وانقضى اليوم ولم تقم الساعة، والناس مازالوا أحياءً يُرْزَقُون، فشاع بينهم مرة أخرى أن السيد أحمد البدوي والسيد الدسوقي والإمام الشافعي تشفعوا للناس عند الله أن يؤجل لهم قيام القيامة، فقبل شفاعتم!!."
ويرى السني أن محمد علي، رغم استبداده، أسس الدولة الحديثة ببصيرة حضارية "فبالرغم من استبداده السياسي وأخطائه العديدة؛ إلا أنه استطاع تحقيق نهضة حضارية غير مسبوقة تقترب من الإعجاز في حجمها ومغزاها، رافقها نهضة ثقافية وفكرية أوجدت المفاهيم والرؤى العصرية المصرية."
ويضيف "لم تكن الحملة الفرنسية على مصر صدامًا بين جيشين... بل كانت مواجهة بين حضارتين، لعصرين متغايرين... ومن هنا كانت نتيجة الصدام حتمية، وكانت الصدمة أكبر من جانب الشعب المصري، الذي عرف الحضارة، والتقدم، والريادة، والقيم الأخلاقية، والمُثُل الإنسانية منذ القدم."
وتظهر الفجوة الحضارية كنتاج لهذا الانقطاع والتخلف، إذ يحدد السني في خمسة أبعاد أساسية: وتمثَّلت (الفجوة الحضارية) بيننا وبين المجتمعات الغربية في عدة مؤشرات.. أولًا مستوى التطور الاقتصادي؛ الناتج عن الثورة الصناعية، والقائم أساسًا على إنتاج وسائل الإنتاج، وتركزها وتمركزها في الغرب، الذي مَكَّنَ دولها من امتلاك قوة اقتصادية جبارة، وسمح بسيطرة وهيمنة شركاتها المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات على الاقتصاد العالمي؛ بينما لا زلنا نراوح في مستوى الإنتاج الحرفي الصغير والمُبَعثَر، وإنتاج وسائل الاستهلاك المعتمدة على تكنولوجيا غربية متقادمة. ثانيًا مستوى تحول العلم ومستحدثاته إلى قوة إنتاج حقيقية في الغرب، والمُعَبّر عنها بالثورة (العلمية - التكنولوجية)، ودخول التكنولوجيا كافة مجالات الحياة، وما أحدثه ويحدثه العلم من صيرورة حضارية، نتيجة التنظيم العلمي للمعارف وإدراكها والاستفادة منها. ثالثًا سيادة مناهج وأنماط التفكير الحديثة في الغرب؛ كالعقلانية، والنقدية، والموضوعية، والعلمانية، والعلمية، والبراغماتية، والإنسانية، والنزوع للحداثة؛ فيما لا زلنا نغط في التفكير السلفي، والأيديولوجي، والديني، واللاهوتية، والميتافيزيقية، والتأملية، والقدرية، والرؤى المنغلقة، والمنهج السجالي المُنْكَفِئ على الذات والتراث التاريخي، والعاجزة عن فهم كنة التطور الحضاري الحاصل في الغرب، واللحاق به.
رابعًا درجة التمدن التي وصلت إليها المجتمعات الغربية؛ نتيجة قدرة الثقافة فيها على إدماج القيم الحضارية البشرية في بنية مفاهيمها وقيمها الخاصة، ودرجة إشباع الحاجات النوعية للمواطن، وضمان العيش في بيئة لائقة، وكذلك قدرة هذه المجتمعات على التنوع، والتناقضات الداخلية، وعلى الحفاظ على مستوى عال من الوحدة الداخلية والترابط والتحديث، القائمة على التواصل وليس الإكراه، والذي رفع من مستوى (الأنا) القومية وتمثلها للحضارة، وسمح بتقارب أمم الغرب. خامسًا مستوى تطور التنظيم السياسي للمجتمع في الغرب، وترسخ المجتمع المدني، والمأسسة الدستورية الديمقراطية، التي تسمح بالتعددية الفكرية، والسياسية، وكفالة الحقوق، وتوسع الحريات، والمشاركة السياسية، وتداول السلطة سلميًا. سادسًا مستوى التقدم الذي وصله الغرب في تثوير واستخدام وسائل الاتصال، والمعلوماتية، والمواصلات، التي عمقت الفجوة بيننا وبينه، وأضافت إليها فجوة رقمية معلوماتية، ومعرفية.
ويوضح "نتيجة لذلك؛ ظلت ولايات الاستعمار العثماني ومنها مصر مجتمعات جمعانية، تربطهم علاقات على أساس روابط الدم، وغلبة النظام الذكوري الأبوي (الباطرياركي)، والتسلط والاستبداد الاجتماعيان بالمعنى الأوسع للعبارة، والإقطاع، والعشائرية، والطائفية، والفكر الغيبي، والافتقار إلى الفهم الدينامي للظواهر السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها. بينما نشأ مبدأ الفردانية في الغرب، وامتد ليشمل التربية، وعلاقة الفرد بالمجتمع، والسلوك الاقتصادي، وأساس بناء الدولة. فقد تأسست الدولة القومية الحديثة على الفردانية، وحرية المبادرة، وروح الابتكار، والمغامرة في الاقتصاد، والتربية على الحرية في السلوك، وإقامة المجتمع السياسي على التعاقد بين إرادات أفراد أحرار، وقد أسهم ذلك في صعوبة الاستيعاب الحضاري للمجتمعات المتخلفة. وبذلك؛ أدت الفجوة الحضارية التي خلقتها العزلة العثمانية لبلادنا عن المجتمعات الغربية؛ إلى خلق (التبعية الموضوعية) للدول الغربية، التي أصبحت تمثَّل دول العالَم الأول، أو دول مركز الرأسمالية العالمية. باعتبار أن الرأسمالية أوجدت مجتمع عالمي متوحد في المصالح الاقتصادية، ومتحد في التوجهات السياسية، ومكتسي بثقافة استغلالية واستعمارية، تعكس طبيعة النظام الرأسمالي القائم على الاستغلال، ولا يعرف سوى لغة القوة.
وفي النهاية، يشرح المؤلف جوهر مفهوم "التبعية الموضوعية" فيقول: أن (التبيعة الموضوعية) هنا تكمن في العلاقة غير المتكافئة بين قوة اقتصادية كبيرة، وذات نظام سياسي حديث وقوي، وشعب متحضر ومتقدم ومنتج؛ وبين قوة ضعيفة وذات نظام سياسي واجتماعي هش ومتخلف، ولا تنتج ما تحتاجه، وشعب منهك ومُنتّهَك الحقوق والحريات، ولا يشارك في صنع قرار وطنه. تلك العلاقة غير المتكافئة هي (التبعية الموضوعية)؛ وليست كما كان في السابق من خلال الاحتلال أو الهيمنة العسكرية. ليصبح تجاوزنا (للفجوة الحضارية)؛ المهمة التاريخية الملحة، والعاجلة، والمصيرية، للخروج من تلك التبعية الموضوعية، واللحاق بقطار العصر الحديث، والتخلص من هذا الاضمحلال الحضاري، وتحقيق نهضتنا الشاملة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والفكرية. والذي يبدأ دائما باكتشاف ذاتنا، والتعرف على هُويتنا الحقيقية، وليست المزورة أو الدخيلة علينا. بحيث لم يعد من الممكن النهوض بدون إعادة إحياء تراثنا وثقافتنا العريقة منذ قبل التاريخ، ووضعه في مكانه الصحيح، باعتباره الأساس في هُوِيَّة وثقافة الأمة المصرية، دون إنكار أو رفض أيًا من روافد القومية المصرية؛ الفرعونية، والإغريقية، والرومانية، والقبطية، والعربية، أو غيرها من مكونات القومية المصرية مهما صغر شأنها.