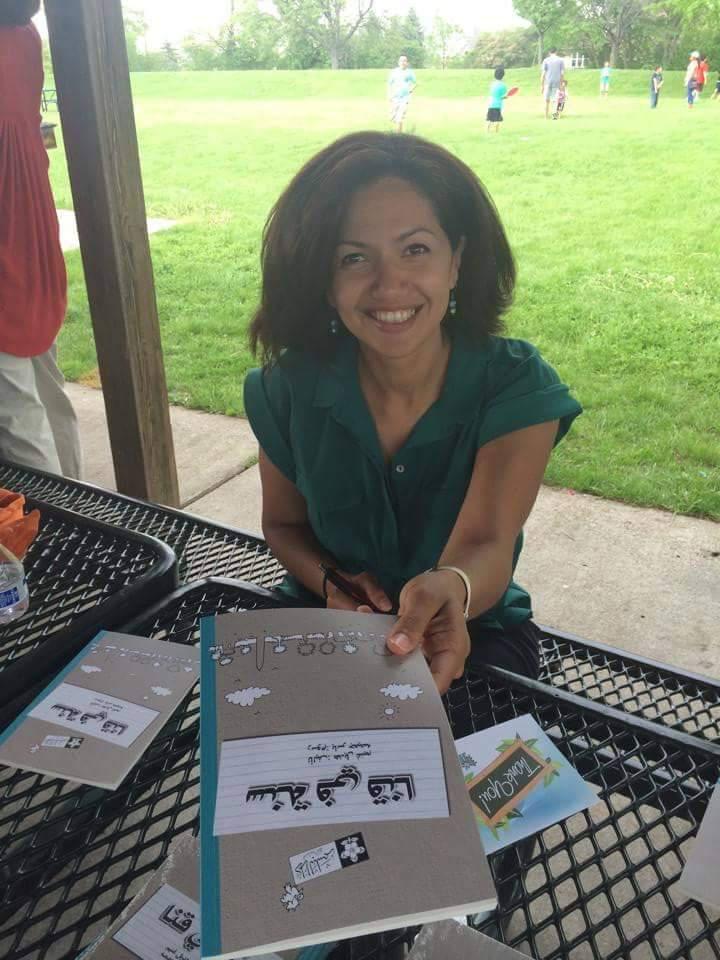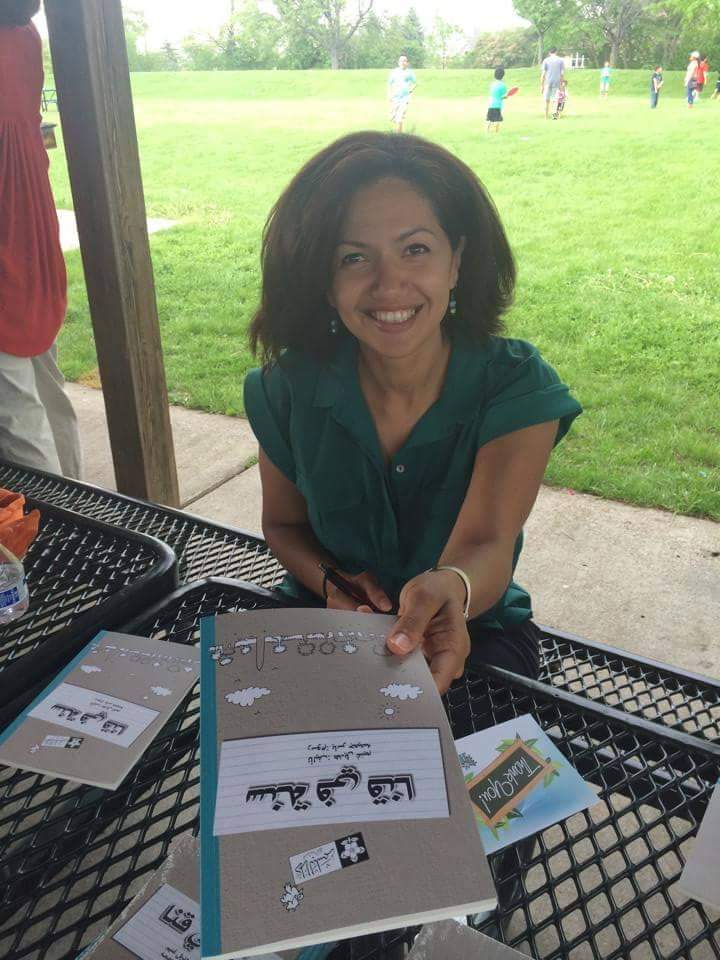هديل غنيم تطرح المشاكل وتترك لجيل المستقبل حلها في 'سنة في قنا'
كاتبة جريئة، كلماتها رشيقة، تكتب بحرية، تطرح المشكلة دون محاولة وضع الحلول لها، فهي تعتمد أن كتابتها الواعية لابد وأن تكون لقاريء واعي، ولأن الأطفال هم المستقبل، فإن معرفته في سن صغير بها وشعوره بالانزعاج منها، قد تجعله يشعر أنها قضيته، ولعل المستقبل على يديه يحمل هو الحلول لما طرحت.
وأنا أقصد الكاتبة المبدعة هديل غنيم، وتحديدا روايتها لليافعين "سنة في قنا"، وليست هذه هي المرة الأولى التي أقرأ لهديل غنيم أو أكتب عن كتابتها الرشيقة، فقد سبق وكتبت عن "ليالي شهرزيزي"، حيث دمجت حكايات التراث بالواقع وحكتها بشكل عصري وقامت بعمل تنقيح له، وكانت حكاية داخل حكاية داخل حكاية بشكل مبتكر استحقت عنها جائزة اتصالات 2020.
أما "سنة في قنا" والتي تدور في 56 صفحة، وصدرت عن دار البلسم، ووصلت القائمة النهائية لجائزة اتصالات لكتاب الطفل 2014، والرواية عبارة عن "دفتر فضفضة" يكتب فيه بطل الرواية شهريا أهم الأحداث التي ستمر عليه خلال عام في قنا، بعد أن اضطر وهو من سكان القاهرة للسفر هناك مع أمه وأخته لرعاية جدته المريضة حتى تتحسن صحتها، وكان هذا الدفتر بمثابة صديق يفضفض له ويحكي ما في هذه الرحلة من صعاب متوقعة، ولعل اختيار هديل أن تكتب الرواية على هيئة مذكرات شهرية، هو توثيقها القيم والبسط لشهور السنة القبطية المربوطة بالزراعة منذ مصر القديمة، والتي سجلت في كل شهر ميلادي وما يقابله من شهر قبطي أشهر الكلمات المتوارثة من الجدات، ولعل من أشهرها "طوبة يخلي الشابة كركوبة" كناية عن شدة البرد فيه، "توت يقول للحر موت"، وتوت يعود للإله تحوت إله الحساب والعلم والفلك عند قدماء المصريين، "إن صح زرع بابه يغلب النهابة"، "إن خاب زرع بابه ما يدي ولا لبابة" ليتلعثم الفتى وحده قصد جدته من المثلين وهو (إذا لعبت مباراة جيدة في أول السنة سأنجح في إبعاد الأذى عني، لكن إن خسرت أو ضعفت من أولها.. لن يتبقى مني ولا قطعة). وهكذا على مدار ال 12 شهر التي قضاها البطل في بلد جدته بقنا.
وجعلت هديل ما يردده بعض المتشددين من أننا كمسلمين لا يجب أن تكون لنا علاقة بالشهور القبطية، تذكره دينا أخت البطل الصغيرة، ليصفها هو بالساذجة، وكأن هديل نفسها ترد على ما يردده هؤلاء بأنه كلام ساذج، فنحن جميعا مصريين، والتقويم القبطي هو التقويم المصري، وتوارثناها عبر آلاف السنين، وبالفعل سمعت تلك الأمثال من جدتي وأنا صغيرة، وكانت دائما ما تسألني "احنا في شهر إيه قبطي؟" وحين أخبرها تذكر لي المثل الخاص به، وجدتي لأمي كانت تعيش معي بالإسكندرية.
وهذه الرواية هي بالفعل رواية جريئة للغاية، فقد طرحت قضايا في منتهى الحساسية، مثل تطور العلاقة بين المسيحين والمسلمين في الآونة الأخيرة في الصعيد، والتي أشارت لها هدير في لمحة بسيطة عن عدم قدرة البطل الذهاب لمولد عيد العذراء أو الليلة الكبيرة في أسيوط، والذي كان يوافق اليوم الثالث من أيام العيد إلا أن خاله رفض ذلك، وطلبت منه أمه أن ينتظر للعام التالي لأنها لا تريد مشكلات قبل سفرهم إلى القاهرة، وحين سأل البطل جدته رقية عن السبب، قالت إنها كانت زمان تزور الأديرة والكنائس المنتشرة في قنا ولكنها توقفت ولا تتذكر لماذا.
وعما يدور في الموالد، فهناك رياضات التحطيب والفروسية التي يمارسها الرجال في المناسبات والموالد، هذه الرياضات ليست تنافسية، بل لعب بروح جميلة، تجعل الجميع سعيدا بالمشاركة في الحدث، ولا تثير أي حساسيات أو تقسم الناس لفرق، كل فريق له من يشجعه فينقسم الناس فيما بينهم، بل الهدف هو المتعة والسعادة ونشر الروح الجميلة.
أما عن المساواة بين الولد والبنت فكانت شديدة الذكاء في طرح تلك القضية، من خلال بقرة خاله التي ولدت ذكرا سموه أبو سريع، ولكن خاله لم يكن فرحا لأنهم يفضلون الإناث عن الذكور لأنها تعني الخيرات كلها من اللبن والسمن والزبد والجبن وضمان لولادة مزيد من الأبناء، ليسبب ذلك دهشة البطل حين يقارن موقف خاله هذا من موقفه حين ولادة ابنته، لأنه كان يتمنى ولدا، حتى أن البطل يقول في استغراب "تعجبت في سري من تناقض خالي ومعاندته للطبيعة أحيانا واستسلامه لها أحيانا أخرى".
ولعل الطبقية والقبلية والعصبية من الأمور الشديدة في الصعيد، وفي إشارة لكبريات العائلات في الصعيد ومنها الهوارة والأشراف، ولأصول العائلات ومن كانوا في الماضي خدما ومن كانوا الأسياد، وكيف أن بعض المهن لا تحظى بالاحترام مثل مهنة الحلاق ليقوم البطل الذي يعرف قيمة العمل الشريف بالإشارة إلى "عمو كريم" الأنيق الذي يحلق له في القاهرة ويعطيه عصير الليمون ويحدثه في السياسة كأنه رجل كبير، فالبطل يناديه عمو احتراما له، والرجل رغم بساطة مهنته إلا أن مثقف وعامل الفتى بشكل تربوي جميل فيه احترام لعقله، فالاحترام هنا متبادل من البطل للرجل صاحب المهنة الشريفة ومن الرجل للفتى صاحب العقل الواعي والخلق النبيل، وفي الصعيد تمتنع بعض العائلات عن زواج بناتها من خارج القبيلة، هذا الأمر الذي يسبب ألما كبيرا للمحب ولكنه لا يستطيع أن يخالف التقاليد فينكسر قلب الحبيبين.
ولأن الفتى في مرحلة المراهقة، فإن الحب جزء أساي في تلك المرحلة، لم تسخر الأم من تلك المشاعر أو تتجاهلها، ولكن في لمحة بسيطة وراقية، أشارت لابنها أنها تعرف أنه معجب بفتاة ولذلك يحاول أن يتعرف على اهتماماتها، فالفتاة مهتمة بالأدب وخاصة أدباء الصعيد، فتساعده الأم في سرد عدد من أهم أدباء الصعيد وإهدائه كتابا ل "طه حسين"، ولم تعلق الأم أو تدفع ابنها دفعا ليحكي لها عن مشاعره، وكأنها تقول له: "أنا أمك أقرأك جيدا، أنا هنا أن أردت أن تحكي أو تستشير، أنا أحترم مشاعرك، أنا أدعمك".
أما الموت والذي يعني هنا أن جيلا يسلم لجيل، وتستمر الحياة، وهنا أدركت مدى نضج قلم هديل غنيم وفلسفتها العميقة والبسيطة في نفس الوقت، فقد توقفت الأم عند الموز الأخضر الجميل المزروع على ضفة النيل، وحاولت أن تشرح لابنها كيف يجدد نبات الموز نفسه باستمرار، ولكنها كانت تسرح وهي تكلمه، وتبذل جهدا كبيرا لإخراج الكلمات، "قالت أن النبتة الأم بمجرد أن تخرج ثمارها تبدأ في الذبول والموت ولكنها تكون قد أنبتت حولها عددا من الفسائل أو الخلفات، كل خلفة تكبر هي الأخرى وتثمر موزا جديدا في نفس المكان"، ليفهم الفتى المغزى والذي جعل عيني أمه تدمع وهي تحاول أن تسرع في مشيتها.
وبالفعل أثارت رواية "سنة في قنا" لدي بعض ذكرياتي البسيطة والقليلة عن الصعيد، فقد زرتها مرات قليلة، ولعل بعض ما يعلق في ذاكرتي من مواقف، أنهم بالفعل كما أشارت هديل لم يفرضوا علي زيهم، وتركوا لي الحرية التامة في إرتداء ما يناسبني وما أتيت به معي من محافظتي، كنت أسير دون ارتداء حجاب، وكان هذا الأمر حقيقة مثيرا للدهشة بالنسبة لي، والحقيقة أنه لم يتعرض لي شخص واحد بالنقد أو الاستياء، بل حين فكرت أن أحترم أنا عرفهم وأرتدي مثل ملابسهم ولو من باب التغيير، رفضوا هم ذلك، وهناك موقف آخر لا أنساه لجدتي لوالدي الصعيدية الحازمة قوية الشخصية، حيث كانت تربي كلبا في البيت، وحين رآني هذا الكلب زمجر ونبح بصوت عال أخافني، فنهرته وقالت له: "اصمت هذه صاحبة البيت" فسكت وخفض رأسه احتراما لما قالت، ولم يرفع صوته مرة أخرى، ولو أردت أن أشير لجزء من الثقافة التي عايشتها هناك، فموقف ابنة عمي حين أخذتني مع مجموعة من الفتيات ولا أذكر إن كان معنا وقتها فتيان، لنغني للقمر لأنه مخنوق حتى تنفرج خنقته، وأذكر أنني لم أقتنع بما قالت وانزعجت من ذلك وحاولت أن تشرح لي وتثبت لي وجهة نظرها، وحين فكرت في الأمر، قررت أن أحترم ما يقولون رغم عدم قناعتي به، كما يحترمون هم اختلافي عنهم.
واختلاف اللهجة كان مثار الكثير من المواقف الكوميدية والتي ربما أشعرتهم في المرات المحدودة التي زرت فيها الصعيد، وعلى فترات متباعدة، وفي مراحل مختلفة من عمري، فمثلا قالت لي ذات مرة ابنة عمي وكنا صغارا، "دسي دي منهم" فوقفت مذبهلة لا أعرف ما لاذي علي فعله، وهي لم تعرف لماذا لم أنفذ ما قالت، فهي لعبة تريدني أن أشترك فيها، حتى فهمت ما تريد بعد شرح للمعنى، إذن دسيها بمعنى خبيها، وهل ستأكلين كحروتة، أو تعالي معي نجمع الكحروت، أي البيض، وكأن تلك اللهجة هي الأقرب للغة قدماء المصريين عن لهجتنا نحن في المدن الكبرى.
وفي الختام فليس مهما اسم البطل، فالبطل هو كل فتى مصري، ذكي، يفكر، يحاول الوصول لحلول للمشكلات، لا يقبل الأمر الواقع الذي يتعارض مع الإنسانية، يحاول أن يصنع تغييرا حقيقيا، يحب برومانسية وبراءة، يحلل ليفهم، يحترم الاختلاف، لديه حلم بجزيرة يحقق فيها تصور جميل للمستقبل الذي يريده ويخطط له ليجعله حقيقة يوما ما.