محمد حسن عبدالله في عزلته الاختيارية
يملك الناقد الأدبي د. محمد حسن عبدالله - وهو يجتاز العام الخامس والثمانين من عمره - ذهنًا متقدًا لشاب في الثلاثينيات، يقرأ المشهد الثقافي الحالي ويحلله، كمراقب يعمل أدواته النقدية في تحليل الظاهرة الأدبية، ولكن من بعيد، ربما لأنه آلف عزلته الاختيارية بضاحية المعادي البعيدة عن وسط القاهرة، أو ربما لاستشعاره ما يعانيه ذلك المشهد من أزمة، يصفها بأنها أزمة أخلاق، لكن ذلك لا يعني أنه يجلس في "صومعته" كناسك اعتزل الحياة الثقافية، حيث لا يزال رغم كل هذه السنوات محافظًا على عقد صالونه الأدبي الشهري في مكتبه الذي يحتل الطابق الأرضي من منزله بالمعادي.
وفي حوارنا معه، يفتح صاحب "جماليات الحضور الفرعوني" في أدب نجيب محفوظ، خزينة ذكرياته، ويعلق كذلك على المشهد الأدبي الراهين، ينتصر لبعضه وينتقد بعضه الآخر، بموضوعية، ودون مغالاة.
في بداية حديثنا معه عن كتابه "الواقعية في الرواية العربية" لكونه رائداً في الدراسات النقدية العربية، وقد صدر في أوائل سبعينيات القرن الماضي أشار إلى ما ينقص الواقعية في الإبداع الروائي العربي؟ وكيف يمكن تجاوز الجانب الأيديولوجي المذهبي في منهج الواقعية في الإبداع الأدبي مؤكداً أن بحث "الواقعية" هو أطروحة الدكتوراه، وكان الاختيار قائما على أن الواقعية – في جوهرها – أسلوب يستوعب كافة الأساليب، ومع مضي الزمن عرفنا الواقعية النقدية (الأوروبية) ثم الواقعية الاشتراكية، ونعيش حالياً زمن الواقعية السحرية، وهكذا يمكن أن تستوعب الرؤية كافة الاجتهادات، فمن قبل كانت هناك الواقعية الرومانسية، ولعلنا نصل إلى الواقعية الرمزية ... لماذا لا؟! ولماذا نظل ننتظر نزول الوحي في الغرب مرة، وفي أميركا الجنوبية مرة، ونحن – العرب – أصلاء في التعبير عن كافة مستويات الحالات الإنسانية . هكذا يقول تراثنا الشعري والحكائي، الذي يتجاوز الشائع من المقامات والنوادر، إلى "الفرج بعد الشدة"، و"مصارع العشاق"، ومن قبلهما كتاب "البخلاء"، هذه مسالك فريدة في طاقتها الإبداعية، ولكن من المؤسف أن قطاع/ قطيع /قطيعة الثقافة العربية لا تريد أن تمد بصرها في غير الاتجاه الذي أدمنته .
وعند سؤاله هل الرواية العربية تستجيب للواقع السياسي والاجتماعي في العالم العربي، أكد بالطبع، فهي لا تملك إلا أن تستجيب، فتكوين الخبرة الإنسانية المتوارثة لا يذهب بعيدا عن هذين العنصرين: السياسة والمجتمع، غير أن الاستجابة قد تأخذ طابعا سلبياً، مثلما فعل أصحاب "المدن الفاضلة" فقد لجأوا إلى تأسيس هذه المدن المتخيلة، رفضا للواقع الذي يعيشونه، وتطلعاً إلى واقع بديل .
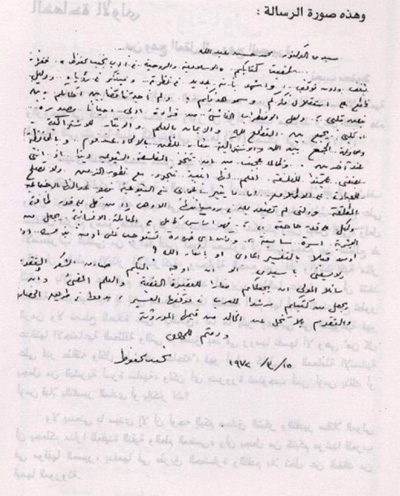
وعن أثر جيل الستينيات (جيله) على الرواية العربية وهل استطاع هذا الجيل أن ينقل الرواية من الاتجاه الواقعي التقليدي إلى نموذج مختلف يطور تقنية السرد، أكد أن جيل الستينيات، أو جيلي، هو الذي طوَّر فن الرواية العربية، وأسس لها مكاناً بين الآداب العالمية، ما بين حنا مينه في سوريا، وعبدالرحمن مجيد الربيعي في العراق، والطيب صالح في السودان، هؤلاء البناة العظام للواقعية في توجهاتهم التي تبدو للعين المتسرعة مختلفة في جوهرها، غير أنها تنبعث من مشكاة واحدة .
وعند التطرق إلى كتابه "الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ" وكون أدبه متأثرا بالقيم الإسلامية والثقافة الإسلامية، وتوضيح إذا ما كان نجيب محفوظ كاتبا إسلاميا رغم أنه لم يكتب بشكل مباشر عن الإسلام مثل عبقريات العقاد أو روايات جورجي زيدان أو كتابات مصطفى محمود، أوضح الناقد د. محمد حسن عبدالله أن ما كتبه نجيب محفوظ من روايات، وقصص قصيرة، يختلف تماما عن كل من ذكرت، ولم أقل إنه كاتب إسلامي (بالمعنى الشائع لهذا المصطلح)، ولكنه كاتب ينظر إلى شخصياته، وإلى الأحداث في ذاتها نظرة فلسفية عميقة، ويطرح من خلالهما رؤى كونية، وسلوكية راقية، وأحيانا مثالية، وفي كل الأحوال يرتقي تصويره لشخصياته، وتعليله للأحداث عن المألوف الذي (يتمحك) في الواقعية ليسقط في هوة الغواية، والإغواء. نجيب محفوظ لم يفعل هذا على الإطلاق .
وعند سؤاله لماذا لم يحصل أي كاتب عربي على نوبل منذ أن حصل عليها نجيب محفوظ قبل ربع قرن أوضح من المؤكد أن لدينا في مصر، وفي النتاج العربي الفكري والفني العام ما يرقى إلى مستوى المنافسة على جائزة نوبل، ومن المؤسف أنها تخلفت عن مفكر إنساني في حجم طه حسين، ومبدع نادر الأداء مثل يحيى حقي، وغيرهما. وفي ظني أن هناك انحيازاً/ تسييساً للجائزة، ساعدناه بموقفنا السلبي من كبار مبدعينا، فلم نعمل على ترجمة أعمالهم إلى اللغات العالمية المقروءة، والتعريف بهم في الدوريات المهمة .
وعند سؤاله لديك العديد من الكتب عن المسرح منها "الحكيم وحوار المرايا". وكيف يمكن سد فراغ الكتابة المسرحية بعد جيل توفيق الحكيم، أكد أن المسرح يزدهر بتأثير عاملين – إلى جانب توارث الحرفة، والعمل على رقيها. المسرح يحتاج إلى مجتمع متسامح، يتسع صدره لتقبل الانتقاد، ومواجهة النقص ولا ترفع فيه الدعاوى من النقابات لمجرد تصوير أحد منتسبيها في عمل لا ترضى عنه تلك الفئة. ويزدهر حين تعترف السلطة الحاكمة – ولو بالإحراج – بحق الاختلاف، وحق الاجتهاد، فظهور مسرح يوسف إدريس، وسعد الدين وهبة، وألفريد فرج، ونعمان عاشور، وغيرهم .. لم يكن مصادفة، وإنما كان ترتيبا على تحقق ما سبق ذكره من عوامل الإنعاش .
وشرح قضية أزمة المسرح أزمة نصوص أم تمويل مؤكداً أن كل الأزمات في وطننا العربي (دون الشعور بالتردد أمام التعميم بكل) مصدرها: الإدارة البيروقراطية التي يجسدها (الكاتب جالس القرفصاء) فهو لا يبحث ولا يتحرك، بقدر ما يكبح ويشكك، أو يفضل الجاهز المتفق عليه. ثم حالة التحاسد والتنافس غير النزيه (غير الفني) بين الكتاب أنفسهم .
وتحدث عن العلاقة بين الناقد العربي والهوية وهل النقد العربي مجرد ناقل للنظريات النقدية الغربية أم مشارك في حركتها عن طريق التمثل والاستيعاب، أوضح عبدالله أن الناقد العربي لا يملك إلا أن يكون عربيا، حتى وإن استهوته (برنيطة الخواجة) فراح (يرطن) بما لم يبدع، لعله يتصدر (الزفة) وجهد الناقد العربي إلى الآن ينحصر في محاولة التطبيق، والتوفيق. فإذا وجد من يحاول إضافة لمسته الخاصة، واجه من الاستهانة بمحاولته ما يحمله على التراجع عنها .
ونوه أن كتابه "الحب في التراث العربي" ليس أبطال قصص الحب فيه شعراء فقط، ففيهم من الفقهاء والعلماء والأمراء من هم أصحاب تجارب ومواقف، وكتاب "الحب في التراب العربي" يؤكد هذا، كما يؤكده كتاب "مصارع العشاق" وغيره .
أما كتاب "طوق الحمامة" فقد قال ابن حزم في مقدمته: إنه لن يهتم بعشاق البادية من العرب وأشباههم (فزمانهم غير زماننا)، وبذلك أخلص كتابه لتجربته الذاتية، ولملاحظاته على سلوكيات مجتمعه، وهذا نموذج يستحق التقدير، ويستحق أن نلتزم به. فزمانهم غير زماننا !
وأكد أن العلاقة بين الرواية والقصة القصيرة، والعلاقة الجدلية بين النقد والإبداع، لأن شيخنا الراحل غنيمي هلال في درسه النقدي يرى أن المبدع هو أول ناقد لعمله، وأرى أن القدرة على الإبداع تعتمد على اتجاه الموهبة، ودعمها بالإطلاع الدائب في اتجاه محدد، فإذا تعددت الاتجاهات ووسعتها طاقة المبدع المعرفية والفنية، فإنه لن يشعر بتصادم الفنون، وإنما ستتولد التجربة في وجدانه مشكلة بالإطار الذي يناسبها: رواية أو مسرحية أو قصة قصيرة، دون شعور بالتناقض .
يرى د. جابر عصفور أننا في زمن الرواية، ويرى د. محمد عبدالمطلب أننا في زمن الشعر، بينما رأى الراحل د. عبدالقادر القط أننا في زمن الدراما. وهنا يؤكد د. محمد حسن عبدالله أن الإجابة عن هذا الموضوع يرد عليه قول الشاعر القديم :
وكل يدعي وصلا بليلى ** وليلى لا تقر له بذاكا
ونحمد الله أنه ليس للأدباء المبدعين نقيب، ولا للنقيب الذي يدعي ذلك (جندورمة) فالمسألة إذن وجهة نظر، أو اجتهاد لا يصادر، ولا يصادم، ولا يملك أن يحول المسار. وفيما أتصور أن دوافع الإبداع أبعد مدى من أن توجه أو يقترح عليها، فإنما هي حاجات وتطلعات، وقدرات معرفية تظل تتأرجح، مثل الزورق الذي يتغير مساره ما بين الجزر والمد .









