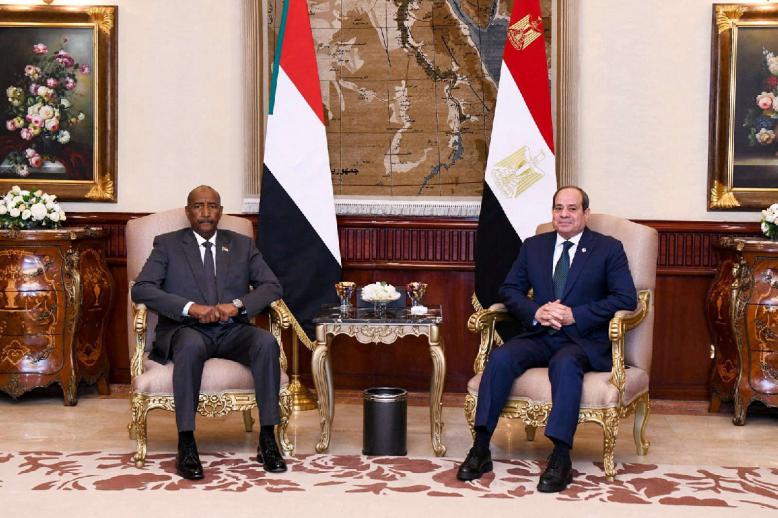العلاقة مع تركيا.. أهم دوافع "هيئة تحرير الشام" لتصفية الفصائل
لم يكن وصف أحد مسؤولي "هيئة تحرير الشام" العلاقة بين تنظيمه والحكومة التركية بأنها "تحالف" زلة لسان ولا عثرة قلم كما صورها الكثيرون. فمشهد الأحداث في إدلب يوحي بتنامي علاقة خاصة بين الطرفين، عمادها الاعتماد المتبادل في تأمين المصالح، مع تنافر يدعيه الطرفان في الاتجاهات العقدية والسياسية.
فمنذ أن نجحت "هيئة تحرير الشام" في تحييد أقرب حلفاء تركيا من الفصائل العاملة في إدلب، حل هذا الفصيل مكانها في سلم العلاقات الذي أنشأته المخابرات التركية منذ اندلاع الصراع في سوريا لتحدد من خلاله شكل ومدى العلاقات مع الفصائل العاملة في الداخل، لتصبح "الهيئة" اليوم هي القائم على تحقيق المصالح التركية في إدلب والمناطق المحيطة بها، وتنال مقابل ذلك الكثير من الميزات التي كانت في السابق حكرا على الفصائل الأخرى التي تحاربها اليوم.
كان الهجوم مستمرا من قبل "جبهة النصرة" وهو الاسم الأصلي لفصيل "هيئة تحرير الشام" على فصائل أخرى مثل "أحرار الشام" و"نور الدين زنكي" و"فيلق الشام" بسبب علاقتها القوية مع الحكومة التركية، واللقاءات المستمرة بين قيادات تلك الفصائل والمخابرات التركية، وكان سبب الهجوم المعلن هو كون الحكومة التركية علمانية التوجه، تتبنى الديموقراطية، وتحافظ على انتماء تركيا إلى حلف الناتو، وتشارك في عملياته في أفغانستان، وتقدم الدعم للحكومتين العراقية والصومالية. ولكن الأحداث الحالية بينت -بما لا يدع مجالا للشك- أن السبب الأساسي لانتقاد تلك العلاقة كان الحسد ورغبة قيادة "جبهة النصرة" بالاستئثار بالميزات الكبيرة التي تؤمنها العلاقة مع الحكومة التركية، والسعي لحرمان الفصائل المنافسة من تلك الميزات، الأمر الذي سيعطي لقيادة "الجبهة" اليد العليا في مستقبل الأيام.
وبناء على هذا الأساس حكم كثير من المتابعين بأن هدف الهجوم الذي شنته "هيئة تحرير الشام" على الفصائل قبيل نشر نقاط المراقبة التركية في محيط مناطق سيطرة المعارضة كان بخلاف ما أعلنته "الهيئة" من رغبتها في تخريب "اتفاق سوتشي" الذي وقعته الحكومة التركية بالنيابة عن الفصائل لتحييد منطقة إدلب والأرياف المحيطة بها عن الصراع مع جيش النظام الحاكم لسوريا بزعم أن هذا الاتفاق ما هو إلا خيانة للثورة ومقدمة لتسليم جديد للمناطق كما حدث في مناطق خفض التصعيد الأخرى في درعا ودمشق وحمص، وكان رأي أولئك المتابعين –والذي أثبتته أحداث الشهور اللاحقة- أن قيادة "الهيئة" منزعجة من تهميشهم من قبل الحكومة التركية في الاتفاق، وبالتالي كان تحركها ضده محاولة للضغط عليها لإعطائهم المكانة التي يطلبون بناء على حسابات القوى بين الفصائل على الأرض.
وهذا المطلب استوعبته المخابرات التركية بشكل جيد، فلم تدخل في صراع مع "الهيئة" لإلزامها بالخضوع لما وقعت عليه كما كان يأمل حلفاؤها من الفصائل، بل وجدت في هذا الأمر فرصة ذهبية لإدخال هذا الفصيل في دائرة نفوذها المباشر، لا عن طريق الترهيب، ولكن عن طريق الترغيب بفتح مجالات للعمل وتأمين موارد سيفكر قادة "الهيئة" كثيرا قبل التفكير في خسارتها بإغضابهم للحكومة التركية.
وهكذا بدأت "هيئة تحرير الشام" بتنفيذ مقررات "اتفاق سوتشي" بكاملها بعد أن كانت تتهم الفصائل المنافسة لها بالخيانة والعمالة بسبب رضاهم بها لكونها أفضل الممكن بحسب رأيهم، وبدأت أرتال الجيش التركي الذي كان يوصف سابقا في خطابات قادة "الهيئة" ومسؤوليها الشرعيين بأنه "عميل للصليبيين" تجوب مناطق سيطرتها، وتنصب القواعد العسكرية ونقاط المراقبة على أطرافها، بحماية وحراسة مقاتليها الذين كان بعضهم يعلن سابقا أنه سيتوجه لقتال الحكومة التركية بعد انتهاءه من قتال نظام بشار الأسد، بسبب حكمها بالقوانين العلمانية ومساعدتها أميركا في قتال حركة طالبان في أفغانستان.
وأما الرافضون لهذا التقارب مع الحكومة التركية، المطالبون بإزالة نقاط المراقبة ونقض كل بنود اتفاق سوتشي فالظاهر أن "هيئة تحرير الشام" بدأت منذ زمن بعزلهم وتهميشهم داخلها ما دفع الكثيرين منهم إلى الانشقاق عنها والانتقال إلى فصيل "حراس الدين" الذي يعلن ولاءه لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الأمر الذي لم يثر –كما يبدو- غضب قيادتهم، لرغبتها في التخلص منهم لتجنب أي معارضة داخلية لقراراتها والتي يبدو أنها ستأخذ منحى أكثر انعطافا عما كانت تعلنه قبل سنوات، طمعا في تحصيل المزيد من المكاسب، وطلبا للحفاظ على ما ترى فيه حجما كبيرا من المكتسبات، وخاصة ما يتعلق بالحكومة التي أنشأتها "هيئة تحرير الشام" لتجعلها واجهة لنشاطاتها غير العسكرية، وأطلقت عليها مسمى "حكومة الإنقاذ" راغبة في جعلها مستقبلا الممثل الوحيد للقوى المعارضة لنظام بشار الأسد، خاصة في ظل ضعف ما يسمى "الحكومة الانتقالية" التي أنشأها "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة" وعجزها عن تسيير مهامها أو فرض هيبتها في مناطق تواجد مقراتها في حلب وإدلب، واقتصارها على الوساطة في تقديم بعض الخدمات الممولة من قبل المنظمات الإنسانية والدولية.
أما بالنسبة للحكومة التركية فالظاهر أن هذه العلاقة التي لا يمكن إخفاؤها لا تشكل حرجا داخليا أو خارجيا لها، بل إنها تحقق لها الكثير من المكاسب على هذه الأصعدة، ليس أقلها إثباتها قدرتها على تحقيق ما وعدت بإنفاذه في "سوتشي" من ضبط لوقف إطلاق النار بشكل كامل من جهة مناطق سيطرة المعارضة، وهو ما كان يشكك فيه الكثيرون، وكذلك إمكانية ادعاءها القدرة على ترويض فصيل لا يزال مصنفا على قوائم الإرهاب الدولية، وكان حتى فترة قريبة جزءا من تنظيم القاعدة، وربما التقارب بينها وبين "هيئة تحرير الشام" جاريا بالتشاور مع حلفاء الحكومة التركية، في مشهد شبيه بالعلاقة المرضي عنها أميركيا بين الحكومة القطرية وحركة طالبان الأفغانية والتي ساهمت كثيرا في تغيير وجهة نظر الحركة تجاه التفاوض مع الأميركيين.
هذه العلاقة المبنية على المصالح المتبادلة بين الطرفين من شأنها أن تنمو بنمو هذه المصالح، وتتحول تدريجيا إلى ما يشبه التبني من قبل الحكومة التركية لفصيل "هيئة تحرير الشام" وحكومته المعلنة في إدلب، وإن كان في الأمر معاندة من مشروع فصائل "درع الفرات" التي يمكن القول أنها تجاوزت مرحلة التحالف المؤقت إلى التبعية الدائمة.