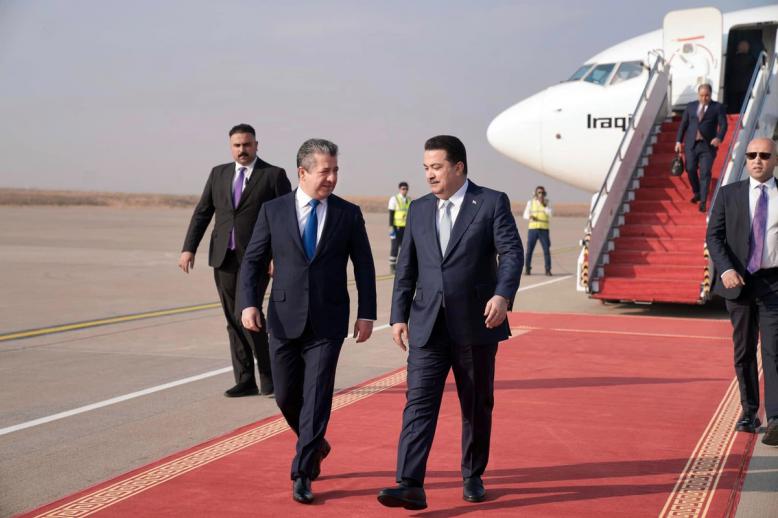الفقير المضحوك عليه المثقل بالديون، لا يُمنع من الكلام
تتوالى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المثيرة للقلق في الأردن وتضيق في نفس الوقت هوامش حرية التعبير في السنوات الأخيرة. ثم يقال ان هذه وصفة مثالية للاضطراب الاجتماعي، فتغض أجهزة الحكم النظر وتلتفت الى ما هو بعيد عن اهتمامات الناس.
اذا كانت أزمة الوباء الممتدة منذ سنة ونصف السنة نالت من الاقتصاد الهش القائم اساسا على المساعدات الخارجية والضرائب والرسوم ، فإن "قانون الدفاع" الذي تعمل بموجبه الحكومة حسب الدستور، كرّس ايضا انتهاك الحريات العامة المكفولة في الدستور.
الآلاف خسروا وظائفهم الى جانب عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أنهت اعمالها بسبب قرارات الحظر والاغلاق غير المفهومة احيانا وغير المبررة في احيان اخرى، فارتفعت البطالة بين الشباب الى أكثر من النصف وحوالي 25 بالمئة في مجمل سوق العمل.
تتآكل الدخول مع الارتفاعات المستمرة في الاسعار وتزايد ضغوط الضرائب والرسوم على المعيشة اليومية للأردنيين، وتتسع رقعة الفقر بشكل لافت حتى بات مئات الآلاف يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وكل هذه ارقام رسمية صادرة عن الحكومة.
أما الدين العام فقد قفز الى أكثر من مئة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بواقع حوالي 50 مليار دولار في نهاية سبتمبر. وهذا يعني بحسبة "شعبية" سريعة ان كل مواطن اردني مدين بنحو خمسة آلاف دولار، معظمها لمؤسسات وبنوك في الخارج.
عاملان اساسيان اخران يساهمان في تحول العلاقة بين الأردنيين والحكومة من حالة فقدان الثقة الى شعور عام أبعد واخطر، وهو أنها تحاول ان تضحك على الناس.
لا يصدق الأردنيون احاديث الحكومة عن مكافحة الفساد والمحسوبية وتوريث المناصب، وهم يعلمون ان قضايا الفساد الكبرى لا يقترب منها احد، ولو كثر الكلام عن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
كما الارتباك الحكومي ظهر واضحا في الروايات الرسمية وتعديلها وتفسيرها لأبرز حدثين شهدتهما المملكة وتداولهما الرأي العام بكثافة في الشهور الاخيرة، وهما الكشف عن عقارات للملك عبدالله الثاني في الخارج حسب "اوراق باندورا"، وقبلها أزمة الأمير حمزة.
وهكذا تركت الحكومة تساؤلات مهمة حول الحدثين بلا إجابة. وأفسحت مجالا اوسع للهمس والشكوك وكثرة التأويلات. ومعها يتولد الاستياء والاحساس المبرر بأن "ما خفي أعظم" وأكبر أحيانا من قدرة الحكومة نفسها على التصريح به.
هل تعاني الحكومة من قيود على حرية تعبيرها عن نفسها في حين تتكفل أجهزة الحكم الاخرى بتحديد ما يقال وما لا يقال؟ الواقع يقول: لا. لأن الحكومات تعرف حدودها جيدا قبل تشكيلها رغم انها صاحبة "الولاية العامة" على البلد، وهي بذلك ترضى ولا تشعر بـ"القمع"!
وسط هذا كله، اتخذت القيود المفروضة على حرية التعبير منحى تصاعديا، وبالأرقام ايضا. ففي 2020 زاد عدد قضايا الجرائم الالكترونية الى حوالي عشرة آلاف بارتفاع يناهز ألفي قضية عن العام الذي سبقه، بحسب تقرير صدر الاثنين عن مركز حماية وحرية الصحافيين في الاردن.
وذكّر المركز بالنصوص القانونية الفضفاضة التي تتيح ملاحقة الصحافيين والمدونين قضائيا، وأشار الى دراسة تفيد بأن ثلثي الأردنيين يخشون من المساءلة عن آرائهم السياسية في البلد الذي تسيّر أجهزته الأمنية "دوريات إلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي.
في نفس اليوم، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الى إلغاء العمل بقانون الدفاع الذي يتيح للحكومة استخدام صلاحيات استثنائية كما لو كانت في حالة حرب.
الحكومة بالفعل استخدمت هذه الصلاحيات في اكثر من مناسبة، ومنها إغلاق نقابة المعلمين وحظر الاحتجاجات اللاحقة لقرار الاغلاق ومنع تنظيم مظاهرات اخرى على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب.
ومنذ بدء تطبيق قانون الدفاع في مارس/اذار من العام الماضي، لم تتوقف الانتقادات الحقوقية لطريقة تعامل الحكومة مع قضايا الحريات العامة وخصوصا حرية التعبير التي تتعرض حاليا لمزيد من التضييق.
أجهزة الحكم تجاهلت هذا كله وحاولت إشغال الأردنيين بقضايا الاصلاح السياسي والاحزاب والانتخابات. وهي قضايا، وإن كانت مهمة للوهلة الأولى، الا انها لا تسمن من جوع ولا تغني عن حرية الكلام.
ألا تستطيع الحكومة استدعاء الطريقة الكلاسيكية في التعامل مع الغضب الشعبي، وإعطاء مساحة "تنفيسية" لحرية التعبير؟ على الاقل من أجل قياس اتجاهات الرأي العام او التنبؤ بما يمكن ان يحدث.
لكن الحكومة تنكر دائما انها تفرض القيود على الحريات العامة. وحيث الإنكار غير مفيد في حالة تشبه قول المتنبي "وليس يصح في الأفهام شيء، إذا احتاج النهار إلى دليل"، تحاول الحكومة عقد مقارنات مع أوضاع الدول الاخرى في الإقليم.
المقارنة لا تستقيم طبعا مع دول تشهد حروبا واضطرابات مثل سوريا والعراق ولبنان، ولا مع الدول الخليجية التي استطاعت اقتصاداتها الغنية مواكبة الأضرار الناجمة عن أزمة الوباء.
المقارنات مع دول المنطقة لم تعد تقنع أحدا. ولو كان الأمر هكذا، سيقارن الناس ايضا بين الأردن هذه الايام والدول التي مرّ عليها الربيع العربي قبل عشر سنوات وعانى أبناؤها قبل ذلك من تراجع الاقتصاد والفقر وقمع الحريات.
هذا كله يضع مواصفات المواطن الاردني ضمن سياق مؤسف: الساكت الفقير المضحوك عليه والمثقل بالديون.