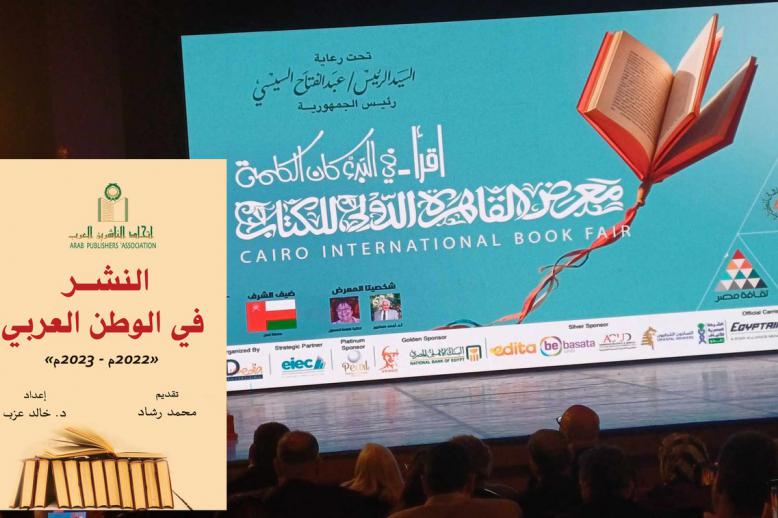زمن الكورونا.. والبحث عن الذات
في تقديري هذا الوباء هو أول جائحة تغطي وجه الكرة الأرضية؛ باردها وحرَّها، جبالها ووديانها، صحاريها وأنهارها دون أي تفرقة.
والحل.. في العزلة حتى يُحدِث الله أمرًا كان مفعولًا باكتشاف لقاح مضاد، أو علاج شافٍ.
والحماية.. بالرجوع إلى عطارة الأمس، و"تذكرة داود"، و"مجربات الدياربي الكبير"، وأي "وصفة بلدي" تُعطي بريق أمل في النجاة.
وبعد الإحساس بملل العزلة تغير مسار التفكير إلى إعادة اكتشاف الذات، والارتحال إلى عالمي الخاص داخل البيت.
وأحمد الله أنني منذ مطلع شبابي متعدد الاهتمامات الثقافية؛ عشقت التاريخ، واقتنيت أمهات كتبه، منذ شرخ شبابي تلميذًا بالمدارس ثم طالبًا في الجامعة، بدءًا من "سور الأزبكية" الذي كان عظيمًا متميزًا يشبه كورنيش نهر السين في باريس، وأسوار "هايد بارك" في لندن مساء كل سبت وطوال أيام الآحاد، إلى "الكتبخانة" القديمة بميدان "باب الخلق"، إلى كثير من مكتبات بيع الكتب، ومقار دور النشر بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كنت أستمتع بقراءة مجلدات التاريخ، والسير، وكتب الفكر السياسي، وتحليل ذوي الجباه العالية، تمامًا كما كانت تمتعني قراءة القصة والرواية والمسرحية وكتب النقد، ومشاهدة الفيلم السينمائي الراقي، وقد أتاحت لي الظروف أن أقترب من اثنين كان لهما فضل بناء ذائقتي الموسيقية؛ أبو زيد حسن، عازف البيانو، ملحن أهم أغنيتين كتبهما صلاح جاهين عن مأساة تلاميذ "مدرسة بحر البقر" الذين قضت عليهم قنابل الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، وكذلك عمال "مصنع أبو زعبل".
والثاني هو الموسيقار مدحت عاصم، الذي أفهمني الفرق على الطبيعة بين: الميلودي والهارموني، وبين: "التخت" و"الأوركسترا".
أضيف إلى ذلك كتابات بدر الدين أبو غازي في مجلة "الهلال" العريقة عن أعلام الفن التشكيلي المصري.
كانت سنوات الستينات من القرن العشرين فترة ثراء لحركة الفنون التشكيلية في قلب القاهرة، وكم تعرفت خلالها على أعمال فنانين عظام في: "قاعة الغرفة التجارية" بميدان "باب اللوق"، هذه القاعة التي لم يعد لها أثر الآن.
ابتعدنا مسافات كبيرة عن فهم معنى الجمال؛ في الأخلاق والمعاملات والحب والخير وعدم الأنانية. وكلها كانت معانيَ جميلة فيها الصدافة والبراءة والألفة والحياة المشتركة، لكنها ضاعت كلها في عالم "البراجماتية" الكريه
وكذلك المعارض التي كان يستضيفها "أتيلييه القاهرة"، و"قاعة الدبلوماسيين الأجانب" بالزمالك، قبل أن يستقر "متحف الفن الحديث" في مكانه الحالي في رحاب "دار الأوبرا" الجديدة.
في تلك الفترة، تعرفت على رمسيس يونان، وعبدالهادي الجزار، والأخوين سيف وأدهم وانلي، وصالح رضا، وعمر النجدي، وجمال السجيني، وحامد ندا، وجاذبية سري، وإنجي أفلاطون، ومحيي الدين حسين، ومنير كنعان، وأحمد فؤاد سليم، وغيرهم كثيرون.
كنا أغنياء مستمتعين بما نعيشه من ألق ثقافي وفني على خشبة: المسرح القومي، والحديث، والجيب، ومسارح التليفزيون أيضًا، وعلى شاشات دور السينما: "ديانا"، و"ريفولي"، و"مترو"، و"أديون"، و"كايرو"، و"ميامي"، وسينمات الإسكندرية: "مترو"، "أمير".
كما كنا نقتني أسطوانات الموسيقى العالمية من: سيمفونيات ورابسوديات وكونشيرتوهات قادمة من شركات أميركية شهيرة مثل "كولومبيا"، أو من الاتحاد السوفيتي أيضًا، وكانت تعرضها "مكتبة الشرق" بشارع طلعت حرب مع الكتب الروسية المترجمة إلى العربية سواء للأطفال أم للكبار.
وكانت الآليات تتطور أيضًا من الأسطوانة الـ 33 لغة إلى شريط التسجيل الممغنط الضخم، إلى شريط الكاسيت.
كنت أسافر مع هذه التجربة بمجرد أن أغلق باب حجرة المكتب عليَّ، وأجلس على مقعد متخرك فوق عجلات أربع، وأتجول بين أجزاء مكتبتي، لأتفرج على العناوين في مختلف الفنون والآداب، في التخصص وخارجه. نعم الفرجة، فبمجرد أن أفتح بابًا من أبواب المكتبة، وأتطلع إلى الكتب النائمة على الأرفف، وأقرأ العناوين، وأسرح بعض الوقت مع ما يضمه الكتاب، مسترشدًا بما تركته من تعليقات بالقلم الرصاص على هوامش الصفحات، أو على جذاذات صغيرة مستقرة بين الصفحات.
أتنقل من كتاب إلى آخر، ومن رف إلى رف، ومن باب إلى باب، حتى أنتبه إلى أن الضوء بدأ ينسحب، فأستعين بالكهرباء لأضيء المكان، وأستمر حتى أحس أن ضوء يوم جديد يتسلل من النافذة، مستحيًا ثم جريئًا، فأعود إلى المفتاح وأطفئ النور، وأنصرف إلى بعض شأني.
وقبل أن أعود إلى مكتبتي أو أبحث عن الأخبار في الراديو أو التليفزيون، لأتابع ما يجري في العالم، وفي بلادنا.
وأفكر فينتابني إحساس بأننا أصغر بكثير مما نتصور، ليس نحن، بل كبراء العالم الذين روَّجت آلاتهم الدعائية لنا أنهم صناع المعجزات!
لقد كشف "كورونا" أن الكبار ليسوا كبارًا أبدًا، بعد أن عرَّاهم أضأل كائن، وأعادهم إلى عصور الغالب لينجو من افتراسه!
تصوروا.. فرنسا تشتري 60 مليون كمامة من الصين، وبعد أن تدفع ثمنها مقدمًا، يلنف مندوب أميركي على الصفقة، ويشتري حمولة الطائرة وهي على المدرج تستعد للإقلاع إلى فرنسا بضعف ثمنها!
أليس هذا عصر الغاب!
وبمناسبة الغاب، أثرت فيّ كثيرًا لقطة لحيوان بري يشبه الغزال، وصل من مكان ما إلى أحد ميادين "روما"، وأخذ يمشي فيه وحيدًا بعد أن هُجرت المدن؛ السيارات، وضجيج البشر.
فهل أحس الحيوان بأن الهواء صار أنقى فجاء ليكتشف السبب؟
يُقال إن المصائب تُوحد البشر، فهل يتحد البشر بحق بعد انزياح هذه الجائحة؟ أم يعودوا، كما كانوا، وحوشًا تتصارع.. والبقاء للأقوى؟!
وهل تنتهي ألعاب السيطرة الرأسمالية بافتعال أزمات تهبط بأسهم البورصة إلى الحضيض، فتشتريها الذئاب لتعود فتبيعها بعد أن تعود وترتفع قيمتها وتجني الأموال الطائلة في حساباتها، ويكون الخراب دائمًا السذج ممن يجهلون قواعد اللعبة؟!
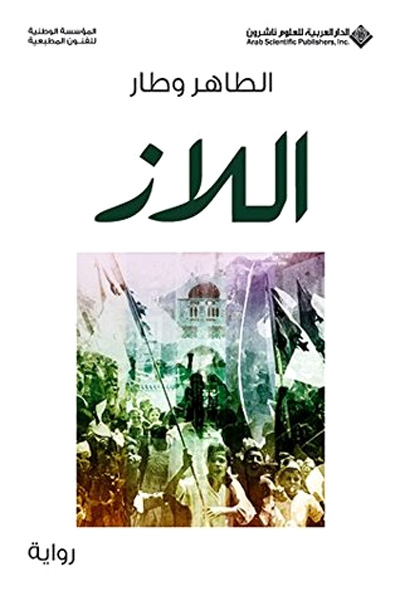
أما الإبداع الأدبي فما يزال تحت الاستنبات، فنحن لا نزال في قلب الأزمة، والتفكير المسيطر الآن هو كيف تتحقق النجاة.. أما الإبداع فمرجأ لإشعار آخر.
ودعونا نتذكر أن همنجواي كتب "وداعًا للسلاح" بعد الحرب العالمية الثانية، وأن تولستوي كتب "الحرب والسلام" بعد انتهاء عصر نابليون كله، وأن مارجريت ميتشل كتبت "ذهب مع الريح" عن الحرب الأهلية الأميركية في ثلاثينيات القرن العشرين.
وعندنا، لم يكتب نجيب محفوظ عن ثورة 1919 إلا في الخمسينيات من القرن الماضي، وإسماعيل فهد إسماعيل كتب سباعيته الروائية بعد استعادة الكويت من غزو صدام لها، والطاهر وطار كتب "اللاز" بعد سنوات من استقلال الجزائر.
وهكذا، فهناك أشياء كشفتها العزلة، لا الوباء، فقد ابتعدنا مسافات كبيرة عن فهم معنى الجمال؛ في الأخلاق والمعاملات والحب والخير وعدم الأنانية. وكلها كانت معانيَ جميلة فيها الصدافة والبراءة والألفة والحياة المشتركة، لكنها ضاعت كلها في عالم "البراجماتية" الكريه.
وحتى الحب كمعني نبيل وجميل صار مجرد شهوة، والزواج أضحى مزايدة.
فهل نحاول استعادة إنسانيتنا مرة أخرى؟
إذا كان لما نمر به من إيجابيات، فهو إدراكنا أننا فقدنا اتزاننا، ومن الضروري أن نستعيد التوازن، ونروض التوحش في داخلنا من أجل استعادة "الإنسان.. الإنسان".