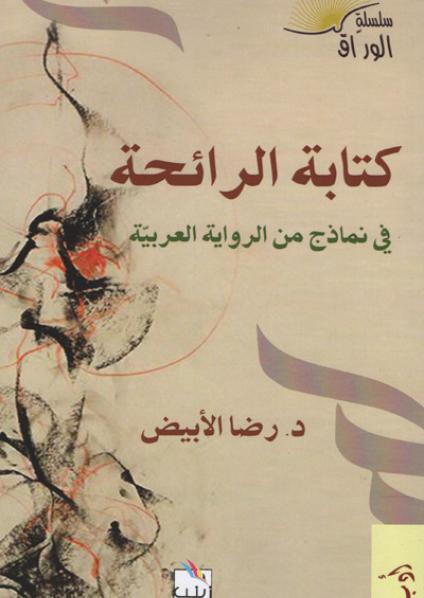تاريخ روائحنا وأدبنا الشميّ
كانت قراءته رواية "روائح المدينة" لحسين الواد مناسبة أولى لتفكيره في تناول موضوع الرائحة في الرواية، طرائق كتابتها وكيفيات تلقّيها من خلال بحثه المهم الذي أصدره قبل أيام عن دار زينب للنشر في تونس تحت هذا العنوان اللافت "كتابة الرائحة في نماذج من الرواية العربية".
وكانت مقالته التي عنوانها "المكان وكتابة الحواس في (جمان وعنبر)"، ومساهمته في ندوة القيروان بورقة عنوانها " لغة الروائح روائح اللغة في (روائح المدينة)"، وفي ندوة سوسة بورقة عنوانُها "تقريضُ العهر في (روائح المدينة)" من الأسباب التي عزّزت لديه قناعةً مفادها أنّ النقدَ العربيّ لم يكتبْ تاريخ الروائح، وأن النقد الروائيّ لم ينتبه إلى إنشائيتها. وبالتالي، فإنّ موضوعَ الروائح ما يزال، في تقديره، بِكْرًا في الدراسات العربيّة في الوقت الذي يهتمّ فيه نقادٌ غربيون بالشمّ في تاريخهم وثقافتهم، وفي نصوص أدبهم.
وفي الوقت الذي يحقق فيه التقدم العلميُّ تطوراتٍ هائلةً في مجال الروائح والعطور، من تجلياتها صناعة "الأنوف الإلكترونية" الذكيّة لاستشعار الروائحِ، والتعرّف عليها، ورسم خرائط شمّية بالاعتماد على الصور التي تظهرها الأشعّةُ المقطعية على الدماغ البشريّ، وعلى تطبيقاتٍ على الأجهزة والحواسيبِ، ورقمنة الروائح في الفضاء الافتراضي، إضافة إلى تطوير صناعة العطور والمواد العطريّة، وتنويع مصادرها، وتعزيز سلطتها وإغرائها في مجالات كثيرة مثل: الصناعة والموضة والعمارة والتعليم.
ويشير مؤلف الكتاب الدكتور رضا الأبيض إلى أنه في عصر التورّط الشمّي، عصر الاعتماد أكثر على حاسّة الشمّ في التواصل اليومي والتجارة والتعليم والزراعة والطب فضلًا عن المجال العسكري، وفي عصرِ تطوير التجارب والأدوات، وانتشار "الشمّ الافتراضيّ" لم يجد في المكتبة العربية ما يسدّ الحاجةَ، ويشبع الرغبة في معرفة دقائقَ هذه الحاسّة، ومعرفة تاريخِ روائحنا وأدبنا الشميِّ، شعرًا وسردًا، إلاّ قليلاً من المقالاتِ أو الفقرات، في هذا المؤلَّفِ أو ذاك، حول الزينة أو العطر، وحول تنافذ الحواسِ في نماذجَ من الشّعر العربيّ القديم والحديث، لا ترقى مجتمعة إلى الدلالة على أنّ هذه المسألة شغلت المفكرين، وأرّقت الباحثين ونقاد الأدبِ.
بيان مدى تمكّن الخطابِ الروائي من تجاوزِ فعل التأثيث الجزئيِّ بتفاصيلَ شميّة عابرة إلى إنشاء خطاب شمّي يقوم على الشمّ حافزًا والرائحة مطلبًا وذاكرة ورؤية
وعبر هذا الكتاب الشائق، يشير مؤلفه الدكتور رضا الأبيض إلى أن المكتبة العربية فقيرةٌ فعلاً، لا يُغني ما فيها هذا المبحثَ. ولذلك فهو مجالٌ لا يزال بكرًا؛ دراسة ونحت مصطلحات ومفاهيم. وهو ما شجع الدكتور رضا الأبيض، على المضيّ قدمًا في إنجاز هذا العمل الذي يعتبر مدخلًا يعبّر عن حيرة، ويخصّب مجال الاهتمام أكثر من كونه إجابات نهائية.
ويشير الأبيض إلى أن ندرةَ المراجعِ في المكتبة العربية في هذا الموضوع، بقدر ما مثَّلت عائقًا له، فقد كانت حافزًا مشجّعًا له على قراءة ما توفر له من دراسات باللغتين: الفرنسية والإنجليزية، وعلى الإفادة منها، سواء تلك التي اهتمت بتاريخِ الروائح أنثروبولوجيًّا، أو في علاقتها بمباحث الفلسفة وعلم النفس، أو تلك التي تدبّرت نماذجَ من الأدب تتقصّى حضور الرائحة وتبحث في رمزيتها.
ويذكرنا مؤلف هذا الكتاب بأن للإنسانِ خمسَ حواسٍ يحتاجها كلَّها، ويعتمد عليها في حياته، هي: البصرُ والسّمع والشمّ واللمس والتذوقُ، ثم يشير إلى أنّ مراتبَها في الفكر والثقافة اختلفت بسبب العاداتِ والعرف والقيم والتمثلات الاجتماعيّة؛ فقد حظي البصرُ بقيمة وعناية أكبرَ، رغم تأخّر اعتمادِ الإنسان عليه، مقارنة بالحواس الأخرى التي أثبتت الدراساتُ العلمية فعاليتها في مرحلة ما قبل الولادةِ عندما يبلغ الجنينُ عمر الشهرين. ولكن، رغم ما لقيه البصرُ من تبجيلٍ، فإنّ الحواسَ كلّها، ظلت خلال مرحلةٍ طويلة من التاريخ ثانوية، بَلْ مهمّشة ومحتقرةً في الثقافة الإنسانيةِ كلها مقارنة بالعقل والروح والنفس، باستثناء محاولاتٍ قليلةٍ لَمْ تتمكّنْ من أنْ تُحرّر الفكرَ من استبدادِ الرؤية الميتافيزيقة وفلسفات الوعيِ المتعالية إلاّ في العصرِ الحديثِ، رغم ما تثبته تجربة الحياة اليومية من تعويل على الحواسِ وعلى الشمّ، ورغم الإشاراتِ القديمة جدّا إلى قيمتها وخطورتها.
ويذكر الأبيض أن مُنَظِّر الحواسِ الأول، الفيلسوف اليونانيُّ ديموقريطوس، اِعتبرَ الرائحةَ وسيلةَ تواصلٍ، وأن الشمَّ مسؤولاً عن الرغباتِ والمشاعرِ والخيال. بينما اتجه مونتيني إلى الفلسفة ملتمسًا فضيلة لا ترتبط بالعقائدِ الدينية. فوجد في فلسفة أبيقور حجة للدفاعِ عن الحواسِ والمُتع السّلِيمَة ما دامت غيرَ شهوانية أو رخيصة.
والباب الأوّل من الكتاب هو بمثابة مدخل تأسيسي للمقاربة النقدية الإجرائيّة، إذ وفّرَّ للمؤلف معرفة بالسياقات التاريخية وبحركة الفكر الإنسانيّ وبعدد من المقاربات التي يمكن الإفادة منها في إضاءة جوانب من هذه الظاهرة المركّبة.
ويشير مؤلف هذا الكتاب إلى أن قضايا كتابة الرائحة، لم يخصَّها نقدُنا العربيُّ بدراساتٍ أكاديميةٍ واسعةٍ ورصينةٍ. لذلك اعتبر البحثَ في سؤالِ كتابة الرواية العربيّة الروائحَ مبحثًا جديدًا وغير مأنوسٍ.
وبسببِ هذه الجدّة وجد نفسه فيما يتعلّق باختيار المدونة، بين أمرين: إمّا أنْ يقتصر نظرُه على رواية واحدةٍ أو أنْ يوسّعَ دائرة الاختيار. فاختار توسيعَ المدونة رغبة في أنْ تكون العيّنة ممثّلةً، وعسى أن يفضيَ العملُ إلى نتائجَ مقبولةٍ.
ولمّا كانت المدونةُ الروائية العربية من الاتّساع ما يستحيل معه حصرٌ أو استيفاءٌ، فقد اختار المؤلف أنْ يكتفيَ بعدد من الرواياتِ تعلن عناوينُها، التي هي العتبة الأولى المنشئة للعقد القرائيّ، اشتغالَها على الشمّ فعلًا، والرائحة موضوعًا، باستثناء رواية واحدة توحي بذلك إيحاءً، هي "زرايب العبيد"، بناء على أنّ التلقيّ محكومٌ بخلفياتٍ ثقافية، وبناء على أنَّ هذا العنوانَ يوحي بحضور الرائحة وصْمَا اجتماعيًا وعرقيّا.
ولقد حرص الكاتب في اختيار المدونة على أنْ تكون موزّعة على مساحةٍ من الفضاء العربيِّ شاسعةٍ، تمتدّ، بالنظر إلى تواريخ طبعها، على فترة تسمح برصد التطوّر والتحولاتِ، فاحتوت عشر روايات مرتبة حسب تاريخ إصدار طبعاتها الأولى، وهي: "تلك الرائحة" لصنع الله إبراهيم (1965)، "رائحة الصابون" لإلياس خوري (1984)، "رائحة الأنثى" لأمين الزاوي (2000)، "فخاخ الرائحة" ليوسف المحيميد (2003)، "رائحة القرفة" لسمر يزبك (2008)، "روائح ماري كلير" للحبيب السالمي (2008)، "روائح المدينة" لحسين الواد (2010)، "رائحة الجنة" لشعيب حليفي (2012)، "زرايب العبيد" لنجوى بن شتوان (2016)، "رائحة الكافور" لميسلون فاخر (2018).

وعلى هذا النحو سعى المؤلف إلى أنْ تكون المدونة عيّنةً ممثلة زمنيّا وجغرافيا وجنسيّا، رغم قناعته أنّ جنسَ المؤلّف ليس محدِّدًا ذا قيمة كبرى في أدبيّة الأدبِ.
أمّا الامتدادُ الزمنيّ والتنوع الجغرافي فهما عنده من العواملِ الأكثر تأثيرًا في الاختيارات الأسلوبيّة والفنيّة، وفي الأبعادِ الدلالية. إذ أنّ الرواية "تمثّل نوعًا من الذاكرة الجمعيّة المميّزة لكلّ جغرافية بشريّة، إنها بمثابة خزانة الحكايات التي تحفظ المزايا الاجتماعية والأنثربولوجية لكلّ جغرافية بشريّة".
ولقد اختار أن يقسّم دراسته إلى ثلاثة أبواب كبرى: الباب الأول يضم مقاربات ومداخلَ متنوعة وزعها إلى فصلين. في الأوّلِ عرض مقارباتٍ عامّةً، وفي الثاني قدم مدخلين: المدخل السّيميولوجي، البارتيّ تحديدًا، والمعجميِّ الأدبيّ، انطلاقًا من كون الرائحة في المقاربة السيميولوجية علامة تواصلية حاملة لرسالة مثلما تقتضي تركيبًا تحتاج تفكيكًا، ولأنّ معجمَ اللغة يمثل، لا شكّ، الخزّانَ الذي يوفّر الكلماتِ الأولية التي يحتاجها الروائيّ وينشّطها في إنشاء خطاب الرائحة، رغم أنَّ إفادة الروائيّ ليست مباشرة من صُحِفِ المعاجمِ، بقدر ما يمثل المعجم خلفية وثقافةً تتبدّى موادُه فيما يقرأ من نصوصٍ سيكون لاختياراتها المعجمية ولصورها حضور على سبيل التناصّ اقتباسًا ومحاكاة ومعارضة.
لذلك جمع في هذا المدخلِ المعجمَ إلى الأدب، وعرض بعضَ النماذج الأدبية الشعرية العربية والرّوائيّة العالمية التي حظيت فيها الرائحة باهتمامٍ، على سبيل الإشارة إلى روافدَ العملِ الروائيِّ التي تظل في دائرة المُمْكِنِ، وليس بحثًا في وجوه التّناصِ الذي يمثل مظهرًا من مظاهر أدبيّة خطاب الرائحة.
وفي الباب الثاني اهتم بمعجم الشمّ والرائحة في خطاب العنوانِ، باعتباره مؤشّرًا تيميًّا وعتبة مُحفِّزة ومؤثرة في فعل التلقي والتأويلِ، ثم في متن الروايات، مقدمة لدراسة نشاط هذا المعجمِ دلاليًا. فوقف عند الطيب والنتن في وصف الأشياء والأجساد والأمكنة.
وفي الفصلِ الثاني الذي خصّصه لـ"الجملة الشمّية"، درس مكوّنات هذه الجملة ونظام توزع عناصر فعل الشمّ فيها، حضورًا وغيابًا.
وفي البابِ الثالث اهتم في الفصلِ الأوّل بالشمّ وبالرائحة فعلاً سرديًّا، وبمدى قدرة الرواياتِ المختارةِ على أن تحوّله إلى برنامجٍ سرديّ كلّيٍّ ينهض عليه بناءُ الرواية كلُّه.
وفي الفصْلِ الثاني من هذا البابِ درس الرائحةَ استعارةً ممتدّة في الروايةِ، لا تقوم على مجرّد استبدالِ كلمةٍ بأخرى، على نحو ما نجد من تعريفاتٍ الاستعارةِ في النظرية البلاغية التقليديّة، بقدر ما تدلّ على نظامٍ في التفكير، وفي تشكّل فعل الشمّ إبداعًا تتحوّل بمقتضاه الاستعارةُ إلى طريقة في الوجود وعلامةٍ ترمز إلى أسئلةٍ ومعبّرة عن هواجسَ وقضايَا مثل قضيّة الهوية والجنسِ والحبّ والذكريات والسياسة.
ويعترف المؤلف بأن كتابه لا يدّعي تحقيقَ مستحيلٍ، حسبه أنْ يؤكّد أهمّيةَ حاسة الشمّ والروائح في إدراكِ الذات والعالم، معاضَدةً لحواس أخرى أو بديلاً، وإنْ وقتيّا، عنها، وبيان مدى تمكّن الخطابِ الروائي من تجاوزِ فعل التأثيث الجزئيِّ بتفاصيلَ شميّة عابرة إلى إنشاء خطاب شمّي يقوم على الشمّ حافزًا والرائحة مطلبًا وذاكرة ورؤية، وهو ما تجلّى في تناولات إبداعيّة مثل رواية حسين الواد "روائح المدينة".