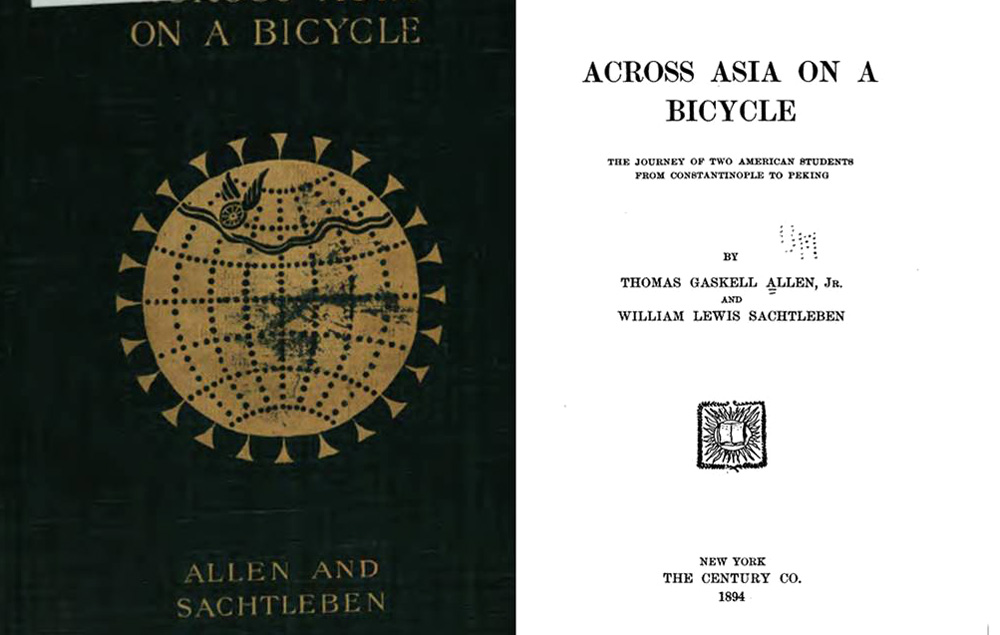
محمد عبدالغني يترجم رحلة طالبين أميركيين بالدراجات
تلقيت مكالمة من الكاتب والمترجم المصري الدكتور محمد عبدالغني، جراح العظام بمستشفى قنا العام في صعيد مصر، يبلغني فيها بأنه مترجم الكتاب الصادر في نيويورك عام 1894 وعنوانه "خيول الريح المدهشة.. رحلة طالبين أمريكيين بالدراجات من القسطنطينية إلى بكين"، الفائز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة في مجال الترجمة في دورتها الأخيرة، وليس محمد عبدالغني المغربي الجنسية، كما تم تداوله في البيان الإعلامي الصادر عن لجنة التحكيم وأمانة الجائزة، وأضاف بأن مؤلفي العمل الذي تقدم به لنيل الجائزة هما: "توماس غاسكل آلن الابن"، و "ووليم لويس ساكليبن"، وأنه قلق لأن أحدًا لم يبلغه بفوزه حتى الآن، كما أن أحدًا من أمانة الجائزة لم يرسل له ردًا على رسالته التي أرسلها على الإيميل ذاته الذي أرسل عمله من خلاله، فطمأنته وقلت له إنني سأتواصل مع الشاعر نوري الجراح، المشرف على أمور الجائزة، مستفسرًا عما حدث.
إلا أن الدكتور محمد عبدالغني عاد واتصل بي اليوم ليعلمني بأن رسالة وصلته من نوري الجراح هذا نصها "تحية طيبة وبعد، هنا تنويه يصحح خطأ متداولاً ورد في بيان جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة دورة 2020-2021 المتداول في الإعلام أن جنسية الفائز الأستاذ محمد عبدالغني هي مغربية، والصحيح أن الفائز يحمل الجنسية المصرية، فاقتضى التنويه."
وهكذا تم احتواء هذا الخطأ، واطمأن الرجل، ليبدأ حديثنا عن هذا الطبيب المولع بالترجمة، وكتابة القصة الذي نشر حتى الآن عدة ترجمات من الإنجليزية إلى العربية بلغة تنم عن دراية بجماليات العربية ووعي بأصول صنعة الترجمة.
ومن هذه الأعمال التي ترجمها: مسرحية "سالومي" لأوسكار وايلد، وقد نُشرت بجريدة "مسرحنا" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر، العدد 210، الإثنين 25/7/2011. وقصة "فاهافالو" لجان-لوك راهاريمانانا، ونُشرت بمجلة "الدوحة"، عدد سبتمبر/أيلول 2016.
رابط:
و"من السلوم إلى كيب تاون" تاتامخولو أفريكا.. بذرة مصرية وثمار جنوب إفريقية (تعريف بالشاعر مع ترجمة شعرية). نشرت بجريدة "أخبار الأدب" العدد 1409، الأحد 26 يوليو/تموز 2020، ص 16، 17.
كما أن له كتابات باللغة العربية مثل: "الدَّنَس" (قصة قصيرة) نُشرت في العدد 219 من جريدة "منبر التحرير" المصرية في 1 مارس/آذار 2016.
اختيرت قصته "سيجة" ضمن أفضل خمس قصص بمنطقة جنوب الصعيد، وشارك في الأمسية الثقافية التي أقامتها مؤسسة روبرت بوش الألمانية في مدينة قنا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وفي تقديمه للكتاب الفائز، يذكر مترجمه الدكتور محمد عبدالغني أن الحكاية بدأت باختراع جديد يُدعى "الڤيلوسيپيد" الذي تدحرج من فرنسا إلى أقطار العالم الغربي في سبعينيات القرن التاسع عشر. مركبة خفيفة تسعى على عجلة أمامية بالغة الارتفاع وعجلة خلفية لا تكاد تُرى، ولا يجرؤ على ركوبها إلا لاعبو الأكروبات والمغامرون.
كان زمن الصراعات والاكتشافات والشغف بكل جديد، ولكل جديد عشاقه. وسرعان ما شهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر ما عُرف في الولايات المتحدة بهوس الدراجات، ولا سيما بعد أن أُدخلت التعديلات على تصميمها لتصير أكثر شبهًا بالدراجة الهوائية التي نعرفها اليوم، وأكثر أمانًا للراكبين وللمشاة أيضًا.
في تلك الحقبة أُنشئت نوادي الدراجات وأقيمت سباقاتها، ونشر كثير من الدراجين كتبًا ومقالات عن رحلات ـ طالت أو قصُرت ـ حملتهم فيها الدراجات داخل بلادهم أو خارجها، فأثاروا شغف المزيد من الرحالة والمغامرين.
ولا يبدو أن مبتكر الدراجة الأول كان ينوي أن تكون إلا مركبة للنزهة في الحدائق، ولا يبدو أن خياله قد جنح فصور له أن هذه المركبة الهزيلة ستصير ـ بعد أعوام قليلة ـ أداة للسفر الطويل وعبور الحدود. لكنه حماس الشباب واندفاع المغامرين، الذي يفتح الآفاق، ويأتي بما قد لا يُتصوَّر.
اندفعت الدراجة من ساحات الاستعراض إلى الشوارع العمومية، وسرعان ما وجدت طريقها إلى الطرق المفتوحة، ثم عبرت الحدود. ولم تلبث الدراجة ـ بشكلها القديم ـ أن طافت العالم للمرة الأولى في التاريخ وعلى متنها مغامر إنجليزي يدعى توماس ستيڤنس (1854 ـ 1935) قضى في طوافه قرابة ثلاث سنوات (أبريل/نيسان 1884 ـ ديسمبر/كانون الأول 1886)، مستخدمًا دراجة من الطراز القديم المسمى "پيني فارذنغ" ذي العجلة الأمامية المرتفعة للغاية، فصار بعدها ملهمًا لمن جاء بعده من رحالة الدراجات الأول، ومنهم مؤلفانا: ساكليبن، وآلن.
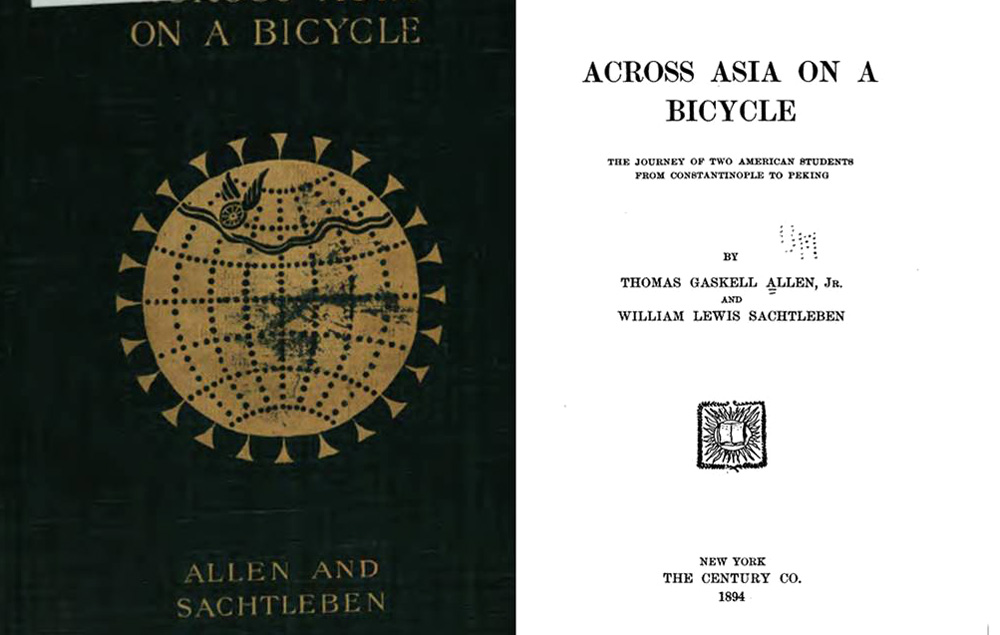
وعن رحلتهما يقول عبدالغني: في زمن كان فيه المرفهون من السائحين يسافرون في سفن بخارية أو قطارات فاخرة، أو عربات فارهة تجرها الخيل، مصحوبين بخدمهم وصناديق أمتعتهم، سافر مؤلفانا الشابان بدراجتين لا محرك لهما إلا أقدامهما. لا صناديق ولا حقائب. كان متاعهما القليل ووثائقهما القيمة محشوّة في هياكل دراجتيهما، أو مطوية حولها. تسلحا بمسدسين للدفاع عن النفس، إذا لزم الأمر، وبخطابات توصية ووثائق سفر شرعا في جمعها وهما في لندن لتكفل لهما، في محطات سفرهما ودروبه، حماية ودعمًا رسميين. ورغم ما ذكرا في كتابهما، وفي اللقاءات الصحفية التي أجريت معهما بعد وصولهما إلى الولايات المتحدة، من مضايقات تعرضا لها (ومن شكوك في كونهما جاسوسين)، لكن خطابات التوصية الرسمية أثبتت جدواها غير مرة، بل أن العثمانيين في الأناضول خصصوا لهما "جندي ضبطية" أو أكثر، حرصًا على سلامتهما إلى أن بلغا بلاد فارس.
ويبدو أن هذه المحاباة لم تُصب مواطنهما فرانك لينز، الذي حاول أن يكرر في عام 1894 تجربتهما في الطواف حول العالم بالدراجة، ولكن من الشرق إلى الغرب، غير أن حظه العاثر قاد خطواته إلى مدينة "أرض روم" في خضم اضطرابات عرقية محتدمة بين الأكراد والأرمن، وهناك انقطع أثره تمامًا، فعاد ساكليبن في العام التالي ـ وحده في هذه المرة ـ إلى الأناضول بحثًا عنه، وسط اهتمام مكثف من الصحافة والرأي العام الأميركيين، ولكن بعد بحث مُضنٍ عاد خاوي الوفاض، موقنًا أن لينز قد قُتل.
بدأ الشابان رحلتهما من ليڤرپول في يونيو/حزيران 1890، ومنها إلى نورماندي وغرب فرنسا وبوردو، ومارسيليا، والريڤييرا الفرنسية، فإيطاليا، ثم كورفو وپاتراس في اليونان، ثم عبرا خليج كورينثي إلى أثينا، حيث قضيا شتاء سنة 1891، وفي أبريل بلغا إسطنبول في باخرة، وهي البداية الحقيقية للرحلة وللكتاب، الذي يصف اجتياز الشابين لتركيا العثمانية ثم إيران فتركستان الروسية فالصين، التي دخلاها مرورًا بصحراء غوبي، على خطى ماركو پولو إلى أن بلغا بكين.
وبعد ثلاثة أعوام إلا ثلاثة أسابيع، بلغ الشابان نيويورك على دراجتيهما، بعد أن أكملا جولة حول العالم، وبلغ ما قطعاه منها بالدراجات أكثر من خمسة عشر ألف ميل.
لا يتحدث المؤلفان عن رحلتهما الأوروبية التي سبقت وصولهما إلى إسطنبول إلا في سطور موجزة في المقدمة، فلم تكن تلك الرحلة إلا وسيلة إلى غاية. والواقع أن الشابين لم يخرجا من بلادهما وفي ذهنيهما نية الطواف حول العالم، بل كانا ينويان قضاء الصيف متجولَين في الجزر البريطانية بالدراجات ـ التي تعلما قيادتها في الجامعة قبل عدة أشهر ـ انطلاقًا من محطة وصولهما ليڤرپول، حيث ابتاعا دراجتين مصمتتي العجلات من طراز سينجر، غير أن استمتاعهما بهذه الرحلة جعلهما يتخذان هنالك قرارًا بالمضي شرقًا على دراجتيهما حتى يستكملا الطواف حول العالم على خطى توماس ستيڤنس.
وفي لندن أعلنا للصحافة البريطانية عن نيتهما، وابتاعا دراجتين جديدتين وزنهما أخف، وعجلاتها أكثر مرونة، كما اشتريا آلتي تصوير من نوع "كوداك" ليسجلا مغامرتهما.

التقط الشابان أكثر من 2500 صورة نشرا مختارات منها في الكتاب. وقد اكتُشف كثير من أوراق المؤلفين و"نيجاتيف" صورهما الخاصة بهذه الرحلة مصادفة في سنة 1984، فحُفظت في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس تحت عنوان "مجموعة ساكليبن"، وعُرضت في معرض خاص في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
استبدل الشابان دراجتيهما أكثر من مرة كما أسلفنا، ولما بلغا ساحل بلادهما الغربي في رحلة العودة أهداهما وكيل إحدى شركات الدراجات دراجتين هوائيتين جديدتين ليستكملا مرحلتهما الأخيرة في أميركا الشمالية صوب نيويورك. ولم يكن ذلك إلا استغلالًا لشهرة "الشابين المقدامَين" التي سبقتهما إلى بلادهما عبر أوراق الصحف؛ فقد اهتمت الصحافة الأميركية برحلة الشابين وأخذت تنشر ما يصلها من أخبارهما أولًا بأول، فلما عادا إلى بلادهما عن طريق كاليفورنيا في يناير/كانون الثاني 1893، التقاهما مراسل صحيفة "الهيرالد" في أحد الفنادق، ونشر تفاصيل لقائه معهما، ممتدحًا "تواضعهما الجمّ" في الحديث عن إنجازهما، ومضيفًا أنه "يحق لهما الفخر بلا جدال، لكن من يلاحظ سلوكهما قد يحسبهما درّاجين في نزهة قصيرة، لا شابين مقدامين وضعا روحيهما على أكفهما عدة مرات في العام المنقضي".
يقص الشابان على المراسل كيف ناما "في الخيام مع القبائل الرحالة"، وكيف باتا "في مخازن الغلال، وفي العراء، ومع الكهنة الرحّل"، لكنهما لا يشيران إلى أنهما أيضًا قضيا بعض الليالي في دور الإرساليات وفي قصور بعض الكبراء. ولا ينسى الشابان بالطبع أن يأتيا على ذكر "الحريم"، تلك الكلمة الغامضة التي فتنت ألباب الغربيين آنذاك وارتبطت عندهم بسحر الشرق الغامض، فأشارا إلى أن "الحريم" في الشرق ليس كمثل ذلك الحريم الذي بالغ الغربيون في وصفه مبالغة عظيمة، بل لا يشبهه أدنى شبه.
تعمد الكاتبان ألا يستعينا في جُلّ رحلتهما بأدلّاء أو مترجمين، وكان غرضهما من ذلك ـ حسب قولهما ـ أن يعرفا الشعوب الأجنبية عن قرب، فألزمهما ذلك بتعلم شيء من لغات البلاد التي يمرون بها. والظاهر أن اللغات الأوروبية لم تشكل عائقًا كبيرًا أمامهما، إذ يبدو أنهما تعلما شيئًا منها في دراستهما الجامعية.
أما التركية فقد لاحظا أن معرفتهما بها ظلت نافعة من القسطنطينية إلى تركستان الصينية، كما استخدماها أحيانًا في إيران، واستخدما الروسية بالطبع في تركستان الروسية. وأما الصينية، وهي اللغة المعروفة بصعوبة نبراتها وتبدل المعنى وفق تنغيم الكلمة فقد أقرّا بصعوبتها، وبأنها "أصعب اللغات تعلُّمًا".







